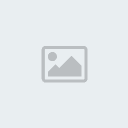﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾
قال الله تبارك وتعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾(الفرقان: 45- 46) .
أولاً- هذه الآية الكريمة بيان لبعض دلائل قدرة الله عز وجل وتوحيده . والخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمراد به العموم ؛ لأن المقصود من الآية الكريمة بيان نعم الله تعالى بالظل ، وجميع المكلفين مشتركون في أنه يجب تنبُّههم لهذه النعمة ، وتمكُّنهم من الاستدلال بها على وجود الصانع . ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما بيِّن جهل المعترضين على دلائل الصانع وفساد طريقتهم ، ذكر أنواعًا من الدلائل الواضحة التي تدل على قدرته التامة ؛ لعلهم يتدبرونها ويؤمنون بمن هذه قدرته وتصرفه في عالمه ، فبدأ تعالى بحال الظل في زيادته ونقصانه ، وتغيره من حال إلى حال ، وأن ذلك جار على مشيئته سبحانه .
وتركيب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ﴾ يفيد معنيين : أحدهما التنبيه والتذكير . والثاني : التعجيب من الأمر العظيم ؛ كقولك : ألم تر إلى فلان يقول كذا ، ويعمل كذا ، على طريق التعجيب منه . والتعجيب يقوم على أحد أمرين : إما على الإنكار والاستهجان والاستغراب . وإما على الاستحسان والاستعظام والإجلال . والحال في كلا الأمرين ببعث على التنبيه ، بمعنى : التأمل والتبصر والاعتبار ، وهو ما دعا إليه القران الكريم في كثير من آياته .
ومن الأول قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾(إبراهيم: 28) ، ومن الثاني قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ . فهذا استفهام الغرض منه التذكير والتنبيه ، وإثارة تعجيب المخاطب من هذا الظل الدال على عظمة الله جلت قدرته ، وبديع صنعه ، وبالغ حكمته ، ويدعو المتأمل المتبصر إلى التفكير فيه : كيف يمده الله ويبسطه ، فينتفع به الناس انتفاعًا لا يبلغه إحصاء ولا وصف . ولو شاء ، لجعله ساكنًا لا يتحرك . ثم كيف جعل الشمس دليلاً عليه ، يستدل الناس بها على أحوال الظل : أين يمتد وينبسط ، ومتى يكون ذلك ؟ وأين يتقلص ويتلاشى ، ومتى يكون ذلك ؟ ثم كيف جعل الشمس بمشيئته تعالى تنسخ شيئًا فشيئًا هذا الظل الممتد المبسوط ؟
والرؤية في قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ ، وقوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ﴾ ، ونحوهما ، رؤية بصرية ؛ لأنها هي التي تتعدى بـ( إلى ) . ونظيرهما قوله تعالى :﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (الغاشية:17) . وعليه يكون المعنى في الآية التي نحن بصددها : ألم تنظر إلى بديع صنع ربك نظر تأمل وتبصر واعتبار كيف مد الظل .. وكون الرؤية هنا بصرية أولى من كونها علمية للعلة التي ذكرناها .
وإنما قال تعالى هنا :﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، ولم يقل :﴿ أَلَمْ تَنْظُر ﴾ ؛ لأن حقيقة النظر هي تقليب البصر حيال مكان المرئي طلبًا لرؤيته ، ولا يكون ذلك إلا مع فقد العلم . والشاهد قولهم : نظر ، فلم يَرَ شيئًا . ويقال : نظر إلى كذا ، إذا مدَّ طرفه إليه ، رآه أو لم يرَه . أما الرؤية فهي إدراك الشيء من الجهة المقابلة ، ولا يكون إلا مع وجود العلم .
بقي أن تعلم أن الفرق بين الرؤية والعلم : أن الرؤية لا تكون إلا لموجود ، والعلم يتناول الموجود والمعدوم . وكل رؤية لم يعرض معها آفة فالمرئي بها معلوم ضرورة . وكل رؤية فهي لمحدود ، أو قائم في محدود ؛ كما أن كل إحساس من طريق اللمس ، فإنه يقتضي أن يكون لمحدود ، أو قائم في محدود . فإذا علمت ذلك ، تبين لك سِرَّ التعبير بفعل الرؤية هنا ، دون التعبير بفعل النظر ؛ كأن يقال :﴿ أَلَمْ تنْظُر ﴾ ؟ أو التعبير بفعل العلم ؛ كأن يقال :﴿ أَلَمْ تَعْلَم ﴾ ؟
وكان حق التعبير أن يقال :( ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ) ؛ لأن الظل المقيَّد بالحال - وهو كيفية مده- هو المقصود بتوجيه الرؤية إليه . ولكن عُدِل عنه إلى قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ ؛ لأن المقام- هنا- مقام إثبات الوحدانية والإلهية لله تبارك وتعالى ؛ ولهذا أوثر تعلق فعل الرؤية باسم الذات المفصح عن الربوبية ابتداء ، ثم جيء بالحال بعد ذلك ، وهو كيفية مد الظل .
وقال الفاضل الطيبي :« لو قيل : ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ، كان الانتقال من الأثر إلى المؤثر . والذي عليه التلاوة كان عكسه ، والمقام يقتضيه ؛ لأن الكلام في تقريع القوم وتجهيلهم في اتخاذهم الهوى إلهًا ، مع وضوح هذه الدلائل ؛ ولذلك جعل ما يدل على ذاته تعالى مقدمًا على أفعاله في سائر آياته ؛ كقوله تعالى :﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾(الفرقان: 47- 48) .
وفي التعرض لعنوان الربوبية في قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإيذان بأن ما يعقبه هو من آثار ربوبيته ورحمته سبحانه تعالى . أما ﴿ كَيْفَ ﴾ فهي مجردة عن معنى الاستفهام ، ومُخلَصة للدلالة على الحال ، أو الهيئة التي صار إليها الظل بعد مدِّه . و﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ : بسطه بعد أن كان منقبضًا ؛ ومنه قولهم : مدَّ الحبل ، ومدَّ يده . ويطلق المدُّ ويراد به الزيادة في الشيء ، وهو استعارة شائعة ، وهو هنا الزيادة في مقدار الظل .
وقيل : المراد بـ﴿ الظِّلِّ ﴾ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما . وقيل : هو من غياب الشمس إلى طلوعها . وذهب كثير من المفسرين إلى أن القول الأول هو الأصح .. وأصحُّ منهما قول من قال : المراد به ما يكون من مقابلة جسم كثيف للشمس عند ابتداء طلوعها ؛ كجبل ، أو بناء ، أو شجر ، أو نحو ذلك .
وإنما قلنا هذا أصح الأقوال ؛ لأن المراد من الآية الكريمة تنبيه الناس على عظيم قدرة الله عز وجل ، وبالغ حكمته سبحانه ، فيما يشاهدونه ؛ فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه ، وبين الشمس جسم مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضَحِّ الشمس .
قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن :« الظلُّ ضدُّ الضَّحِّ ، وهو أعم من الفيء ؛ فانه يقال : ظِلُّ الليل ، وظِلُّ الجنة . ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس : ظِلٌّ ، ولا يقال : الفَيْءُ إلا لما زال عنه الشمس » . والضَّحُّ من الضحى ، وهو انبساط الشمس ، وامتداد النهار . وقيل : الظل ما نسخته الشمس ، والفيء ما نسخ الشمس .. وقيل : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل , وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل .
وقوله تعالى :﴿ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ جملة شرطية معترضة بين المعطوف ، والمعطوف عليه ، للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل للأسباب العادية من قرب الشمس إلى الأفق الشرقي على الأول ، أو قيام الشاخص الكثيف على الثاني ؛ وإنما المؤثر فيه حقيقة المشيئة والقدرة . والمعنى : ولو شاء الله تعالى ، لجعل الظل ثابتًا على حاله ظلاًّ أبدًا ؛ كما فعل عز وجل في ظل الجنة . أو لجعله ثابتًا على حاله من الطول والامتداد .. وفي ذلك أيضًا تذكير للعباد بأن في جعل الظل ممدودًا . أي : متحركًا منَّة من الله تعالى عليهم ، تستوجب الحمد والشكر .
وقابل تعالى قوله :﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ بقوله :﴿ سَاكِنًا ﴾ . والسكون إنما يقابل الحركة ؛ فدل ذلك على أنه قد أطلق مد الظل على الحركة مجازًا ؛ وذلك من باب تسمية الشيء باسم ملابسه ، أو سببه . كما دلت هذه المقابلة على حالة مطوية من الكلام ؛ وهي حالة عموم الظل جميع وجه الأرض . أي : حالة الظلمة التي سبقت اتجاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض ؛ كما أشار إلى ذلك قول التوراة في الإصحاح واحد من سفر الخروج :« وكانت الأرض خالية ، وعلى وجه القمر ظلمة . وقال الله : ليكن نور ، فكان نور .. » . وواضح أن استدلال القرآن بالظل أجدى من استدلال التوراة بالظلمة ؛ لأن الظلمة عدم ، لا يكاد يحصل الشعور بجمالها ، بخلاف الظل الذي يجمع بين النور والظلمة ، فكلا دلالتيه واضحة .
ثانيًا- وقوله تعالى :﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ عطف على قوله تعالى :﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ ، داخل في حكمه . أي : جعلنا الشمس دليلاً على ظهوره للحس ؛ فإن الناظر إلى الجسم الملون حال قيام الظل عليه ، لا يظهر له شيء سوى الجسم ولونه ، ثم إذا طلعت الشمس ، ووقع ضوؤها على الجسم ، ظهر له أن الظل كيفية زائدة على الجسم ولونه . والضد يظهر حالة الضد . هذا قول الرازي والطبري وغيرهما .. أو : جعلنا الشمس علامة يُسْتدَلُّ بأحوالها المتغيرة على مقادير امتداد الظل ، من غير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعًا ، حسبما نطقت به الجملة الشرطية المعترضة بينهما ؛ وهي :﴿ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ .
وقال تعالى :﴿ دَلِيلاً ﴾ بالتذكير ، وهو صفة الشمس ، ولم يقل :﴿ دَلِيلةً ﴾ ، فيؤنِّثه ؛ لأن الدليل في معنى الاسم ، فكما يقال : الشمس برهان ، والشمس حق ؛ كذلك يقال : الشمس دليل .. والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى :﴿ جَعَلْنَا ﴾ ، يؤذن بعظَم قدْر هذا الجعل ؛ لما يستتبعه من المصالح التي لا تحصى . ثم هو أدخل في الامتنان من ضمير الغائب ؛ فهو مشعر بأن هذا الجعل نعمة عظيمة ، وهي نعمة النور التي بها تتميَّز أحوال المرئيات . وعلى هذا يكون قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ ارتقاء بالمنَّة بعد قوله تعالى :﴿ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ . أما ﴿ ثُمَّ ﴾ فهي للتراخي الزماني ؛ كما هو حقيقة معناها . أو للتراخي الرتبي . أي : أزلنا الظل بعدما أنشأناه ممتدًّا ، ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه من غير أن يكون له تأثير في ذلك أصلاً .. وتعدية ﴿ دَلِيلاً ﴾ بـ( على ) تفيد أن دلالة الشمس على الظل- هنا- دلالة تنبيه على شيء قد يخفى ؛ كقول الشاعر :
إلى الله أشكو أنني لست ماشيًا ** ولا جائيًا إلا عليَّ دليل
أي : رقيب يدل عليَّ . والدليل هو المرشد إلى الطريق والهادي إليه ؛ فجعل امتداد الظل لاختلاف مقاديره كامتداد الطريق ، وعلامات مقادير ؛ مثل صُوَى الطريق ، وجعلت الشمس من حيث كانت سببًا في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مراحل ، بطريقة التشبيه البليغ . فكما أن الهادي يخبر السائر في الطريق أين ينزل ؛ كذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعرِّف المستدل بالظل بأوقات أعماله ؛ ليشرع فيها .
ثالثًًا- قوله تعالى :﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ يعني : ثم قبضنا هذا الظل الممدود إلينا قبضًا هيِّنًا خفيًّا ، شيئًا فشيئًا. أي : بالتدرج والمهل ، حسب ارتفاع دليله على وتيرة معينة مطردة ، لمعرفة الساعات والأوقات التي تتوقف عليها مصالح العباد . وفيه لمحة من معنى قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾(البقرة: 18) .
وقيل : إن الله تعالى حين بنى السماء كالقبَّة المضروبة ، ودحا الأرض تحتها ، ألقت القبَّة ظلَّها على الأرض ، لعدم وجود الشمس ؛ وذلك مدُّه تعالى الظل . ولو شاء لجعله ساكنًا مستقرًا على تلك الحالة إلى يوم القيامة . ثم خلق الشمس ، وجعلها على ذلك الظل دليلاً . أي : سلَّطها عليه ، ونصبها دليلاً متبوعًا له ؛ كما يتبَع الدليل في الطريق ؛ فهو يزيد بها وينقص ، ويمتد ويقلص ، ثم نسخه بها ، فقبضه قبضًا سهلاً يسيرًا .
و﴿ ثُمَّ ﴾ يحتمل أن تكون للتراخي الزماني ، وأن تكون للتراخي الرتبي على نحو ما مر . وجيء بصيغة ﴿ قَبَضْنَاهُ ﴾ ماضية للدلالة على تحقق الوقوع ، ولمناسبة ما ذكر معه . وإنما عبَّر عنه بالقبض المنبىءِ عن جمع المنبسط وطيِّه ، لما أنه قد عبَّر عن إحداثه بالمدِّ الذي هو البسط طولاً . شبَّه الظل بحبل ، أو ثوب طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة الاستعارة المكنية . وكذلك عبَّر عن نقص الظل بالقبض الذي هو ضد المد على طريقة الاستعارة .
وقوله تعالى:﴿ إِلَيْنَا ﴾ للتنصيص على كون مرجع الظل إليه عز وجل ، لا يشاركه- حقيقة- أحد في قبضه ؛ كما أن حدوثه منه سبحانه ، لا يشاركه- حقيقة- أحد في إيجاده ومده . وقوله تعالى :﴿ قَبْضًا ﴾ مصدر مؤكد لفعله ، و﴿ يَسِيرًا ﴾ صفته . أي : قبضًا غير عسير .
وفي وجود الظل بأحواله المتغيرة التي أفادها الفعل ﴿ مَدَّ ﴾ دقائق من أحوال النظام الشمسي ، تشير إلى دقة التكوين الإلهي ، وتدل على القدرة العظيمة . وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات ، وأعمال الناس ، ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس ، وفوائد الفيء ، بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرَّد بحلول الظل ، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه .
هذا هو محل العبرة والمنة اللتين تتناولهما عقول الناس على اختلاف مداركهم ، ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي ، وحركة الأرض حول الشمس ، وظهور الظلمة والضياء . فليس الظل إلا أثر الظلمة ؛ فإن الظلمة هي أصل كيفيَّات الأكوان ، ثم انبثق النور بالشمس ، ونشأ عن تداول الظلمة والنور نظام الليل والنهار ، وعن ذلك نظام الفصول ، وخطوط العرض والطول للكرة الأرضية ، وبها عرفت مناطق الحرارة والبرودة .
ومن وراء ذلك كله إشارة إلى أصل المخلوقات ، كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدمًا ، وكيف يمتد وجودها في طور نمائها ، ثم كيف تعود إلى العدم تدريجًا في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم المحض ؛ وذلك مما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ ، فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية الكريمة مع المنة ، والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس ، وأحوال الشباب ، وتقدم السن ، وأنهم صائرون عقب ذلك إلى ربهم يوم يبعثون مصيرًا لا إحالة فيه ولا بعد ؛ كما يزعم الكافرون والملحدون .
ولما صار قبض الظل مَثلاً لمصير الناس إلى ربهم بالبعث ، وصف سبحانه وتعالى قبض الظل باليسير ، تلميحًا إلى قوله جل وعلا :﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾( ق : 44) . وفي ذلك كله إشارة إلى أن الحياة في هذه الدنيا كظل يمتد ، ثم ينقبض شيئًا فشيئًا ؛ ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم :« ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ، ثم تركها ».
وقال الألوسي في كتابه ( ما دل عليه القرآن مما يعضِّد الهيئة الجديدة القويمة البرهان ) ، تعقيبًا على قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ ، قال :« دلت هذه الآية على أن الشمس متحركة ؛ لأن الظل تابع لها ؛ لأنه يكون من مقابلة كثيف- كجبل أو ماء أو شجر- للشمس عند ابتداء طلوعها . ولو شاء ، لجعله ساكنًا ؛ وذلك بأن لا يجعل سبحانه للشمس عليه . أي : على نسخه سبيلاً بأن يطلعها ، ولا يدعها تنسخه . أو بأن لا يدعها تغيِّره باختلاف أوضاعها بعد طلوعها ».
وأضاف قائلاً :« وقوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ معناه : جعلنا طلوع الشمس دليلاً على ظهوره للحس . وقوله :﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ . أي : ثم أزلناه ، بعد ما أنشأناه ممتدًّا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه . أو بإيقاعه كذلك ، ومحوناه على مهل قَليلاً قليلاً بحسب مسير الشمس » .
وانتهى من ذلك إلى القول :« وفيه دليل على كروية الأرض ؛ لأنها لو لم تكن كروية ، لتساوت الأقطار في الأفياء والظلال ، مع أن كثيرًا من الأقطار يكون فيه ليل ، وفي أقطار أخرى نهار .. ولأرباب الهيئة الجديدة أن يقولوا : إن الظلال تابع لحركة الشمس على حسب ما يراه الرائي ؛ وإلا ففي الحقيقة أن الأرض هي المتحركة على مركزها ، وهي الشمس . ولا بدع أن تكون الشمس دليلاً على الظل ، وإن كانت الحركة للأرض » .
وقال صاحب كتاب ( القرآن وإعجازه العلمي ) :« في هذه الآية دليل قوي على دوران الأرض حول نفسها ، وأن هذا الدوران ضروري للكائنات الحية فوق الأرض ؛ لأنها لو كانت غير متحركة ، لسكن الظل ولم يتغير طولاً أو قصرًا ، ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الكرة الأرضية باستمرار ، بينما يظل النصف الآخر ليلاً دائمًا ، وهذا ما يسبب اختلافًا كبيرًا في التوازن الحراري على الأرض ، ويؤدى ذلك إلى هلاك البشر من شدة الحرارة ، أو من شدة البرودة ، والله سبحانه قد جعل نسخ الظل بالشمس تدريجيًّا وبمقدار ، ولم يجعله دفعة واحدة ، وفي ذلك منافع للناس تحفظ عليهم نظام حياتهم ونشاطهم » .
قال الله تبارك وتعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾(الفرقان: 45- 46) .
أولاً- هذه الآية الكريمة بيان لبعض دلائل قدرة الله عز وجل وتوحيده . والخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمراد به العموم ؛ لأن المقصود من الآية الكريمة بيان نعم الله تعالى بالظل ، وجميع المكلفين مشتركون في أنه يجب تنبُّههم لهذه النعمة ، وتمكُّنهم من الاستدلال بها على وجود الصانع . ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما بيِّن جهل المعترضين على دلائل الصانع وفساد طريقتهم ، ذكر أنواعًا من الدلائل الواضحة التي تدل على قدرته التامة ؛ لعلهم يتدبرونها ويؤمنون بمن هذه قدرته وتصرفه في عالمه ، فبدأ تعالى بحال الظل في زيادته ونقصانه ، وتغيره من حال إلى حال ، وأن ذلك جار على مشيئته سبحانه .
وتركيب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ﴾ يفيد معنيين : أحدهما التنبيه والتذكير . والثاني : التعجيب من الأمر العظيم ؛ كقولك : ألم تر إلى فلان يقول كذا ، ويعمل كذا ، على طريق التعجيب منه . والتعجيب يقوم على أحد أمرين : إما على الإنكار والاستهجان والاستغراب . وإما على الاستحسان والاستعظام والإجلال . والحال في كلا الأمرين ببعث على التنبيه ، بمعنى : التأمل والتبصر والاعتبار ، وهو ما دعا إليه القران الكريم في كثير من آياته .
ومن الأول قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾(إبراهيم: 28) ، ومن الثاني قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ . فهذا استفهام الغرض منه التذكير والتنبيه ، وإثارة تعجيب المخاطب من هذا الظل الدال على عظمة الله جلت قدرته ، وبديع صنعه ، وبالغ حكمته ، ويدعو المتأمل المتبصر إلى التفكير فيه : كيف يمده الله ويبسطه ، فينتفع به الناس انتفاعًا لا يبلغه إحصاء ولا وصف . ولو شاء ، لجعله ساكنًا لا يتحرك . ثم كيف جعل الشمس دليلاً عليه ، يستدل الناس بها على أحوال الظل : أين يمتد وينبسط ، ومتى يكون ذلك ؟ وأين يتقلص ويتلاشى ، ومتى يكون ذلك ؟ ثم كيف جعل الشمس بمشيئته تعالى تنسخ شيئًا فشيئًا هذا الظل الممتد المبسوط ؟
والرؤية في قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ ، وقوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ﴾ ، ونحوهما ، رؤية بصرية ؛ لأنها هي التي تتعدى بـ( إلى ) . ونظيرهما قوله تعالى :﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (الغاشية:17) . وعليه يكون المعنى في الآية التي نحن بصددها : ألم تنظر إلى بديع صنع ربك نظر تأمل وتبصر واعتبار كيف مد الظل .. وكون الرؤية هنا بصرية أولى من كونها علمية للعلة التي ذكرناها .
وإنما قال تعالى هنا :﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، ولم يقل :﴿ أَلَمْ تَنْظُر ﴾ ؛ لأن حقيقة النظر هي تقليب البصر حيال مكان المرئي طلبًا لرؤيته ، ولا يكون ذلك إلا مع فقد العلم . والشاهد قولهم : نظر ، فلم يَرَ شيئًا . ويقال : نظر إلى كذا ، إذا مدَّ طرفه إليه ، رآه أو لم يرَه . أما الرؤية فهي إدراك الشيء من الجهة المقابلة ، ولا يكون إلا مع وجود العلم .
بقي أن تعلم أن الفرق بين الرؤية والعلم : أن الرؤية لا تكون إلا لموجود ، والعلم يتناول الموجود والمعدوم . وكل رؤية لم يعرض معها آفة فالمرئي بها معلوم ضرورة . وكل رؤية فهي لمحدود ، أو قائم في محدود ؛ كما أن كل إحساس من طريق اللمس ، فإنه يقتضي أن يكون لمحدود ، أو قائم في محدود . فإذا علمت ذلك ، تبين لك سِرَّ التعبير بفعل الرؤية هنا ، دون التعبير بفعل النظر ؛ كأن يقال :﴿ أَلَمْ تنْظُر ﴾ ؟ أو التعبير بفعل العلم ؛ كأن يقال :﴿ أَلَمْ تَعْلَم ﴾ ؟
وكان حق التعبير أن يقال :( ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ) ؛ لأن الظل المقيَّد بالحال - وهو كيفية مده- هو المقصود بتوجيه الرؤية إليه . ولكن عُدِل عنه إلى قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ ؛ لأن المقام- هنا- مقام إثبات الوحدانية والإلهية لله تبارك وتعالى ؛ ولهذا أوثر تعلق فعل الرؤية باسم الذات المفصح عن الربوبية ابتداء ، ثم جيء بالحال بعد ذلك ، وهو كيفية مد الظل .
وقال الفاضل الطيبي :« لو قيل : ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ، كان الانتقال من الأثر إلى المؤثر . والذي عليه التلاوة كان عكسه ، والمقام يقتضيه ؛ لأن الكلام في تقريع القوم وتجهيلهم في اتخاذهم الهوى إلهًا ، مع وضوح هذه الدلائل ؛ ولذلك جعل ما يدل على ذاته تعالى مقدمًا على أفعاله في سائر آياته ؛ كقوله تعالى :﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾(الفرقان: 47- 48) .
وفي التعرض لعنوان الربوبية في قوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإيذان بأن ما يعقبه هو من آثار ربوبيته ورحمته سبحانه تعالى . أما ﴿ كَيْفَ ﴾ فهي مجردة عن معنى الاستفهام ، ومُخلَصة للدلالة على الحال ، أو الهيئة التي صار إليها الظل بعد مدِّه . و﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ : بسطه بعد أن كان منقبضًا ؛ ومنه قولهم : مدَّ الحبل ، ومدَّ يده . ويطلق المدُّ ويراد به الزيادة في الشيء ، وهو استعارة شائعة ، وهو هنا الزيادة في مقدار الظل .
وقيل : المراد بـ﴿ الظِّلِّ ﴾ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما . وقيل : هو من غياب الشمس إلى طلوعها . وذهب كثير من المفسرين إلى أن القول الأول هو الأصح .. وأصحُّ منهما قول من قال : المراد به ما يكون من مقابلة جسم كثيف للشمس عند ابتداء طلوعها ؛ كجبل ، أو بناء ، أو شجر ، أو نحو ذلك .
وإنما قلنا هذا أصح الأقوال ؛ لأن المراد من الآية الكريمة تنبيه الناس على عظيم قدرة الله عز وجل ، وبالغ حكمته سبحانه ، فيما يشاهدونه ؛ فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه ، وبين الشمس جسم مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضَحِّ الشمس .
قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن :« الظلُّ ضدُّ الضَّحِّ ، وهو أعم من الفيء ؛ فانه يقال : ظِلُّ الليل ، وظِلُّ الجنة . ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس : ظِلٌّ ، ولا يقال : الفَيْءُ إلا لما زال عنه الشمس » . والضَّحُّ من الضحى ، وهو انبساط الشمس ، وامتداد النهار . وقيل : الظل ما نسخته الشمس ، والفيء ما نسخ الشمس .. وقيل : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل , وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل .
وقوله تعالى :﴿ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ جملة شرطية معترضة بين المعطوف ، والمعطوف عليه ، للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل للأسباب العادية من قرب الشمس إلى الأفق الشرقي على الأول ، أو قيام الشاخص الكثيف على الثاني ؛ وإنما المؤثر فيه حقيقة المشيئة والقدرة . والمعنى : ولو شاء الله تعالى ، لجعل الظل ثابتًا على حاله ظلاًّ أبدًا ؛ كما فعل عز وجل في ظل الجنة . أو لجعله ثابتًا على حاله من الطول والامتداد .. وفي ذلك أيضًا تذكير للعباد بأن في جعل الظل ممدودًا . أي : متحركًا منَّة من الله تعالى عليهم ، تستوجب الحمد والشكر .
وقابل تعالى قوله :﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ بقوله :﴿ سَاكِنًا ﴾ . والسكون إنما يقابل الحركة ؛ فدل ذلك على أنه قد أطلق مد الظل على الحركة مجازًا ؛ وذلك من باب تسمية الشيء باسم ملابسه ، أو سببه . كما دلت هذه المقابلة على حالة مطوية من الكلام ؛ وهي حالة عموم الظل جميع وجه الأرض . أي : حالة الظلمة التي سبقت اتجاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض ؛ كما أشار إلى ذلك قول التوراة في الإصحاح واحد من سفر الخروج :« وكانت الأرض خالية ، وعلى وجه القمر ظلمة . وقال الله : ليكن نور ، فكان نور .. » . وواضح أن استدلال القرآن بالظل أجدى من استدلال التوراة بالظلمة ؛ لأن الظلمة عدم ، لا يكاد يحصل الشعور بجمالها ، بخلاف الظل الذي يجمع بين النور والظلمة ، فكلا دلالتيه واضحة .
ثانيًا- وقوله تعالى :﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ عطف على قوله تعالى :﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ ، داخل في حكمه . أي : جعلنا الشمس دليلاً على ظهوره للحس ؛ فإن الناظر إلى الجسم الملون حال قيام الظل عليه ، لا يظهر له شيء سوى الجسم ولونه ، ثم إذا طلعت الشمس ، ووقع ضوؤها على الجسم ، ظهر له أن الظل كيفية زائدة على الجسم ولونه . والضد يظهر حالة الضد . هذا قول الرازي والطبري وغيرهما .. أو : جعلنا الشمس علامة يُسْتدَلُّ بأحوالها المتغيرة على مقادير امتداد الظل ، من غير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعًا ، حسبما نطقت به الجملة الشرطية المعترضة بينهما ؛ وهي :﴿ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ .
وقال تعالى :﴿ دَلِيلاً ﴾ بالتذكير ، وهو صفة الشمس ، ولم يقل :﴿ دَلِيلةً ﴾ ، فيؤنِّثه ؛ لأن الدليل في معنى الاسم ، فكما يقال : الشمس برهان ، والشمس حق ؛ كذلك يقال : الشمس دليل .. والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى :﴿ جَعَلْنَا ﴾ ، يؤذن بعظَم قدْر هذا الجعل ؛ لما يستتبعه من المصالح التي لا تحصى . ثم هو أدخل في الامتنان من ضمير الغائب ؛ فهو مشعر بأن هذا الجعل نعمة عظيمة ، وهي نعمة النور التي بها تتميَّز أحوال المرئيات . وعلى هذا يكون قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ ارتقاء بالمنَّة بعد قوله تعالى :﴿ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ . أما ﴿ ثُمَّ ﴾ فهي للتراخي الزماني ؛ كما هو حقيقة معناها . أو للتراخي الرتبي . أي : أزلنا الظل بعدما أنشأناه ممتدًّا ، ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه من غير أن يكون له تأثير في ذلك أصلاً .. وتعدية ﴿ دَلِيلاً ﴾ بـ( على ) تفيد أن دلالة الشمس على الظل- هنا- دلالة تنبيه على شيء قد يخفى ؛ كقول الشاعر :
إلى الله أشكو أنني لست ماشيًا ** ولا جائيًا إلا عليَّ دليل
أي : رقيب يدل عليَّ . والدليل هو المرشد إلى الطريق والهادي إليه ؛ فجعل امتداد الظل لاختلاف مقاديره كامتداد الطريق ، وعلامات مقادير ؛ مثل صُوَى الطريق ، وجعلت الشمس من حيث كانت سببًا في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مراحل ، بطريقة التشبيه البليغ . فكما أن الهادي يخبر السائر في الطريق أين ينزل ؛ كذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعرِّف المستدل بالظل بأوقات أعماله ؛ ليشرع فيها .
ثالثًًا- قوله تعالى :﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ يعني : ثم قبضنا هذا الظل الممدود إلينا قبضًا هيِّنًا خفيًّا ، شيئًا فشيئًا. أي : بالتدرج والمهل ، حسب ارتفاع دليله على وتيرة معينة مطردة ، لمعرفة الساعات والأوقات التي تتوقف عليها مصالح العباد . وفيه لمحة من معنى قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾(البقرة: 18) .
وقيل : إن الله تعالى حين بنى السماء كالقبَّة المضروبة ، ودحا الأرض تحتها ، ألقت القبَّة ظلَّها على الأرض ، لعدم وجود الشمس ؛ وذلك مدُّه تعالى الظل . ولو شاء لجعله ساكنًا مستقرًا على تلك الحالة إلى يوم القيامة . ثم خلق الشمس ، وجعلها على ذلك الظل دليلاً . أي : سلَّطها عليه ، ونصبها دليلاً متبوعًا له ؛ كما يتبَع الدليل في الطريق ؛ فهو يزيد بها وينقص ، ويمتد ويقلص ، ثم نسخه بها ، فقبضه قبضًا سهلاً يسيرًا .
و﴿ ثُمَّ ﴾ يحتمل أن تكون للتراخي الزماني ، وأن تكون للتراخي الرتبي على نحو ما مر . وجيء بصيغة ﴿ قَبَضْنَاهُ ﴾ ماضية للدلالة على تحقق الوقوع ، ولمناسبة ما ذكر معه . وإنما عبَّر عنه بالقبض المنبىءِ عن جمع المنبسط وطيِّه ، لما أنه قد عبَّر عن إحداثه بالمدِّ الذي هو البسط طولاً . شبَّه الظل بحبل ، أو ثوب طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة الاستعارة المكنية . وكذلك عبَّر عن نقص الظل بالقبض الذي هو ضد المد على طريقة الاستعارة .
وقوله تعالى:﴿ إِلَيْنَا ﴾ للتنصيص على كون مرجع الظل إليه عز وجل ، لا يشاركه- حقيقة- أحد في قبضه ؛ كما أن حدوثه منه سبحانه ، لا يشاركه- حقيقة- أحد في إيجاده ومده . وقوله تعالى :﴿ قَبْضًا ﴾ مصدر مؤكد لفعله ، و﴿ يَسِيرًا ﴾ صفته . أي : قبضًا غير عسير .
وفي وجود الظل بأحواله المتغيرة التي أفادها الفعل ﴿ مَدَّ ﴾ دقائق من أحوال النظام الشمسي ، تشير إلى دقة التكوين الإلهي ، وتدل على القدرة العظيمة . وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات ، وأعمال الناس ، ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس ، وفوائد الفيء ، بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرَّد بحلول الظل ، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه .
هذا هو محل العبرة والمنة اللتين تتناولهما عقول الناس على اختلاف مداركهم ، ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي ، وحركة الأرض حول الشمس ، وظهور الظلمة والضياء . فليس الظل إلا أثر الظلمة ؛ فإن الظلمة هي أصل كيفيَّات الأكوان ، ثم انبثق النور بالشمس ، ونشأ عن تداول الظلمة والنور نظام الليل والنهار ، وعن ذلك نظام الفصول ، وخطوط العرض والطول للكرة الأرضية ، وبها عرفت مناطق الحرارة والبرودة .
ومن وراء ذلك كله إشارة إلى أصل المخلوقات ، كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدمًا ، وكيف يمتد وجودها في طور نمائها ، ثم كيف تعود إلى العدم تدريجًا في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم المحض ؛ وذلك مما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ ، فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية الكريمة مع المنة ، والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس ، وأحوال الشباب ، وتقدم السن ، وأنهم صائرون عقب ذلك إلى ربهم يوم يبعثون مصيرًا لا إحالة فيه ولا بعد ؛ كما يزعم الكافرون والملحدون .
ولما صار قبض الظل مَثلاً لمصير الناس إلى ربهم بالبعث ، وصف سبحانه وتعالى قبض الظل باليسير ، تلميحًا إلى قوله جل وعلا :﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾( ق : 44) . وفي ذلك كله إشارة إلى أن الحياة في هذه الدنيا كظل يمتد ، ثم ينقبض شيئًا فشيئًا ؛ ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم :« ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ، ثم تركها ».
وقال الألوسي في كتابه ( ما دل عليه القرآن مما يعضِّد الهيئة الجديدة القويمة البرهان ) ، تعقيبًا على قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ ، قال :« دلت هذه الآية على أن الشمس متحركة ؛ لأن الظل تابع لها ؛ لأنه يكون من مقابلة كثيف- كجبل أو ماء أو شجر- للشمس عند ابتداء طلوعها . ولو شاء ، لجعله ساكنًا ؛ وذلك بأن لا يجعل سبحانه للشمس عليه . أي : على نسخه سبيلاً بأن يطلعها ، ولا يدعها تنسخه . أو بأن لا يدعها تغيِّره باختلاف أوضاعها بعد طلوعها ».
وأضاف قائلاً :« وقوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ معناه : جعلنا طلوع الشمس دليلاً على ظهوره للحس . وقوله :﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ﴾ . أي : ثم أزلناه ، بعد ما أنشأناه ممتدًّا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه . أو بإيقاعه كذلك ، ومحوناه على مهل قَليلاً قليلاً بحسب مسير الشمس » .
وانتهى من ذلك إلى القول :« وفيه دليل على كروية الأرض ؛ لأنها لو لم تكن كروية ، لتساوت الأقطار في الأفياء والظلال ، مع أن كثيرًا من الأقطار يكون فيه ليل ، وفي أقطار أخرى نهار .. ولأرباب الهيئة الجديدة أن يقولوا : إن الظلال تابع لحركة الشمس على حسب ما يراه الرائي ؛ وإلا ففي الحقيقة أن الأرض هي المتحركة على مركزها ، وهي الشمس . ولا بدع أن تكون الشمس دليلاً على الظل ، وإن كانت الحركة للأرض » .
وقال صاحب كتاب ( القرآن وإعجازه العلمي ) :« في هذه الآية دليل قوي على دوران الأرض حول نفسها ، وأن هذا الدوران ضروري للكائنات الحية فوق الأرض ؛ لأنها لو كانت غير متحركة ، لسكن الظل ولم يتغير طولاً أو قصرًا ، ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الكرة الأرضية باستمرار ، بينما يظل النصف الآخر ليلاً دائمًا ، وهذا ما يسبب اختلافًا كبيرًا في التوازن الحراري على الأرض ، ويؤدى ذلك إلى هلاك البشر من شدة الحرارة ، أو من شدة البرودة ، والله سبحانه قد جعل نسخ الظل بالشمس تدريجيًّا وبمقدار ، ولم يجعله دفعة واحدة ، وفي ذلك منافع للناس تحفظ عليهم نظام حياتهم ونشاطهم » .