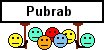فضل محمد البرح
إن طيب النفس
وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته
لهي ثمرة من ثمار العبودية لله تعالى، فما ينتاب الشعورُ بالطمأنينة
والسكينة والراحة العبدَ بعد تأديته العبادة والطاعة لعمري إنها جنة الدنيا
ورياضها التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: “إذا مررتم
برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر”، وقال :”ما
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”.
قال ابن
تيمية رحمه الله تعالى: “… فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له
لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ”. العبودية – (1 / 25).
وهذه اللذة
والراحة بالعبادة والأنس بها وجدها الكثير من الصالحين، حتى قال بعضهم عما
يجده من لذة للعبادة والطاعة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه
لجالدونا عليه بالسيوف. لاسيما وأن ثمة لحظات تمر على العبد يجد فيها بغيته
من السعادة والطمأنينة، حتى قال بعض السلف: إنه يمر بالقلب أوقات أقول
فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب!.
وليس النعيم
خاصا بالجنة وحدها.. نعم نقول إنه من خصائص الجنة التي لا يشوبها هم ولا
كدر، بخلاف الدنيا فإنها مزيج مابين الراحة واللغوب، فالجنة لا تجمع النعيم
إلى جانب بعض المنغصات التي تطرأ على الحياة الدنيا.
قال بعض الصالحين: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
قال ابن
القيم عند قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ
الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 13 ـ 14]… ولا تظن أن قوله تعالى إن
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في
نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، وأي لذة ونعيم في
الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى، ومحبته والعمل
على موافقته! وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ الجواب الكافي – (1
/ 84).
وقال عن
عبادة الذكر: “إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن
للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به،
ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: وما تلذذ
المتلذذون بمثل ذكر الله عز و جل فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ولا
أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب”. الوابل الصيب – (1 / 110).
وقال:… وإذا
كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت
لذة خيرا منها، وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة، وهي لذة الدار
الآخرة ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال الله تعالى: {وَلاَ
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} [العنكبوت: 56 ـ 57] وقال تعالى:
{لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ
الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} [يوسف: 12] وقال تعالى:
{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}
[الأعلى: 16 ـ 17] وقال تعالى: {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 29 ـ 64] وقال العارفون
بتفاوت ما بين الأمرين “وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا
توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير
ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها في
العاجلة والآجلة وإن لم تشغل” . روضة المحبين – (1 / 161).
وليس ما يجده
العبد من الأنس والسعادة في العبادة واللذة الممنوحة جراء تلك الطاعة،
ويهرع إليها عندما تدلهم عليه الهموم والأحزان من الشرك في شيء، بل هو عين
التأويل لنصوص الوحي، حيث قد ثبت كثير منها التي تحث على ما يزيل الهموم
والأحزان، وتبعد الأمراض والأسقام، من الأدعية والأذكار، وتكون تعبدية
يُقصد بها رضى الله تعالى والدار الآخرة.
وثمة فرق بين
من يجعل الأمور التعبدية للانتفاع الجسدي الخالص كمن يصوم للصحة، يصلي
للرياضة؛ فهذا غير الذي يمكن أن تطرأ عليه الوسواس في ذلك، فالأول ليس له
حظ من هذه العبادة، بخلاف الثاني فإنه خاطر ووساوس يدفعه بالإخلاص
والاستمرار على تلك العبادة، فإنه ما قصد بها إلا الله ثم البحث عمَّا
يسعده في الدارين.
ومما يجدر
التنبيه عليه: أن العبد إذا شعر بالراحة عقب الطاعة والعبادة عليه أن يتذكر
ذلك النعيم المقيم، واللذة التي لا تنقطع في دار الخلد، فهذا أحرى أن لا
ينجر وراء وساوسه وشكوكه، فتجعله يركن إلى الدعة ويتوانى عن الطاعة.
إن طيب النفس
وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته
لهي ثمرة من ثمار العبودية لله تعالى، فما ينتاب الشعورُ بالطمأنينة
والسكينة والراحة العبدَ بعد تأديته العبادة والطاعة لعمري إنها جنة الدنيا
ورياضها التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: “إذا مررتم
برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر”، وقال :”ما
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”.
قال ابن
تيمية رحمه الله تعالى: “… فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له
لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ”. العبودية – (1 / 25).
وهذه اللذة
والراحة بالعبادة والأنس بها وجدها الكثير من الصالحين، حتى قال بعضهم عما
يجده من لذة للعبادة والطاعة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه
لجالدونا عليه بالسيوف. لاسيما وأن ثمة لحظات تمر على العبد يجد فيها بغيته
من السعادة والطمأنينة، حتى قال بعض السلف: إنه يمر بالقلب أوقات أقول
فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب!.
وليس النعيم
خاصا بالجنة وحدها.. نعم نقول إنه من خصائص الجنة التي لا يشوبها هم ولا
كدر، بخلاف الدنيا فإنها مزيج مابين الراحة واللغوب، فالجنة لا تجمع النعيم
إلى جانب بعض المنغصات التي تطرأ على الحياة الدنيا.
قال بعض الصالحين: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
قال ابن
القيم عند قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ
الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 13 ـ 14]… ولا تظن أن قوله تعالى إن
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في
نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، وأي لذة ونعيم في
الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى، ومحبته والعمل
على موافقته! وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ الجواب الكافي – (1
/ 84).
وقال عن
عبادة الذكر: “إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن
للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به،
ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: وما تلذذ
المتلذذون بمثل ذكر الله عز و جل فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ولا
أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب”. الوابل الصيب – (1 / 110).
وقال:… وإذا
كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت
لذة خيرا منها، وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة، وهي لذة الدار
الآخرة ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال الله تعالى: {وَلاَ
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} [العنكبوت: 56 ـ 57] وقال تعالى:
{لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ
الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} [يوسف: 12] وقال تعالى:
{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}
[الأعلى: 16 ـ 17] وقال تعالى: {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 29 ـ 64] وقال العارفون
بتفاوت ما بين الأمرين “وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا
توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير
ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها في
العاجلة والآجلة وإن لم تشغل” . روضة المحبين – (1 / 161).
وليس ما يجده
العبد من الأنس والسعادة في العبادة واللذة الممنوحة جراء تلك الطاعة،
ويهرع إليها عندما تدلهم عليه الهموم والأحزان من الشرك في شيء، بل هو عين
التأويل لنصوص الوحي، حيث قد ثبت كثير منها التي تحث على ما يزيل الهموم
والأحزان، وتبعد الأمراض والأسقام، من الأدعية والأذكار، وتكون تعبدية
يُقصد بها رضى الله تعالى والدار الآخرة.
وثمة فرق بين
من يجعل الأمور التعبدية للانتفاع الجسدي الخالص كمن يصوم للصحة، يصلي
للرياضة؛ فهذا غير الذي يمكن أن تطرأ عليه الوسواس في ذلك، فالأول ليس له
حظ من هذه العبادة، بخلاف الثاني فإنه خاطر ووساوس يدفعه بالإخلاص
والاستمرار على تلك العبادة، فإنه ما قصد بها إلا الله ثم البحث عمَّا
يسعده في الدارين.
ومما يجدر
التنبيه عليه: أن العبد إذا شعر بالراحة عقب الطاعة والعبادة عليه أن يتذكر
ذلك النعيم المقيم، واللذة التي لا تنقطع في دار الخلد، فهذا أحرى أن لا
ينجر وراء وساوسه وشكوكه، فتجعله يركن إلى الدعة ويتوانى عن الطاعة.