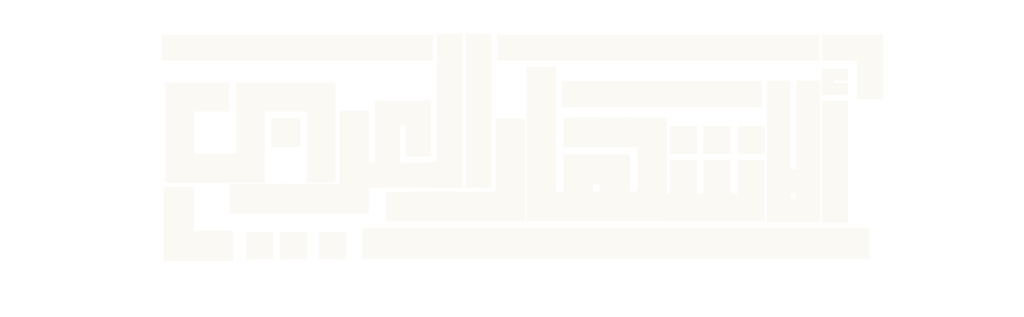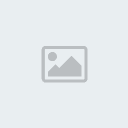
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله - تعالى-: (( إِنَّ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً
وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.. الآيات))(190) سورة آل عمران.
ورد عن عائشة - رضي الله عنها -
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنها ذات مرة في أن تتركه يقوم
الليل؛ وقد كانت - رضي الله عنها- تحب قربه والجلوس معه، فتركته - صلى
الله عليه وسلم - لقيام الليل، فقام من الليل يصلي ويبكي حتى آذنه بلال
بأذان الفجر، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حاله، فقال له:
(لقد أنزلت عليّ الليلة آيات ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها).
فإعمالاً لحديث الرسول - صلى
الله عليه وسلم - نقفُ وإياكم مع هذه الآيات الكريمات وقفات تأمل وتفكر
لنأخذ الدروس والعبر والفوائد، فمن فوائد هذه الآيات ومناسبة نزولها في
الحديث ما يلي:
- أن لله - عز وجل - سجلان
مفتوحان للنظر والتأمل والتفكير، وكلا السجلين يحملان آيات بينات، وحجج
واضحات على وحدانية الصانع، وانفراد الخالق، أول السجلين هو الكون الفسيح،
والسماء الواسعة، والأرض المنبسطة، وما بينهما من المخلوقات، وجميعها شاهد
على وحدانية الله - تعالى-:
وفي كلِّ شيءٍ له آية تدل على أنه الواحد
وأما السجل الثاني فهو القرآن
الكريم، المتضمن لشرعة المكلفين من البشر، ومنهاج العالمين من العباد حتى
يستقيم سيرهم مع سير الكون الخاضع لله، والمسبح له.
((وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم))، وفي كلا السجلين وضوح القدرة الإلهية، وإبداع
الله في خلقه، وأمره وعظمته القاهرة، وعلمه المحيط.
- أن التأمل في خلق السماوات
والأرض، وحركة الزمان، وسير عجلة التاريخ؛ زيادة إيمان ويقين، مما جعل
الله - عز وجل - يمدح أهله ((بأنهم أولوا الألباب)).
وإن مما نلاحظه أننا وللأسف
الشديد أحاطتنا حضارة اليوم من صنعها ما جعلنا نغفل عن آيات الله الكونية،
فأصبحنا معلبين في بيوت صماء، وآلات عجماء، وحركة لا حياة فيها، حتى إن
معالم الأرض بدأت تختفي من تحتنا، ومناظر الطبيعة تنسحب من حولنا، فلا
نشاهد أشجاراً ولا طيوراً، مما له أكبر الأثر على غفلة القلوب، وتجمد
الفكر.
- قوله تعالى: ((واختلاف الليل
والنهار)) أي تعاقبهما جيئة وذهاباً، وسيرهما السير الحثيث، بحيث يغيران
في الإنسان حاله وأحواله، ففي كل واحد منها شأن، حتى يقضي آجل الإنسان في
ساعة بل في لحظة من لحظاتها، فكان المتأمل في حركة الزمان من حوله، وغياب
الناس عنه، وذهاب الرفقة حيناً فحيناً، وفراق الأحبة تارة بعد تارة، متأمل
لحقيقة حياته في ظل ((السماوات والأرض)) فهي حياة زائلة حياة فانية
محدودة.
إنه يخرج بسؤال استنكاري على نفسه:
((كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون)).
- قوله تعالى: ((لآيات لأولي
الألباب)) تشمل أن تكون الآيات هنا بمعنى العلامات، العلامات على التوحيد،
والعلامات على السنن التي يجري عليها الكون، والعلامات على كيفية تسخير
هذا الكون من أجل الاستخلاف الذي ذكره الله - تعالى- عن بني آدم: ((وإذ
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة)).
أما العلامات على التوحيد فيلخصه
قوله تعالى: (( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ))(22) سورة
الأنبياء، وقوله تعالى: ((مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ
مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ))(91) سورة
المؤمنون.
وأما علامات على سنن الله التي
يجري عليها الكون فكيف لا وهي تسير بدقة عالية: ((الشمس والقمر بحسبان))،
وتجري في خطوطها الخاصة: ((كل في فلك يسبحون))، ولا يطغى بعضها على بعض:
((بينهما برزخٌ لا يبغيان))((لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ))(40) سورة يــس، ولكلٍ منهم دورته ومنازله: (( وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ))(39)
سورة يــس، وصدق الله إذا يقول: ((وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ
تَقْدِيراً ))(2) سورة الفرقان، وقال: ((والذي قدر فهدى)).
وقد ركب الله - تعالى- الكون على
سنن ثابتة حتى يستطيع الإنسان اكتشافها ومواكبتها وتسخيرها لاحتياجاته قال
تعالى: ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج))، أي مواقيت يعرفون
بها الأشهر ومطالعها، ويقول تعالى عن النجم (( وعلامات وبالنجم هم
يهتدون))، يهتدون به لمعرفة الفصول السنوية، ومواعيد الزراعة، وحركة
الرياح، وموسم الأمطار، ولولا ذلك لما صلح لهم شأن، كما أنها علامات لهم
لمعرفة الاتجاهات ليلاً ليستدلوا الطريق، ويعرفوا وجهة السير.
وأما كونه ما في السماوات والأرض
علامات على كيفية تسخير ما في الكون لصالح الإنسان فأول ما يحكيه لنا
القرآن في هذا الباب قصة ابني آدم الذي قتل أحدهما الآخر حيث ((طوعت له
نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ
فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا
وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ
سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ))(31) سورة المائدة، لقد
رأى ابن آدم غرابين يختصمان فقتل أحدهما الآخر فلما قضى عليه بحث في الأرض
أي حفر فيها ثم دفنه، وواراه بالتراب، فكانت بعد سنة في بني آدم، ولولا
ذلك لم يهنأ لهم عيش، ولم تطب لهم حياة.
- قوله: ((لأولي الألباب)) هذا
ثناء من الله - عز وجل - على الإنسان بأفضل ما فيه من الخلقه ألا وهو
العقل؛ لأن العقل وعاء العلم، والعلم دليل إلى الإيمان، فكان العقل وعاء
للإيمان أيضاً، ومن كان إيمانه نابع من دون عقل كان في تدينه خلل، وفي
منهاجه زلل، فلم يذكر الله معصية ألا وعقب عليها بقوله: ((أفلا يعقلون))،
وما أمر سبحانه بخير ومصلحة للعباد إلا وعقب عليها بقوله: ((لعلكم
تعقلون)) وذلك في أغلب ما وردت فيه هذه الكلمة من الآيات.
بل لقد عاب أهل النار على أنفسهم
عدم العقل (( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً
لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ))(10- 11) سورة الملك.
- ومن فوائد الآيات في قوله
تعالى: ((الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم)) ما معلوم لدينا
أيها الأخوة من أن الذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ - ذكر القلب من الرغبة، والرهبة، والخوف، والرجاء، والتعظيم، والمحبة.
ب- وذكر اللسان من التسبيح، والتكبير، والتهليل، والدعاء، والأذكار، وقراءة القرآن... إلخ.
ج- وذكر الجوارح من صلاة، وصدقة،
وصوم، وحج، وجهاد، وعمل بالمعروف، وسعى في سبيل العيش، وصدق الله إذ
يقول: ((اعملوا آل داود شكراً وقليلٌ من عبادي الشكور)).
ومن فوائد هذه الآية إن أعظم
الناس عقلاً، وأرفعهم منزلة، وأعمقهم إيماناً، وأثبتهم يقيناً؛ اللاهجون
بذكر الله في جميع أحوالهم، مستفرقين جميع الأمكنة والأزمنة، ولقد كان
الرسول - صلى الله عليه وسلم - القدوة والأسوة في ذلك، ولذلك فقد شرع
لأمته الأذكار:
فمن أذكار الأزمنة: أذكار
الصباح، وأذكار المساء، وأذكار رؤية الهلال، ورؤية البدر، والصلاة في
الثلث الأخير من الليل، والقراءة في الأسحار .. وغير ذلك.
ومن الأذكار ما يتغير فيها حال الذاكر: كأذكار الخروج، والدخول، والسفر، والنوم، واللبس.. إلخ.
ومن الأذكار ما يتعلق بمظاهر الكون: كأذكار هبوب الرياح، وسماع صوت الديك، وصلاة الكسوف والخوف، ونزول المطر... وغير ذلك.
ولقد غفل الكثير منا عن هذه
الأذكار، وحفظها وأدائها عند أوقاتها، مما سبب قسوة القلوب، وجفاف الأنفس،
واللبيب من تذكره آيات الكون بذكر الله، ويدفعه ذكر الله للتفكر في الكون.
وفي هذه الآية أيضاً: دليل على
الفارق الجوهري بين الحضارة الإسلامية في مجال العلوم والاستكشاف وبين
الحضارة الغربية، تلك الحضارة التي ذهبت تنقب عن كل صغيرة وكبيرة في
الحياة دون هدف رباني، أو صلة بالله؛ فخرجت على البشرية بأبشع آلات الدمار
والفتك والعذاب، وبأحط مناهج العيش والحياة حتى أنه ليصدق عليهم قول الله
- تعالى-: (( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
سَبِيلاً ))(43-44) سورة الفرقان.
وفي الآية كذلك إشارة إلى طبيعة الإنسان المتحركة، وتفضيل لمبدأ الحركة عن مبدأ السكون والخمول الذي لم يجبل عليه الإنسان.
ولذلك قدم - سبحانه وتعالى -
المؤمن الذاكر لله في قيامه - والقيام دليل الحركة، دليل العمل، دليل
النشاط، دليل التنقل - ثم عقب سبحانه بالمنزلة الثانية الأ وهي القعود، ثم
عقب بالجنب كناية عن السكون والدعة إلى الراحة والخمول بعد النشاط.
إذن فرغم حاجة الإنسان لهذه الحالات الثلاثة إلا أن أفضلها إطلاقاً هي الأولى؛ لأنها تعبر عن كامل القوة والإرادة، والعمل، والعطاء.
- وفي قوله تعالى: ((ويتفكرون في
خلق السماوات والأرض)) وصف لهؤلاء الذاكرين، إذن فالمسألة سلسلة تبدأ من
الحكمة الإلهية في الخلق: ((إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
والنهار لآيات لأولي الألباب)) وتنتهي بالنتيجة الطبيعية ألا وهي أداء
أولى الألباب للغاية والحكمة الإلهية التي خلق الله الكون لأجلها؛
((يذكرون الله قياماً وقعوداً ويتفكرون في خلق السماوات والأرض))، ويخلصون
بعقيدة يشاركهم فيها كل شيء في السماوات والأرض؛ وكل ذرةٍ فيه، ((ربنا ما
خلقت هذا باطلاً سبحانك))، إنها عقيدة التوحيد النتيجة الطبيعية للعقل
السليم، والتفكير الصحيح، والفطرة النقية.
وما أجمل العبارة، وما ألطف
الكلمات، وما أقرب المعاني، وأتقن الأسلوب، تأمل قولهم: ((ربنا ما خلقت
هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار)).
إنها عقيدة ذات اتصال مباشر
بالله، تخاطبه عن مكنون ذاتها، وتصارحه بمحض إيمانها ((ربنا))، إنها نداء
العرفان، نداء التودد والتحبب، نداء إبداء الضعف والاعتراف بالنعمة
((ربنا)).
((ما خلقت هذا)) إشارة إلى ما
بين أيديهم من آيات الكون، هذا (إشارة للقريب البين كما أنها إشارة للبعيد
المستعصي)، وجاءوا بصيغة النفى ليكون المعنى أبلغ ((ما خلقتَ هذا
باطلاً))، والباطل يقابل الحق، والباطل الفاسق، والباطل الزائل، والباطل
الذي لا نفع فيه ولا فائدة معه.
((سبحانك)) تسبيح يحمل معنيين:
معنى التنزيه في الأسماء والصفات، أي سبحانك من أن توصف بالعبث أو اللهو،
أو نقص القدرة، أو ضعف السلطان، سبحانك أن يشاركك في هذا الخلق إله آخر،
أو شريك ثان، أو ولد، أو والد.
((سبحانك)) والمعنى الثاني: ((سبحانك)) لا ينبغي أن نشرك بك أحد من خلقك، ولا ينبغي لنا أن نخالف حكمتك في الخلق والإيجاد.
إنه تسبيح لله في أفعاله ووصفه، وفي استحقاقه، ولا يصح لمؤمن موحد إيمان إلا بهما جميعاً.
ثم تختم الآية بقولهم: ((فقنا عذاب النار))؟!
إنه ختام لطيف مناسب لمقدمة
الآية وللآية السابقة، فإذا كان الخلق أي خلقوا لحكمة ((ما خلقت هذا
باطلاً)) فما مصير المخالف لهذه الحكمة، وما جزاءه؟ هل يتساوى مع المحقق
للمراد الإلهي والمحبوب الرباني ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون))
((أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)).
أتنتهي الحياة بالجميع إلى
الفناء، أينطوي سجل التاريخ بأعمال الفريقين دون جزاء، إنه عبث، إنه شقاء.
ظلم أن يتساوى العقلاء والحمقى!
إن الشرعة الإلهية تخبرنا أن هذا
الكون ليس نهاية المطاف.. كلا، بل وراء هذه الحياة حياة أخرى أعظم وأجل
وأرفع، ينال كل واحد من الفريقين جزاءه العدل، فإما جنة، وإما نار، وليست
أي نار إنها نار تقلق العارفين بعظمة الخالق، وصدق وعده ووعيده، تقلقهم
ليرددوا: ((سبحانك فقنا عذاب النار)).
فهم بذلك يخافون ألا يؤدون رسالتهم في الحياة أداءً كلياً فيخلدون في النار، أو أداءً جزئياً فينالون من عذابها بقدر تقصيرهم.
وأياً كان دخول النار أبدي
سرمدي، أو حقبة قصيرة؛ فإن مجرد الدخول مكروه لدى العقلاء، والنفوس
المستشعرة لضعفها ((ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته))، إنه خزي تأباه
النفوس الصادقة الشريفة العالية:
ولم أر في عيوب الناس عيب كعجز القادرين عن الكمال
(( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
على القوم الكافرين )).
وفي قوله تعالى: ((ربنا إنك من
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار)) فائدة جليلة، فإن كل من
خلقه الله لحكمة وغاية ووظيفة في هذا الكون، وزوده باحتياجاته للقيام بهذه
الوظيفة، والوصول إلى الغاية والعمل بمقتضى الحكمة، ثم يستر له الظروف،
وذلل له الصعاب، بل وأرشده الطريقة، وبين له السبيل، ثم بعد ذلك: يتراجع
عن وظيفته، ويتخلى عنها، أو يقصر في أدائها، إنه لا شك ظالم، ظالم للمنحة
الإلهية التي أعطيت له، وظالم للحياة التي عرقل وغير مجراها، وظالم لربه
حيث استوفى نعمة دون شكر، وقابل أمره دون تسليم، وإذا كان كذلك فأنى يجد
النصير، وكيف يفلت من العقوبة إلا أن يشاء الله رب العالمين.
ثم يتابع السياق تلك المناجاة
البريئة من القلوب الحية: ((ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن
آمنوا بربكم فآمنا))، إنه اجتماع الآيات الكونية، والآيات الشرعية في هذه
القلوب الحية، إنها استفادت مما ترى، واستفادت مما تسمع، استجابت لداعي
الفطرة، واستجابت لداعي الإيمان.
ويستفاد من الآية إن أولو
الألباب يميزون بين من ينادي للإيمان ومن ينادي للكفر، كيف لا وقد شهدت
لهم آيات الكون ببالغ الحكمة الإلهية، وتمام القدرة الربانية، بحيث أن
أمرها يتفق مع خلقها (( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)).
وفي قولهم: ((منادياً ينادي
للإيمان)) دليل على فهمهم لوظيفة الرسل والأنبياء فهم ينادون للإيمان،
يبلغون رسالات ربهم للناس ((أن آمنوا بربكم)) ومدار الإيمان بجميع أركانه
ينبني على هذا الأساس ((أن آمنوا بربكم)).
فمن الإيمان بالله ينبثق الإيمان
بأسمائه وصفاته، وأقواله وأفعاله، والإيمان برسوله وكتبه، وشرائعه،
والإيمان بقضاءه وقدره، والإيمان بملائكته، والإيمان باليوم الآخر،
والإيمان باليوم الآخر وما فيه.
ومن الطبيعي أن تستجيب العقول
السليمة لنداء الإيمان، وأن تعلن استجابتها مدوية (( فآمنا ))، ويبقى
الخوف من الطبيعة البشرية، والجبلة الطينية ألا تعين على القيام بواجبات
الإيمان وبمقتضياته على وجه الأداء والكمال، فينبعث من هذا الشعور توسل
متكرر ((ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا))، إنه خوف بتملك الإنسان
المؤمن من جراء الذنب وأثر السيئة، إنه يخاف أن يحجب عن ركب الأطهار
الأخيار الأبرار، فيندفع مردداً ((وتوفنا مع الأبرار)) إنها أمنية تتكرر
في نفس المؤمن كلما رأى خاتمة الأبرار الحسنة، ومصارع الفجار السيئة، إنها
أمنية يتحدد معها المشوار في الدار الآخرة قال - صلى الله عليه وسلم -:
((يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة))، ثم تأتي بقية الأماني تبعاً:
((ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف
الميعاد)).
هكذا هي النفوس المؤمنة عندما
تبلغ أقصى أحاسيسها بالضعف والحاجة إلى الله، إنها تعود راجية بتحقيق
الوعد الإلهي: (رغم علمها المسبق أن الله لا يخلف وعده) لكنها الخشية إذا
بلغت ذروتها، والخوف إذا لامس شغاف القلب؛ ولذلك نرى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في غزوة بدر يدعو ربه، ويلح له بالدعاء، ويردد: (أنجز لي نصرك
الذي وعدت)، وأمام هذا الإيمان، وهذه الخشية، وهذا الدعاء، وهذا الإلحاح
تأتي البشرى الإلهية: ((فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم))،
ذلك أن الإيمان عمل ((عمل قلبي، وعمل جوارحي)) ((عمل عاملٍ منكم من ذكر أو
أنثى بعضكم من بعض)) فليس الإخبار عما سبق يقتصر بأولي الألباب، بل يتعداه
إلى أولات الألباب من النساء المؤمنات.
(( فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا )).
وهذه جميعاً تبعات الإيمان،
وتكاليفه، وإعباءه، فمن أراد إيماناً بدون تكاليف، ولا أعباء، ولا تبعات
فهو هازل ومستهزئ ((ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين )).
فما جزاء من تحمل التكاليف، وأدى
التبعات، وصدق في إيمانه ((لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جناتٍ تجري من
تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب))، إنهم لن
يتجاوزوا التبعات، ولن يقوموا بالتكاليف بدون الوقوع في خطأ أو محظور، لكن
أداءهم للمهمة، ومحاولتهم للنجاح فيها كفيل بأن يكون سبباً لتكفير هذه
السيئات، وتكفير السيئات يكون بصور متعددة ذكرها أهل العلم، وأفردوها
بالدراسة.
ثم تكون العاقبة حسنة، والمعاد
محموداً ((ولأدخلنهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار))، إنه الثواب الإلهي
الذي لا يتخلف ولا يكذب ((ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب)).