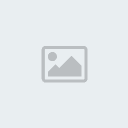من أسرار الإعجاز البياني في سورة المدثِّر
قال الله عز وجل :﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾(المدثر:26-31)
أولاً- هذه الآيات الكريمة من سورة المدثِّر ، وهي مكية بالإجماع ، وقد اختلفت الروايات في سبب ومناسبة نزولها . فهناك روايات تقول : إنها أول ما نزل في الرسالة بعد سورة العلق . ورواية أخرى تقول : إنها نزلت بعد الجهر بالدعوة ، وإيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم . وعن الزهري : أول ما نزل من القرآن قوله تعالى :
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾(العلق: 1) إلى قوله تعالى :﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾(العلق: 5)
فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل يعلو شواهق الجبال ، فأتاه جبريل- عليه السلام- فقال : إنك نبي الله ، فرجع إلى خديجة ، وقال :« دثِّروني ، وصبُّوا عليَّ ماء باردًا » ، فنزل قوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾(المدثِّر: 1)
وأيًا ما كان السبب والمناسبة ، فقد تضمنت السورة الكريمة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلَل ، أمر الدعوة إلى الله تعالى ، والجهاد في سبيله ، وإنذار البشر من عذابه وعقابه ، وتوجيهه إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان ، مع توجيهه عليه الصلاة والسلام إلى التهيؤ لهذا الأمر العظيم ، والاستعانة عليه بهذا الذي وجهه الله تعالى إليه .
﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾(المدثِّر: 2- 7)
ثانيًا- وقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لا يعم الأمة عند جمهور العلماء ، خلافًا لأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهما في قولهم : إنه يكون خطابًا للأمة ، إلا ما دل الدليل فيه على الفرق .
وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال :« يا : نداء النفس . وأيُّ : نداء القلب . وها : نداء الروح » . وعلماء النحو يقولون : « يا : نداءُ الغائب البعيد . وأيُّ : نداءُ الحاضر القريب . وها : للتنبيه » . وشتَّان ما بين القولين !
و﴿ الْمُدَّثِّرُ ﴾ : المتدرِّع دِثاره . وأصله : المتدثر فأدغم . يقال : دثرته ، فتدثر . والدِّثار : ما يتدثر به من ثوب وغيره .
وقوله تعالى :﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ . أي : قم نذيرًا للبشر . أي : تهيَّأ لذلك .. والإنذار هو أظهر ما في الرسالة ، فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد الغافلين السادرين في الضلال ، وهم لا يشعرون . وواضح من ذلك أن المراد بهذا الإنذار العموم ، دون تقييده بمفعول محدد ، ويدل عليه قوله تعالى :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾(سبأ: 28) .
والفاء في قوله تعالى :﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ ، مع كونها عاطفة للترتيب ، فإنها تدل على وجوب إيقاع الإنذار بتبليغ الرسالة ، عَقِبَ التهيؤ له مباشرة ، دون مهلة . وفي ذلك دليل على أن الإنذار فرض واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا بدَّ منه ، وهو فرض على الكفاية ، فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول ، وأن ينذروا كما أنذر . قال تعالى :﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(التوبة: 122) .
ثم إن في قوله تعالى :﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ إشارة إلى قوله تعالى :﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾(الإسراء: 15) . والتهيؤ للإنذار المعبَّر عنه بصيغة الأمر ﴿ قُمْ ﴾ لا يكون إلا بفعل ما تلا هذه الآية من توجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم .
ثالثًا- وبعد أن كلفه سبحانه وتعالى بإنذار الغير ، شرع سبحانه بتوجيهه في خاصَّة نفسه ، فوجهه أولاً إلى توحيد ربه ، وتنزيهه عمَّا لا يليق بجلاله وكماله . ووجهه ثانيًا إلى تطهير قلبه ونفسه وخلقه وعمله . ووجهه ثالثًا إلى هجران الشرك وموجبات العذاب . ووجهه رابعًا إلى إنكار ذاته بعدم المَنِّ بما يقدمه من الجهد في سبيل الدعوة ، ووجهه خامسًا وأخيرًا إلى الصبر لربه .
1- أما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى توحيد ربه وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾(المدثر: 3)
وذلك لأن الرب وحده هو المستحق للتكبير ؛ لأنه الأكبر من كل كبير . وهو توجيه يقرِّر الله جل وعلا فيه معنى الربوبية والألوهية ، ومعنى التوحيد ، والتنزيه من الشريك . وبيان ذلك : أن تكبير الرب جل وعلا يكون بقولنا :« الله أكبر » . فقولنا: « الله » هو إثبات لوجوده عز وجل . وقولنا :« أكبر » هو نفيٌ لأن يكون له شريك ؛ لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر ، فيما يكون فيه الاشتراك . وبهذا يظهر لنا أهميَّة هذا التوجيه الإلهي للرسول الكريم الذي انتدبه ربه لأن يكون نذيرًا للبشر ؛ فإن أول ما يجب على المرء معرفته هو معرفة الله تعالى ، ثم تنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله ، وإثبات ما يليق به جل وعلا .
وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية ، قال عليه الصلاة والسلام :« الله أكبر » . فكبرت معه خديجة وفرحت ، وأيقنا معًا أنه الوحي من الله عز وجل ، لا غيره . وفي التعبير عن لفظ الجلالة بعنوان الربوبية ، وإضافته إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، من اللطف ما لا يخفى !
وقيل : الفاء في قوله تعالى :﴿ فكبِّر ﴾ ، وفيما بعده ، لإفادة معنى الشرط ؛ وكأنه قال : ومهما يكن من أمر ، فكبر ربك ، وطهِّر ثيابك ، واهجر الرجز، واصبر لربك . فالفاء على هذا جزائية . ويسميها بعضهم : فاء الفصيحة ؛ لأنها تفصح عن شرط مقدَّر .
والحقيقة أن هذا تجنٍّ منهم على هذه الفاء ؛ لأن ما نسبوه إليها من الدلالة على ذلك الإفصاح المزعوم ؛ إنما هو من فعلهم هم ، لا من فعل هذه الفاء ؛ لأنهم لمَّا رأوها متوسطة بين ما يسمونه عاملاً ، ومعموله المقدم عليه- وكان جمهورهم قد أجمع على أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها- لجؤوا إلى هذا التأويل الذي لا يتناسب مع بلاغة القرآن ، وأسلوبه المعجز في التعبير . فأين قول الله جل وعلا :
﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ من قولهم في تأويله :« مهما يكن من شيء، فكبر ربك » ؟
ولهذا قال بعضهم : إن هذه الفاء دخلت في كلامهم على توهم شرط ، فلما لم تكن في جواب شرط محقق ، كانت في الحقيقة زائدة ، فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك .
وكلا القولين فاسد ، لما فيه من إخلال بنظم الكلام ومعناه . أما إخلاله بالنظم فظاهر . وأما إخلاله بالمعنى فإن الغرض من تقديم قوله تعالى :﴿ وَرَبَّكَ ﴾ هو التخصيص ، وربطه بما بعده ، وهو قوله تعالى :﴿ كَبِّرْ ﴾ . ولجعل هذا الأمر واجبَ الحدوث دون تأخير ، جيء بهذه الفاء الرابطة ، فقال سبحانه :﴿ وَرَبَّكَ فكَبِّرْ ﴾ .
هذا المعنى لا نجده في قولهم :« مهما يكن من شيء، فكبر ربك » ؛ لأن الشرط مَبناه على الإبهام . والمبهم يحتمل الحدوث ، وعدم الحدوث . فإذا قلت : إن جاءك زيد فأعطه درهمًا ، فإن الأمر بإعطاء الدرهم- وإن كان مستحقًا بدخول الفاء- فإنه مرتبط بمجيء زيد ، ومجيء زيد ممكن الحدوث ، وغير ممكن . ولهذا لما أراد الله تعالى أن يجعل الأمر بالتسبيح ، والاستغفار الواقعين جوابًا للشرط أمرًا واجب الحدوث ، استعمل من أدوات الشرط ﴿ إِذَا ﴾ التي تدل على أن ما بعدها محقق الحدوث لا محالة ، ثم أدخل الفاء الرابطة على الجواب ؛ وذلك قوله تعالى :﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾(النصر: 1- 3)
2- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى تطهير قلبه ونفسه وخلقه وعمله فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾(المدثر: 4)
وطهارة الثياب- في استعمال العرب- كناية عن طهارة القلب والنفس والخلق والعمل . إنها طهارة الذات التي تحتويها الثياب ، وكل ما يلمُّ بها ، أو يمسُّها . يقال : فلان طاهر الذيل والأردان ، إذا كان موصوفًا بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق . ويقال: فلان دنس الثياب للغادر ، ولمن قبح فعله . وكان العرب ، إذا نكث الرجل ولم يفِ بعهد ، قالوا : إن فلانًا لدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح ، قالوا : إن فلانًا لطاهر الثياب . وطهارة ذلك كله يستلزم طهارة البدن والثياب ؛ لأن من كان طاهر القلب والنفس والعمل ، فمن باب أولى أن يكون طاهر الجسم والثياب !
وبعد : فالطهارة بمفهومها العام هي الحالة المناسبة لتلقي الوحي من الملأ الأعلى ؛ كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة . وهي بعد هذا وذاك ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ ، ومزاولة الدعوة في وسط التيارات المختلفة ، والأهواء المتنازعة ، وما يصاحب ذلك ويلابسه من أدران الشرك وشوائبه . وذلك يحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث ، وملابسة المدنسين من غير أن يتدنس .
3- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى هجران الشرك وموجبات العذاب فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾(المدثر: 5)
أي : فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك ، وغيره من القبائح . والرُّجزُ- في الأصل- هو العذاب ، ثم أصبح يطلق على موجبات العذاب . وأصله الاضطراب ، وقد أقيم مقام سببه المؤدي إليه من المآثم والقبائح ؛ فكأنه قيل : اهجر المآثم والمعاصي ، وكل ما يؤدي إلى العذاب .
وقرأ الأكثرون : الرِّجز ، بكسر الراء ، وهي لغة قريش . ومعنى المكسور والمضموم واحد عند الجمهور . وعن مجاهد : أن المضموم بمعنى : الصَّنم . والمكسور بمعنى : العذاب . وفي معجم العين للخليل : الرُجْزُ ، بضم الراء : عبادة الأوثان ، وبكسرها : العذاب .
والرسول صلى الله عليه وسلم كان هاجرًا للشرك ولموجبات العذاب قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف ، وذلك الركام من المعتقدات السخيفة ، وذلك الرجس من الأخلاق والعادات ، فلم يعرف عنه أنه شارك في شيء من خَوْض الجاهلية ؛ ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميُّز الذي لا صلح فيه ، ولا هوادة ؛ فهما طريقان مفترقان لا يلتقيان . كما يعني هذا التوجيه التحرُّز من دنس ذلك الرجز . وقيل : الكلام- هنا وفيما قبله- من باب : إياك أعني ، واسمعي يا جارة ! والصواب من القول هو القول الأول ، والله تعالى أعلم !
4- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى إنكار ذاته بعدم المَنِّ بما يقدمه من الجهد في سبيل الدعوة استكثارًا له ، واستعظامًا فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾(المدثر: 6)
وهو نَهْيٌ عن المنِّ بما سيبذله من الجهد والتضحية في سبيل الدعوة إلى ربه . وفيه إشارة إلى أنه سيقدم الكثير ، وسيبذل الكثير ، وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء ؛ ولكن ربه تبارك وتعالى يريد منه ألاَّ يمتنَّ بما يقدمه ، وألاَّ يستكثره . فهذه الدعوة لا تستقيم في نفسٍ تُحِسُّ بما يُبذَل فيها من تضحيات . فالبذل فيها من الضخامة ، بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه ؛ بل حين لا تستشعره من الأصل ؛ لأنها مستغرقة في الشعور بالله ، شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضل الله تعالى ، ومن عطاياه . فهو فضل يمنحها إياه ، وعطاء يختارها له ، ويوفقها لنيله ، وهو اختيار واصطفاء وتكريم ، يستحق الشكر لله ، لا المنَّ والاستكثارَ . وهذا معنى قول الحسن والربيع :« لا تمنن بحسناتك على الله تعالى ، مستكثرًا لها » . أي : رائيًا إياها كثيرة ، فتنقص عند الله عز وجل .
5- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى الصبر لربه فهو المراد بقوله تعالى:
﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾(المدثر: 7)
أي : اصبر لربك على أذى المشركين . والأحسن حمله على العموم ، فيفيد الصبر على كل مصبور عليه ، ومصبور عنه . ويدخل فيه الصبر على أذى المشركين ؛ لأنه فرد من أفراد العام ، لا لأنه وحده هو المراد . والصبر بمفهومه العام هو الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة ، أو تثبيت ، وهو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة ، معركة الدعوة إلى الله تعالى ، وهي معركة طويلة عنيفة ، لا زاد لها إلا الصبر الذي يُقصَدُ فيه وجه الله جل وعلا ، ويُتَّجَهُ به إليه احتسابًا عنده وحده .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء الفرائض ، وله ثلاثمائة درجة . وصبر عن محارم الله تعالى ، وله ستمائة درجة . وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى ، وله تسعمائة درجة ؛ وذلك لشدته على النفس ، وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :« أسألك من اليقين ما تهون به عليَّ مصائب الدنيا » .
وللصبر المحمود فضائل لا تحصى ، ويكفي في ذلك قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(الزمر: 10) ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم :« قال الله تعالى : إذا وجهت إلى العبد من عبيدي مصيبة في بدنه ، أو ماله ، أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل ، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانًا ، أو أنشر له ديوانًا » .
رابعًا- فإذا ما انتهى هذا التوجيه الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم ، اتجه سياق الآيات إلى بيان ما ينذر به الكافرين ، في لمسة توقظ الحس لليوم العسير الذي ينذر بمقدمه النذير ، فقال سبحانه :
﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير ﴾( المدثر: 8-10 )
إنه التهديد ، والوعيد للمكذبين بالآخرة بحرب الله المباشرة . والنقر في الناقور هو ما يعبر عنه بالنفخ في الصور ؛ ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينه ؛ كأنه نَقْرٌ يُصَوِّت ، ويُدَوِّي . وأصله القَرْعُ الذي هو سببه . ومنه منقار الطائر ؛ لأنه يقرع به . والصوت الذي ينقر الآذان- أي : يقرعها قرعًا- أشد وقعًا من الصوت الذي تسمعه الآذان ؛ ولذلك وصف الله تعالى ذلك اليوم الذي ينقر فيه بالناقور بأنه :﴿ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ ، ثم أكَّده سبحانه بنفي كل ظِلًّ لليسر فيه :﴿ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير ﴾ ، فهو عسرٌ كله ، لا يتخلله يسرٌ أبدًا . والفاء في قوله تعالى :﴿ فَذَلِكَ ﴾ رابطة لجواب الشرط . و﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى وقت النقر المفهوم من قوله تعالى :﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ . أي : فذلك اليوم الذي ينقر فيه بالناقور يوم عسير على الكافرين ، غير يسير .
وفي الإشارة بـ﴿ ذَلِكَ ﴾ الدالة على معنى البعد ، مع قرب العهد لفظًا بالمشار إليه ، إيذانٌ ببعد منزلته في الهول والفظاعة . ثم ترك هذا اليوم مع وصفه هكذا مجملاً منكرًا :﴿ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ ، يوحي بالاختناق والكرب والضيق والهول العظيم . فما أجدر الكافرين ، وغيرهم من المؤمنين الغافلين أن يستمعوا للنذير ، قبل أن ينقر في الناقور ، فيواجههم ذلك اليوم العسير!
وقوله تعالى :﴿ غَيْرُ يَسِير ﴾ . أي : غير سهل ، ويفيد تأكيد عسره على الكافرين ، فهو يمنع أن يكون عسيرًا عليهم من وجه دون وجه ، ويشعر بتيسُّره على المؤمنين ؛ كأنه قيل : عسير على الكافرين ، غير يسير عليهم ؛ كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين . ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم ، وبشارة المؤمنين وتسليتهم .
ومع هذه البشارة للمؤمنين وتسليتهم ، فإن قلب المؤمن لا يخلو من الخوف من هذا اليوم العسير . روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال : لما نزلت :﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :« كيف أنعَمُ ، وصاحب الصور قد التقم القرن ، وحَنَى جبهته ، يستمع متى يؤمر ؟ » . قالوا : كيف نقول يا رسول الله ؟ قال :« قولوا : حسبنا الله ، ونعم الوكيل ، وعلى الله توكلنا » .
واختلف في أن المراد به يوم النفخة الأولى ، أو الثانية . والحق أنها النفخة الثانية ؛ إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين ، وأما النفخة الأولى فحكمها الذي هو الإصعاق يعمُّ الجميع ، على أنها مختصة بمن كان حيًّا عند وقوعها .
خامسًا- وينتقل السياق بنا من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من الكافرين المكذبين ، يبدو أنه كان له دور كبير في التكذيب والتبييت للدعوة . قيل: إنه الوليد بن المغيرة المخزومي. فيرسم الله تعالى مشهدًا من مشاهد كيده ؛ وذلك قوله تعالى :
﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا* وَبَنِينَ شُهُودًا* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾(المدثر:11- 15)
أي : ذرني مع من خلقته وحيدًا فريدًا ، لا مال له ، ولا ولد ، ثم جعلت له مالاً كثيرًا مبسوطًا- ما بين مكة والطائف- يعتزُّ به ، وبنين حضورًا ، يتمتع بمشاهدتهم ، لا يفارقونه للتصرف في عمل ، أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم . أو حضورًا في الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم- قيل : كان له عشرة بنين . وقيل : ثلاثة عشر . وقيل : سبعة ، كلهم رجال- وهيَّأت له الرياسة والجاه العريض تهيئة يتبطَّر بهما ويختال ، حتى لقِّب بريحانة قريش . ثم هو بعد ذلك كله يطمع في المزيد . فذرني معه ، أكفيك أمره ، ولا تشغل بالك بمكره وكيده .
وقوله تعالى :﴿ وَحِيدًا ﴾- على ما تقدم- حال من العائد المحذوف في قوله تعالى:﴿ خَلَقْتُ ﴾ . وقيل هو حال من الياء في قوله تعالى :﴿ ذَرْنِي ﴾ . أي : ذرني وحدي معه ، فإني أكفيكه في الانتقام منه . وقيل هو حال من التاء في قوله :﴿ خَلَقْتُ ﴾. أي : خلفته وحدي ، لم يشركني في خلقه أحد . والقول الأول أجمع الأقوال الثلاثة .
أما قوله تعالى :﴿ ذَرْنِي ﴾ فهو من : وَذََرَ يَذَرُ ؛ كوَدَعَ يَدَعُ ، إلا أن وَذَرَ ، لم يستعمل في كلامهم ، بخلاف : وَدَعَ . قال سيبويه : ولا يقال : وَذََرَ ، ولا وَدَعَ ، استغنوا عنهما بترك . وهذا إنما يخرَّج على الأكثر في : وَدَعَ . ففي القرآن ورد قوله تعالى :﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ ﴾ ، بالتخفيف ، وهي لغة كلغة التشديد ، وليست مخففة منها كما يقال . ثم هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة عروة بن الزبير .
وفي صحيح مسلم : أن عبد الله بن عمر ، وأبا هريرة سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :« لينتهيَّن أقوام عن ودَعهم الجُمُعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين » . وفي كشف الخفاء للعجلوني ، عن أبي داود ، عن رجل من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :« دعوا الحَبَشَة ما ودَعوكم ، واتركوا التُّرْكَ ما تركوكم » .
ويقال : يَذَرُ الشيءَ ؛ كما يقال : يَدَعُ الشيء . ومعناهما متقارب ، إلا أن الأول يستعمل في مقام التهديد والوعيد ، لما فيه من معنى الدفع والقذف . وأما الثاني فيستعمل في مقام الكره والبغض ، لما فيه من معنى التوديع . تأمل معنى الأول في قوله تعالى :﴿ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾(الأعراف: 127) ، وقوله تعالى :﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾(الطور: 45) . وتأمل معنى الثاني في قوله تعالى :﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ ومَا قَلَى ﴾(الضحى: 3) ، والتشديد فيه للمبالغة ؛ لأن من ودَّعك مفارقًا ، فقد بالغ في تركك .
أما قوله تعالى :﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ فهو استبعاد لطمعه وحرصه على الزيادة ، واستنكار لذلك . هذا ما دلت عليه ﴿ ثُمَّ ﴾ . وإنما استبعد ذلك منه ، واستنكر ؛ لأنه أعطي المال والبنين ، وبسط له الجاه العريض ، والرياسة في قومه ، واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا ، فلا مزيد على ما أعطي وأوتي . أو لأن طمعه في الزيادة لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم ؛ ولذلك ردعه الله تعالى ردعًا عنيفًا عن ذلك الطمع الذي لم يقدم طاعة ، ولا شكرًا لله يرجو بسببه المزيد ؛ بل عاند دلائل الحق ، ووقف في وجه الدعوة ، وحارب رسولها ، وصد عنها نفسه وغيره ، وأطلق حواليها الأضاليل ، فقال سبحانه وتعالى :
﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾(المدثر: 16)
فقوله تعالى :﴿ كَلاَّ ﴾ ردعٌ وزجرٌ له ، وردٌّ لطمعه الفارغ ، وقطعٌ لرجائه الخائب . وقوله تعالى:﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾ تعليل لذلك الطمع على سبيل الاستئناف ؛ فإن معاندة آيات المنعم مع وضوحها ، وكفران نعمه مع سبوغها ، مما يوجب إزالة النعمة المانعة عن الزيادة والحرمان منها بالكلية ؛ وإنما أوتي هذا المعاند ما أوتي ، استدراجًا له . قيل : ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده، حتى هلكوا .
ثم يعقِّب الله تعالى على هذا الردع والزجر بالوعيد الذي يبدل اليسر الذي جُعِل فيه عسرًا ، والتمهيد الذي مُهِّد له مشقة ، فيقول سبحانه وتعالى :
﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾(المدثر: 17)
وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعب الذي لا يطاق ، يصور حركة المشقة . فالتصعيد في الطريق هو أشق السير وأشده إرهاقًا . فإذا كان دفعًا من غير إرادة من المصعد ، كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقًا . وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن طريق الإيمان السهل الميسر ، يندبُّ في طريق وعر شاق مبتوت ، ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة وضيق ؛ كأنما يصعد في السماء ، أو يصعد في وعر صلد ، لا ريَّ فيه ولا زاد ، ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق !
وفي الترغيب والترهيب للمنذري ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في قوله :﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ :« جبل من نار يكلَّف أن يصعده ، فإذا وضع يده عليه ذابت ، فإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله عليه ذابت ، فإذا رفعها عادت ، يصعد سبعين خريفًا ، ثم يهوي كذلك » . رواه ( أحمد والحاكم والترمذي ) .
سادسًا- ثم يرسم الله تعالى لهذا الرجل المكذب المعاند صورة منكرة ، تثير الهزء والسخرية ، من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات ؛ كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات ، فيقول سبحانه :
﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾(المدثر: 18- 25)
فالرجل يكد ذهنه ، ويعصر أعصابه ، ويقبض جبينه ، وتكلح ملامحه وقسماته . كل ذلك ليجد عيبًا يعيب به هذا القرآن العظيم ، وليجد قولاً يقوله فيه . وبعد هذا المخاض كله يلد الجبل فأرًا ، وبعد هذا الحَزق كله ، لا يُفتح عليه بشيء ، فيولي عن النور مدبرًا ، ويصد عن الحق مستكبرًا ، ويقول :﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ !
وقوله تعالى :﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ تعليلٌ للوعيد ، واستحقاقه له . أو هو بيان لعناده لآيات الله تعالى .
وقوله تعالى :﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ تعجيبٌ من تقديره ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به . أو هو حكاية لما كرروه من قولهم : قتل كيف قدَّر ، تهكمًا بهم ، وبإعجابهم بتقديره ، واستعظامهم لقوله .
أما قوله تعالى :﴿ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ فهو تكرير للمبالغة . و﴿ ثُمَّ ﴾ للدلالة على أن ما بعدها أبلغ مما قبلها . وأما في قوله تعالى :﴿ ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ فهي باقية على أصلها من الدلالة على التراخي الزماني . أي : ثم نظر في القرآن مرة بعد مرة ، ثم قطَّب وجهه ، لمَّا لم يجد فيه مطعنًا ، ولم يدر ماذا يقول . وقيل : نظر في وجوه الناس ، ثم لمَّا عسُر عليه الرد ، قطَّب وجهه وبسَر . أي : كلح ، ثم أدبر عن الحق ، واستكبر عن اتباعه ، وقال :﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴾ . أي : يروَى ويتعلَّم .
وإنما عطف هذا بالفاء بعد أن عطف ما قبله بـ﴿ ثُمَّ ﴾ ، للدلالة على أن هذه الكلمة ، لما خطرت بباله ، لم يتملك أن نطق بها من غير تلعثم وتلبث . ثم أكَّدَ ذلك بقوله :﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ ؛ ولذلك لم يوسِّط بين الجملتين بأداة العطف .
وقد روي عنه- أي : عن الوليد بن المغيرة- أنه قال لبني مخزوم :« والله لقد سمعت من محمد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ، ولا من كلام الجن ، إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ، وما يعلى . فقالت قريش : صَبَأ ، والله الوليد . والله لتصبأن قريش كلهم . فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه ، فقعد عنده حزينًا ، وكلمه بما أحماه ، فقام ، فأتاهم ، فقال : تزعمون أن محمدًا مجنون ، فهل رأيتموه يخنق ؟ وتقولون : إنه كاهن ، فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه يتعاطى شعرًا قط ؟ وتزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب ؟ فقالوا في كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا : فما هو ؟ ففكر ، فقال : ما هو إلا ساحر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ، وولده ومواليه ، وما الذي يقوله إلا سحر يرويه عن أهل بابل ، ويتعلمه منهم . فارتجَّ النادي فرحًا ، وتفرقوا معجبين بقوله ، متعجبين منه » .
ولهذا يصور له التعبير القرآني المعجز هذه اللمحات الحيَّة التي يثبتها في المخيلة أقوى مما تثبتها الريشة في اللوحة ، وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار ، فتدع صاحبها سخريةَ الساخرين أبد الدهر ، وتثبت صورته الزَّرِيَّة في صلب الوجود ، تتملاها الأجيال بعد الأجيال !
سابعًا- فإذا ما انتهى الله تعالى من عرض هذه اللمحات الحيَّة الشاخصة لهذا المخلوق المضحك ، عقَّب عليها بالوعيد المفزع ، والتهديد الساحق ، فقال سبحانه :﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾(المدثر: 26) ، وهو بدل من قوله تعالى :﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ .
و﴿ سَقَرَ ﴾ هي- على ما قيل- الدرك السادس من النار ، ومنِع لفظها من التنوين للتأنيث . وقيل : إنه اسم أعجمي . والأول هو الصواب ؛ لأن الأعجمي إذا كان على ثلاثة أحرف ، انصرف ، وإن كان متحرك الأوسط . وأيضًا فإنه اسم عربي مشتق ، يقال : سَقَرَته الشمس ، إذا أحرقته . والسَّاقُورُ : حديدة تُحْمَى ، ويُكْوَى بها الحمار .
وزاد هذا التهديد ، وذلك الوعيد تهويلاً تنكير﴿ سَقَرَ ﴾ . ثم تكرارها في جملة استفهامية ، يزيد من تهويل أمرها ؛ وهي قوله تعالى :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾(المدثر: 27) . يريد : أيُّ شيء أدراك ما سقر ؟ أي: لم تبلغ درايتك غاية أمرها وعظم هولها ؛ لأنها شيء أعظم وأهول من الإدراك !
وقيل : كل ما في القرآن من قوله تعالى :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ ، فقد أدراه ، وما فيه من قوله :﴿ وَمَا يُدْريكَ ﴾ ، فلم يدره ؛ كقوله تعالى :﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾(الأحزاب: 63) . والدليل على الأول قوله تعالى :﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . فقد أدراه ما سقر؟ ومثله قوله تعالى :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾(القارعة: 3) . ثم أدراه ما القارعة ، فقال سبحانه :﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾(القارعة:4) ، ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾(القارعة:5)
ولما كان قوله تعالى :﴿ مَا سَقَرُ ﴾ ؟ و﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ؟ سؤالاً عن الماهيَّة ، لم يجز فيه الجمع بين الاسم ، وضميره؛ كما يفعل ذلك كثير من علماء وكتَّاب اليوم . فلا يقال : ما هي سقر ؟ وما هي القارعة ؟ وإنما يقال كما قال الله تعالى :﴿ مَا سَقَرُ ﴾ ؟ و﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ؟
أو يقال : ما هي ؟ إذا تقدم ذكر لها في الكلام ، فيقال : سقرٌ ما هي ؟ والقارعة ما هي ؟ كما قال تعالى :﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴾(القارعة: 9- 10) . فتأمل ذلك في القرآن ، تجده على ما ذكرت ، إن شاء الله !
ثم عقَّب الله تعالى على هذا تجهيل سقر ، وتهويل أمرها بذكر شيء من صفتها أشد هولاً وأعظم ، جوابًا عن السؤال السابق :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾(المدثر: 27) ، فقال سبحانه : ﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴾(المدثر: 28) . أي : لا تبقي شيئًا فيها إلا أهلكته ، وإذا هلك ، لم تذره هالكًا حتى يعاد . أو لا تبقي على شيء ، ولا تدعه من الهلاك ، حتى تهلكه . فكل شيء يطرح فيها هالك لا محالة ، وكأنها تبلعه بلعًا ، وتمحوه محوًا . وللدلالة على هذا المعنى جيء بـ﴿ لَا ﴾ مكررة بعد الواو العاطفة ؛ لأنه لو قيل : لا تبقي وتذر ، احتمل وقوع النفي على أحد الفعلين ، دون الآخر .
ثم هي بعد ذلك :﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾(المدثر: 29) . أي : مغيِّرة لهم ، أو محرقة ، بلغة قريش . يقال : لاحته الشمس ، ولوَّحته ، إذا غيرته . ويقال : لوحَّت الشيءَ بالنار : أحميته بها . وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- وجمهور العلماء : معناه : مغيِّرة للبشرات ، ومحرقة للجلود ، مسودة لها . فالبشر- على هذا- جمع بشرة .
وقال الحسن وابن كيسان :﴿ لَوَّاحَةٌ ﴾ بناء مبالغة من لاح يلوح ، إذا ظهر . فالمعنى : أنها تظهر للناس- وهم البشر- من مسيرة خمسمائة عام ؛ وذلك لعظمها وهولها وزفيرها . وقرىء :﴿ لَوَّاحَةً ﴾ ، بالنصب على الاختصاص للتهويل .
ثم إن :﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾(المدثر: 30) ملكًا هم خزنة جهنم ، المحيطون بها ، المدبرون لأمرها ، القائمون على تعذيب أهلها ، الذين إليهم جماع أمر زبانيتها ، باتفاق العلماء جميعهم .
وهكذا تتلاحق الآيات سريعة الجريان ، منوعة الفواصل والقوافي ، يتئد إيقاعها أحيانًا ، ويجري لاهثًا أحيانًا ، وبخاصة عند تصوير المشهدين الأخيرين : مشهد ذلك المكذب بالبعث ، وهو يفكر ، ويقدر ، ويعبس ، ويبسر .. ومشهد سقر التي لا تبقي ولا تذر ، ملوحة للبشر !
وواضح من ذلك كله أن الغرض من نزول هذه السورة الكريمة هو تكليف محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون نذيرًا للبشر من عذاب الله تعالى . والإنذار يحتاج إلى دليل تقام به الحجة . والدليل- هنا- هو المعجزة . والمعجزة هي في قوله تعالى :
﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾(المدثر: 30)
وروي أنه لما نزلت هذه الآية ، قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ! أسمع ابنَ أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم الدهر ! أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أبو الأشدِّ بن أسيد بن كلدة الجُمَحِيِّ ، وكان شديد البطش : أنا أكفيكم سبعة عشر ، فاكفوني أنتم اثنين . فأنزل الله تعالى قوله :
﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴾(المدثر: 31)
وأصحاب النار هم التسعة عشر ملكًا . والجمهور على أن المراد بهم النقباء الذين إليهم جماع زبانيتها كما تقدموإلا فقد جاء :« يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » .
وكان ظاهر الكلام يقتضي أن يقال :﴿ وَمَا جَعَلْنَاهم ﴾ ؛ ولكنه وضع الاسم الظاهر موضع الضمير ، وكأن ذلك لما في هذا الاسم الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبرون لأمرها ، القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير . وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر : النار مطلقًا ، لا طبقة خاصة منها ، وعليه يكون المعنى : وما جعلناهم إلا ملائكة لا يطاقون ، فهم من ذلك الخلق المغيَّب الذي لا يعلم طبيعته ، وقوته إلا الله تعالى ، وقد وصفهم الله عز وجل بقوله :
﴿ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾(التحريم : 6)
فقرر سبحانه وتعالى : أنهم غلاظ شداد ، يطيعون ما يأمرهم به الله ، وأن بهم القدرة على فعل ما يأمرهم ؛ فهم- إذًا- مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله تعالى به . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقر ، فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمة كما يعلمها الله ، فلا مجال لقهرهم ، أو مغالبتهم من هؤلاء البشر ! وما كان قول الكافرين عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله ، وتدبيره للأمور .
وقيل : لم يجعلهم الله تعالى بشرًا ؛ بل جعلهم ﴿ مَلَائِكَةً ﴾ ؛ ليخالفوا جنس المعذبين من الجن والإنس ، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ، ولا يستروحون إليهم ؛ ولأنهم أقوم من البشر بحق الله عز وجل ، وبالغضب له تعالى ؛ ولأنهم أشد الخلق بأسًا وأقواهم بطشًا .
وعن عمرو بن دينار:« واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر » . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصفهم :« كأن أعينهم البرق ، وكأن أفواهم الصياصي يجرون أشعارهم ، لأحدهم مثل قوة الثقلين ، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل ، فيرمي بهم في النار ، ويرمي بالجبل عليهم » .
ثامنًا- ثم أخبر تعالى عن الحكمة التي جعل من أجلها عدتهم تسعة عشر ، فقال سبحانه :
﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر ﴾(31)
أي : ما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا فتنة للذين كفروا ، ووسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب ، وزيادة في إيمان الذين آمنوا ، وحفظًا من ارتياب أهل الكتاب والمؤمنين ، وداعيًا إلى تقوُّل أهل الكفر والنفاق :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ .
فهذه خمس حكم من جعل عددهم : تسعة عشر . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : كيف يكون هذا العدد المخصص بـ﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ فتنة للذين كفروا ، ووسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب ، وازدياد الذين آمنوا إيمانًا ، وحفظًا من ارتياب أهل الكتاب والمؤمنين ، وداعيًا إلى تقول أهل النفاق والكفر ما قالوا ؟!
1- فأما كون هذا العدد فتنة وابتلاء للذين كفروا فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن الذين كفروا يستهزئون ، ويقولون : لمَ لمْ يكونوا عشرين ، أو ثمانية عشر مثلاً ؟ وذلك لأن حال هذا العدة الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته ، ويعترض ويستهزىء ، ولا يذعن إذعان المؤمن ، وإن خفي عليه وجه الحكمة .
والوجه الثاني : أنهم يقولون : كيف يكون هذا العدد القليل وافيًا بتعذيب أكثر الخلق من الجن والإنس ، من أول خلق آدم إلى يوم القيامة ؟
2- وأما كونه وسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب فلأنه مطابق لما عندهم في التوراة والإنجيل . فإذا سمعوا به في القرآن ، استيقنوا أنه منزل من عند الله تعالى ، ومصدق لما بين يديهم . وهذا مما يشهد لقومهم على صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم !
3- وأما كونه وسيلة إلى ازدياد الذين آمنوا إيمانًا فإن المؤمنين كلما جاءهم أمر عن ربهم صدقوه ، وإن لم يعلموا حقيقته ، اكتفاء بأنه من عند الله تعالى ؛ لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقيًا مباشرًا . وكل حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنسًا بالله ، وتزيد قلوبهم إيمانًا ، فتستشعر بحمكة الله في هذا العدد ، وتقديره الدقيق في الخلق .
ولمَّا أثبت الله تعالى بذلك العدد الاستيقان لأهل الكتاب ، وزيادة الإيمان للمؤمنين ، جعله حفظًا لهم من الوقوع في الريبة ، فجمع لهم بذلك : إثبات اليقين ، ونفي الريب . وإنما فعل ذلك ؛ لأنه آكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس ، وثلج الصدر ؛ ولأن فيه تعريضًا بحال من عَداهم ؛ كأنه قال : ولتخالف حالهم حال الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر .
وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب ؛ حيث لم يقل : ولا يرتابوا ، للتنبيه على تباين النفيين حالاً ؛ فان انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ، ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان ، ولا يخفى ما بينهما من الفرق .. والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث ﴿ الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾ ، للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم فيه .
4- وأما كونه داعيًا إلى تقوُّل أهل النفاق والكفر :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ ؟ فإن هذه السورة الكريمة مكية ، ولم يكن بمكة يومئذ نفاق ؛ وإنما نجم النفاق بالمدينة ، فأخبر الله تعالى أن النفاق سيحدث في قلوب هؤلاء في المدينة بعد الهجرة . وعلى هذا تصير هذه الآية الكريمة معجزة ؛ لأنها إخبار عن غيب سيقع ، وقد وقع على وفق الخبر ، فكان معجزًا .
وتعقيبًا على قولهم هذا قال الزمخشري :« فإن قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان ، وانتفاء الارتياب ، وقول المنافقين والكافرين ما قالوا ، فهب أن الاستيقان ، وانتفاء الريب يصح أن يكونا غرضين ، فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا ؟ قلت : أفادت اللام معنى العلة والسبب ، ولا يجب في العلة أن تكون غرضًا ؛ ألا ترى إلى قولك : خرجت من البلد مخافة الشر ؟ فقد جعلت المخافة علة لخروجك ، وما هي بغرضك » . أراد اللام التي في قوله تعالى :﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ﴾ .
وقولهم :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ ؟ إنما سموه مثًُلآ- على ما قال الزمخشري- لأنه استعارة من المثل المضروب ؛ لأنه مما غرُب من الكلام وبدُع ، استغرابًا منهم لهذا العدد ، واستبعادًا له . وقيل : لمَّا استبعدوه ، حسبوه مثلاً مضروبًا ؛ كما حسبه كذلك بعض الباحثين المعاصرين ، ممن ألفوا في أمثال القرآن . والمعنى : أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيب ؟ وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة عشر ، لا عشرين سواء ؟ ومرادهم : إنكاره من أصله ، وأنه ليس من عند الله ، وأنه لو كان من عند الله ، لما جاء بهذا العدد الناقص .
وهكذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين في القلوب المختلفة . فبينما الذين أوتوا الكتاب يستيقنون ، والذين آمنوا يزيدون إيمانًا ، إذا بضعاف القلوب ، والذين كفروا في حيرة يتساءلون :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ ؟ فهم لا يدركون حكمة هذا الأمر الغريب ، ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة في تقدير كل خلق ، ولا يطمئنون إلى صدق الخبر ، والخير الكامن في إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ؛ ولهذا أشاروا إليه بقولهم :﴿ هَذَا ﴾ استحقارًا للمشار إليه ، واستبعادًا له ؛ كقولهم :﴿ أهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (الفرقان:41) . وهذا هو حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يفتتن به كفرًا وجحودًا ، وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقًا .
وهنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء ما سمَّوْه :﴿ مَثلاً ﴾ من تقدير وتدبير ، فيقول تعالى :﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾(المدثر: 31) ، وهو إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية . أي : مثل ذلك المذكور من الإضلال والهداية يضل المنافقين والكافرين حسب مشيئته ، ويهدي المؤمنين حسب مشيئته . فكل أمر مرجعه في النهاية إلى مشيئة الله تعالى المطلقة التي ينتهي إليها كل شيء ، ومشيئته سبحانه تابعة لحكمته . وقد جاء هذا المعنى موضحًا في آيات أخر ؛ منها قوله تعالى :
﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾( إبراهيم: 27)
أي : يفعل ما توجبه الحكمة ؛ لأن مشيئة الله تعالى تابعة للحكمة من تثبيت الذين آمنوا ، وتأييدهم ، وعصمتهم عند ثباتهم وعزمهم ، ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية بينهم ، وبين شأنهم عند زللهم . ففعله تعالى كله حسن ؛ لأنه مبني على الحكمة والصواب . فأما المؤمنون فيسلمون بحكمة الله تعالى ، ويذعنون لمشيئته ، لاعتقادهم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة وحكمة ، فيزيدهم ذلك إيمانًا . وأما الكافرون فينكرون أفعاله سبحانه ، ويشكون فيها ؛ لأنهم لا يدركون حكمة الله تعالى فيها ، فيزيدهم ذلك كفرًا وضلالاً .. وفي وضع الفعلين :﴿ يُضِلُّ , ويَهْدي ﴾ موضع المصدر إشعار بالاستمرار التجددي . والمضارع يستعمل له كثيرًا ؛ ففي التعبير به- هنا- إشارة إلى أن الإضلال والهداية لا يزالان يتجددان ما تجدد الزمان .
وقال تعالى :﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾(المدثر:31) ؛ لأن علم ذلك من الغيب . والمراد : علم حقيقتها ، وصفاتها ، ووظائفها ، وأعدادها . والله تعالى يكشف عما يريد الكشف عنه من أمر جنوده ، وقوله سبحانه هو الفصل في شأنهم . وليس لقائل بعده أن يجادل ، أو يحاول معرفة ما لم يكشف الله تعالى عنه ؛ إذ فلا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ، ولو إجمالاً ، فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها ، من كم ، وكيف ، ونسبة !
وروى أن إبراهيم- عليه السلام- لما خرج من النار ، أحضره نمرود ، وقال له في بعض قوله : يا إبراهيم ! أين جنود ربك الذي تزعم ؟ فقال له عليه السلام : سيريك فعل أضعف جنوده . فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من بعوض ، فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم ، حتى كانت العظام تلوح بيضاء ، ودخلت منها بعوضة في رأس نمرود ، فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرها ، ثم هلك منها .
قال الألوسي في تفسيره روح المعاني :« هذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من جنود الله تعالى ، لا يعلم حقائقها وأحوالها إلا هو عز وجل . ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط بها نطاق الحصر ، أو يصل إلى مركزها طائر الفكر » .
وقوله تعالى :﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر ﴾(المدثر: 31) إما أن يعود على :﴿ جُنُود رَبِّكَ ﴾ . أو يعود على :﴿ سَقَرَ وَمَنْ عَليْهَا من جنود ربك ﴾ . أي : وما جنود ربك ، أو : وما سقر ، ومن عليها إلا ذكرى للبشر . وذكراها للبشر ؛ إنما جاء للتنبيه والتحذير ، لا ليكون موضوعًا للجدل ! والقلوب المؤمنة هي التي تتعظ بالذكرى ، أما القلوب الضالة فتتخذها جدلاً .
وقد يكون فيما قاله علماء الإعجاز العددي في تفسير هذه الآية الكريمة ما يكشف عن حقيقة هذا العدد .. والله تعالى أعلم ، له الحمد في السموات والأرض ، وهو بكل شيء عليم !
قال الله عز وجل :﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾(المدثر:26-31)
أولاً- هذه الآيات الكريمة من سورة المدثِّر ، وهي مكية بالإجماع ، وقد اختلفت الروايات في سبب ومناسبة نزولها . فهناك روايات تقول : إنها أول ما نزل في الرسالة بعد سورة العلق . ورواية أخرى تقول : إنها نزلت بعد الجهر بالدعوة ، وإيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم . وعن الزهري : أول ما نزل من القرآن قوله تعالى :
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾(العلق: 1) إلى قوله تعالى :﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾(العلق: 5)
فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل يعلو شواهق الجبال ، فأتاه جبريل- عليه السلام- فقال : إنك نبي الله ، فرجع إلى خديجة ، وقال :« دثِّروني ، وصبُّوا عليَّ ماء باردًا » ، فنزل قوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾(المدثِّر: 1)
وأيًا ما كان السبب والمناسبة ، فقد تضمنت السورة الكريمة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلَل ، أمر الدعوة إلى الله تعالى ، والجهاد في سبيله ، وإنذار البشر من عذابه وعقابه ، وتوجيهه إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان ، مع توجيهه عليه الصلاة والسلام إلى التهيؤ لهذا الأمر العظيم ، والاستعانة عليه بهذا الذي وجهه الله تعالى إليه .
﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾(المدثِّر: 2- 7)
ثانيًا- وقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لا يعم الأمة عند جمهور العلماء ، خلافًا لأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهما في قولهم : إنه يكون خطابًا للأمة ، إلا ما دل الدليل فيه على الفرق .
وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال :« يا : نداء النفس . وأيُّ : نداء القلب . وها : نداء الروح » . وعلماء النحو يقولون : « يا : نداءُ الغائب البعيد . وأيُّ : نداءُ الحاضر القريب . وها : للتنبيه » . وشتَّان ما بين القولين !
و﴿ الْمُدَّثِّرُ ﴾ : المتدرِّع دِثاره . وأصله : المتدثر فأدغم . يقال : دثرته ، فتدثر . والدِّثار : ما يتدثر به من ثوب وغيره .
وقوله تعالى :﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ . أي : قم نذيرًا للبشر . أي : تهيَّأ لذلك .. والإنذار هو أظهر ما في الرسالة ، فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد الغافلين السادرين في الضلال ، وهم لا يشعرون . وواضح من ذلك أن المراد بهذا الإنذار العموم ، دون تقييده بمفعول محدد ، ويدل عليه قوله تعالى :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾(سبأ: 28) .
والفاء في قوله تعالى :﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ ، مع كونها عاطفة للترتيب ، فإنها تدل على وجوب إيقاع الإنذار بتبليغ الرسالة ، عَقِبَ التهيؤ له مباشرة ، دون مهلة . وفي ذلك دليل على أن الإنذار فرض واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا بدَّ منه ، وهو فرض على الكفاية ، فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول ، وأن ينذروا كما أنذر . قال تعالى :﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(التوبة: 122) .
ثم إن في قوله تعالى :﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ إشارة إلى قوله تعالى :﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾(الإسراء: 15) . والتهيؤ للإنذار المعبَّر عنه بصيغة الأمر ﴿ قُمْ ﴾ لا يكون إلا بفعل ما تلا هذه الآية من توجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم .
ثالثًا- وبعد أن كلفه سبحانه وتعالى بإنذار الغير ، شرع سبحانه بتوجيهه في خاصَّة نفسه ، فوجهه أولاً إلى توحيد ربه ، وتنزيهه عمَّا لا يليق بجلاله وكماله . ووجهه ثانيًا إلى تطهير قلبه ونفسه وخلقه وعمله . ووجهه ثالثًا إلى هجران الشرك وموجبات العذاب . ووجهه رابعًا إلى إنكار ذاته بعدم المَنِّ بما يقدمه من الجهد في سبيل الدعوة ، ووجهه خامسًا وأخيرًا إلى الصبر لربه .
1- أما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى توحيد ربه وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾(المدثر: 3)
وذلك لأن الرب وحده هو المستحق للتكبير ؛ لأنه الأكبر من كل كبير . وهو توجيه يقرِّر الله جل وعلا فيه معنى الربوبية والألوهية ، ومعنى التوحيد ، والتنزيه من الشريك . وبيان ذلك : أن تكبير الرب جل وعلا يكون بقولنا :« الله أكبر » . فقولنا: « الله » هو إثبات لوجوده عز وجل . وقولنا :« أكبر » هو نفيٌ لأن يكون له شريك ؛ لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر ، فيما يكون فيه الاشتراك . وبهذا يظهر لنا أهميَّة هذا التوجيه الإلهي للرسول الكريم الذي انتدبه ربه لأن يكون نذيرًا للبشر ؛ فإن أول ما يجب على المرء معرفته هو معرفة الله تعالى ، ثم تنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله ، وإثبات ما يليق به جل وعلا .
وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية ، قال عليه الصلاة والسلام :« الله أكبر » . فكبرت معه خديجة وفرحت ، وأيقنا معًا أنه الوحي من الله عز وجل ، لا غيره . وفي التعبير عن لفظ الجلالة بعنوان الربوبية ، وإضافته إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، من اللطف ما لا يخفى !
وقيل : الفاء في قوله تعالى :﴿ فكبِّر ﴾ ، وفيما بعده ، لإفادة معنى الشرط ؛ وكأنه قال : ومهما يكن من أمر ، فكبر ربك ، وطهِّر ثيابك ، واهجر الرجز، واصبر لربك . فالفاء على هذا جزائية . ويسميها بعضهم : فاء الفصيحة ؛ لأنها تفصح عن شرط مقدَّر .
والحقيقة أن هذا تجنٍّ منهم على هذه الفاء ؛ لأن ما نسبوه إليها من الدلالة على ذلك الإفصاح المزعوم ؛ إنما هو من فعلهم هم ، لا من فعل هذه الفاء ؛ لأنهم لمَّا رأوها متوسطة بين ما يسمونه عاملاً ، ومعموله المقدم عليه- وكان جمهورهم قد أجمع على أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها- لجؤوا إلى هذا التأويل الذي لا يتناسب مع بلاغة القرآن ، وأسلوبه المعجز في التعبير . فأين قول الله جل وعلا :
﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ من قولهم في تأويله :« مهما يكن من شيء، فكبر ربك » ؟
ولهذا قال بعضهم : إن هذه الفاء دخلت في كلامهم على توهم شرط ، فلما لم تكن في جواب شرط محقق ، كانت في الحقيقة زائدة ، فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك .
وكلا القولين فاسد ، لما فيه من إخلال بنظم الكلام ومعناه . أما إخلاله بالنظم فظاهر . وأما إخلاله بالمعنى فإن الغرض من تقديم قوله تعالى :﴿ وَرَبَّكَ ﴾ هو التخصيص ، وربطه بما بعده ، وهو قوله تعالى :﴿ كَبِّرْ ﴾ . ولجعل هذا الأمر واجبَ الحدوث دون تأخير ، جيء بهذه الفاء الرابطة ، فقال سبحانه :﴿ وَرَبَّكَ فكَبِّرْ ﴾ .
هذا المعنى لا نجده في قولهم :« مهما يكن من شيء، فكبر ربك » ؛ لأن الشرط مَبناه على الإبهام . والمبهم يحتمل الحدوث ، وعدم الحدوث . فإذا قلت : إن جاءك زيد فأعطه درهمًا ، فإن الأمر بإعطاء الدرهم- وإن كان مستحقًا بدخول الفاء- فإنه مرتبط بمجيء زيد ، ومجيء زيد ممكن الحدوث ، وغير ممكن . ولهذا لما أراد الله تعالى أن يجعل الأمر بالتسبيح ، والاستغفار الواقعين جوابًا للشرط أمرًا واجب الحدوث ، استعمل من أدوات الشرط ﴿ إِذَا ﴾ التي تدل على أن ما بعدها محقق الحدوث لا محالة ، ثم أدخل الفاء الرابطة على الجواب ؛ وذلك قوله تعالى :﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾(النصر: 1- 3)
2- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى تطهير قلبه ونفسه وخلقه وعمله فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾(المدثر: 4)
وطهارة الثياب- في استعمال العرب- كناية عن طهارة القلب والنفس والخلق والعمل . إنها طهارة الذات التي تحتويها الثياب ، وكل ما يلمُّ بها ، أو يمسُّها . يقال : فلان طاهر الذيل والأردان ، إذا كان موصوفًا بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق . ويقال: فلان دنس الثياب للغادر ، ولمن قبح فعله . وكان العرب ، إذا نكث الرجل ولم يفِ بعهد ، قالوا : إن فلانًا لدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح ، قالوا : إن فلانًا لطاهر الثياب . وطهارة ذلك كله يستلزم طهارة البدن والثياب ؛ لأن من كان طاهر القلب والنفس والعمل ، فمن باب أولى أن يكون طاهر الجسم والثياب !
وبعد : فالطهارة بمفهومها العام هي الحالة المناسبة لتلقي الوحي من الملأ الأعلى ؛ كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة . وهي بعد هذا وذاك ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ ، ومزاولة الدعوة في وسط التيارات المختلفة ، والأهواء المتنازعة ، وما يصاحب ذلك ويلابسه من أدران الشرك وشوائبه . وذلك يحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث ، وملابسة المدنسين من غير أن يتدنس .
3- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى هجران الشرك وموجبات العذاب فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾(المدثر: 5)
أي : فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك ، وغيره من القبائح . والرُّجزُ- في الأصل- هو العذاب ، ثم أصبح يطلق على موجبات العذاب . وأصله الاضطراب ، وقد أقيم مقام سببه المؤدي إليه من المآثم والقبائح ؛ فكأنه قيل : اهجر المآثم والمعاصي ، وكل ما يؤدي إلى العذاب .
وقرأ الأكثرون : الرِّجز ، بكسر الراء ، وهي لغة قريش . ومعنى المكسور والمضموم واحد عند الجمهور . وعن مجاهد : أن المضموم بمعنى : الصَّنم . والمكسور بمعنى : العذاب . وفي معجم العين للخليل : الرُجْزُ ، بضم الراء : عبادة الأوثان ، وبكسرها : العذاب .
والرسول صلى الله عليه وسلم كان هاجرًا للشرك ولموجبات العذاب قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف ، وذلك الركام من المعتقدات السخيفة ، وذلك الرجس من الأخلاق والعادات ، فلم يعرف عنه أنه شارك في شيء من خَوْض الجاهلية ؛ ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميُّز الذي لا صلح فيه ، ولا هوادة ؛ فهما طريقان مفترقان لا يلتقيان . كما يعني هذا التوجيه التحرُّز من دنس ذلك الرجز . وقيل : الكلام- هنا وفيما قبله- من باب : إياك أعني ، واسمعي يا جارة ! والصواب من القول هو القول الأول ، والله تعالى أعلم !
4- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى إنكار ذاته بعدم المَنِّ بما يقدمه من الجهد في سبيل الدعوة استكثارًا له ، واستعظامًا فهو المراد بقوله تعالى :
﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾(المدثر: 6)
وهو نَهْيٌ عن المنِّ بما سيبذله من الجهد والتضحية في سبيل الدعوة إلى ربه . وفيه إشارة إلى أنه سيقدم الكثير ، وسيبذل الكثير ، وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء ؛ ولكن ربه تبارك وتعالى يريد منه ألاَّ يمتنَّ بما يقدمه ، وألاَّ يستكثره . فهذه الدعوة لا تستقيم في نفسٍ تُحِسُّ بما يُبذَل فيها من تضحيات . فالبذل فيها من الضخامة ، بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه ؛ بل حين لا تستشعره من الأصل ؛ لأنها مستغرقة في الشعور بالله ، شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضل الله تعالى ، ومن عطاياه . فهو فضل يمنحها إياه ، وعطاء يختارها له ، ويوفقها لنيله ، وهو اختيار واصطفاء وتكريم ، يستحق الشكر لله ، لا المنَّ والاستكثارَ . وهذا معنى قول الحسن والربيع :« لا تمنن بحسناتك على الله تعالى ، مستكثرًا لها » . أي : رائيًا إياها كثيرة ، فتنقص عند الله عز وجل .
5- وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى الصبر لربه فهو المراد بقوله تعالى:
﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾(المدثر: 7)
أي : اصبر لربك على أذى المشركين . والأحسن حمله على العموم ، فيفيد الصبر على كل مصبور عليه ، ومصبور عنه . ويدخل فيه الصبر على أذى المشركين ؛ لأنه فرد من أفراد العام ، لا لأنه وحده هو المراد . والصبر بمفهومه العام هو الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة ، أو تثبيت ، وهو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة ، معركة الدعوة إلى الله تعالى ، وهي معركة طويلة عنيفة ، لا زاد لها إلا الصبر الذي يُقصَدُ فيه وجه الله جل وعلا ، ويُتَّجَهُ به إليه احتسابًا عنده وحده .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء الفرائض ، وله ثلاثمائة درجة . وصبر عن محارم الله تعالى ، وله ستمائة درجة . وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى ، وله تسعمائة درجة ؛ وذلك لشدته على النفس ، وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :« أسألك من اليقين ما تهون به عليَّ مصائب الدنيا » .
وللصبر المحمود فضائل لا تحصى ، ويكفي في ذلك قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(الزمر: 10) ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم :« قال الله تعالى : إذا وجهت إلى العبد من عبيدي مصيبة في بدنه ، أو ماله ، أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل ، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانًا ، أو أنشر له ديوانًا » .
رابعًا- فإذا ما انتهى هذا التوجيه الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم ، اتجه سياق الآيات إلى بيان ما ينذر به الكافرين ، في لمسة توقظ الحس لليوم العسير الذي ينذر بمقدمه النذير ، فقال سبحانه :
﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير ﴾( المدثر: 8-10 )
إنه التهديد ، والوعيد للمكذبين بالآخرة بحرب الله المباشرة . والنقر في الناقور هو ما يعبر عنه بالنفخ في الصور ؛ ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينه ؛ كأنه نَقْرٌ يُصَوِّت ، ويُدَوِّي . وأصله القَرْعُ الذي هو سببه . ومنه منقار الطائر ؛ لأنه يقرع به . والصوت الذي ينقر الآذان- أي : يقرعها قرعًا- أشد وقعًا من الصوت الذي تسمعه الآذان ؛ ولذلك وصف الله تعالى ذلك اليوم الذي ينقر فيه بالناقور بأنه :﴿ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ ، ثم أكَّده سبحانه بنفي كل ظِلًّ لليسر فيه :﴿ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير ﴾ ، فهو عسرٌ كله ، لا يتخلله يسرٌ أبدًا . والفاء في قوله تعالى :﴿ فَذَلِكَ ﴾ رابطة لجواب الشرط . و﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى وقت النقر المفهوم من قوله تعالى :﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ . أي : فذلك اليوم الذي ينقر فيه بالناقور يوم عسير على الكافرين ، غير يسير .
وفي الإشارة بـ﴿ ذَلِكَ ﴾ الدالة على معنى البعد ، مع قرب العهد لفظًا بالمشار إليه ، إيذانٌ ببعد منزلته في الهول والفظاعة . ثم ترك هذا اليوم مع وصفه هكذا مجملاً منكرًا :﴿ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ ، يوحي بالاختناق والكرب والضيق والهول العظيم . فما أجدر الكافرين ، وغيرهم من المؤمنين الغافلين أن يستمعوا للنذير ، قبل أن ينقر في الناقور ، فيواجههم ذلك اليوم العسير!
وقوله تعالى :﴿ غَيْرُ يَسِير ﴾ . أي : غير سهل ، ويفيد تأكيد عسره على الكافرين ، فهو يمنع أن يكون عسيرًا عليهم من وجه دون وجه ، ويشعر بتيسُّره على المؤمنين ؛ كأنه قيل : عسير على الكافرين ، غير يسير عليهم ؛ كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين . ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم ، وبشارة المؤمنين وتسليتهم .
ومع هذه البشارة للمؤمنين وتسليتهم ، فإن قلب المؤمن لا يخلو من الخوف من هذا اليوم العسير . روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال : لما نزلت :﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :« كيف أنعَمُ ، وصاحب الصور قد التقم القرن ، وحَنَى جبهته ، يستمع متى يؤمر ؟ » . قالوا : كيف نقول يا رسول الله ؟ قال :« قولوا : حسبنا الله ، ونعم الوكيل ، وعلى الله توكلنا » .
واختلف في أن المراد به يوم النفخة الأولى ، أو الثانية . والحق أنها النفخة الثانية ؛ إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين ، وأما النفخة الأولى فحكمها الذي هو الإصعاق يعمُّ الجميع ، على أنها مختصة بمن كان حيًّا عند وقوعها .
خامسًا- وينتقل السياق بنا من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من الكافرين المكذبين ، يبدو أنه كان له دور كبير في التكذيب والتبييت للدعوة . قيل: إنه الوليد بن المغيرة المخزومي. فيرسم الله تعالى مشهدًا من مشاهد كيده ؛ وذلك قوله تعالى :
﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا* وَبَنِينَ شُهُودًا* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾(المدثر:11- 15)
أي : ذرني مع من خلقته وحيدًا فريدًا ، لا مال له ، ولا ولد ، ثم جعلت له مالاً كثيرًا مبسوطًا- ما بين مكة والطائف- يعتزُّ به ، وبنين حضورًا ، يتمتع بمشاهدتهم ، لا يفارقونه للتصرف في عمل ، أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم . أو حضورًا في الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم- قيل : كان له عشرة بنين . وقيل : ثلاثة عشر . وقيل : سبعة ، كلهم رجال- وهيَّأت له الرياسة والجاه العريض تهيئة يتبطَّر بهما ويختال ، حتى لقِّب بريحانة قريش . ثم هو بعد ذلك كله يطمع في المزيد . فذرني معه ، أكفيك أمره ، ولا تشغل بالك بمكره وكيده .
وقوله تعالى :﴿ وَحِيدًا ﴾- على ما تقدم- حال من العائد المحذوف في قوله تعالى:﴿ خَلَقْتُ ﴾ . وقيل هو حال من الياء في قوله تعالى :﴿ ذَرْنِي ﴾ . أي : ذرني وحدي معه ، فإني أكفيكه في الانتقام منه . وقيل هو حال من التاء في قوله :﴿ خَلَقْتُ ﴾. أي : خلفته وحدي ، لم يشركني في خلقه أحد . والقول الأول أجمع الأقوال الثلاثة .
أما قوله تعالى :﴿ ذَرْنِي ﴾ فهو من : وَذََرَ يَذَرُ ؛ كوَدَعَ يَدَعُ ، إلا أن وَذَرَ ، لم يستعمل في كلامهم ، بخلاف : وَدَعَ . قال سيبويه : ولا يقال : وَذََرَ ، ولا وَدَعَ ، استغنوا عنهما بترك . وهذا إنما يخرَّج على الأكثر في : وَدَعَ . ففي القرآن ورد قوله تعالى :﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ ﴾ ، بالتخفيف ، وهي لغة كلغة التشديد ، وليست مخففة منها كما يقال . ثم هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة عروة بن الزبير .
وفي صحيح مسلم : أن عبد الله بن عمر ، وأبا هريرة سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :« لينتهيَّن أقوام عن ودَعهم الجُمُعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين » . وفي كشف الخفاء للعجلوني ، عن أبي داود ، عن رجل من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :« دعوا الحَبَشَة ما ودَعوكم ، واتركوا التُّرْكَ ما تركوكم » .
ويقال : يَذَرُ الشيءَ ؛ كما يقال : يَدَعُ الشيء . ومعناهما متقارب ، إلا أن الأول يستعمل في مقام التهديد والوعيد ، لما فيه من معنى الدفع والقذف . وأما الثاني فيستعمل في مقام الكره والبغض ، لما فيه من معنى التوديع . تأمل معنى الأول في قوله تعالى :﴿ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾(الأعراف: 127) ، وقوله تعالى :﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾(الطور: 45) . وتأمل معنى الثاني في قوله تعالى :﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ ومَا قَلَى ﴾(الضحى: 3) ، والتشديد فيه للمبالغة ؛ لأن من ودَّعك مفارقًا ، فقد بالغ في تركك .
أما قوله تعالى :﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ فهو استبعاد لطمعه وحرصه على الزيادة ، واستنكار لذلك . هذا ما دلت عليه ﴿ ثُمَّ ﴾ . وإنما استبعد ذلك منه ، واستنكر ؛ لأنه أعطي المال والبنين ، وبسط له الجاه العريض ، والرياسة في قومه ، واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا ، فلا مزيد على ما أعطي وأوتي . أو لأن طمعه في الزيادة لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم ؛ ولذلك ردعه الله تعالى ردعًا عنيفًا عن ذلك الطمع الذي لم يقدم طاعة ، ولا شكرًا لله يرجو بسببه المزيد ؛ بل عاند دلائل الحق ، ووقف في وجه الدعوة ، وحارب رسولها ، وصد عنها نفسه وغيره ، وأطلق حواليها الأضاليل ، فقال سبحانه وتعالى :
﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾(المدثر: 16)
فقوله تعالى :﴿ كَلاَّ ﴾ ردعٌ وزجرٌ له ، وردٌّ لطمعه الفارغ ، وقطعٌ لرجائه الخائب . وقوله تعالى:﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾ تعليل لذلك الطمع على سبيل الاستئناف ؛ فإن معاندة آيات المنعم مع وضوحها ، وكفران نعمه مع سبوغها ، مما يوجب إزالة النعمة المانعة عن الزيادة والحرمان منها بالكلية ؛ وإنما أوتي هذا المعاند ما أوتي ، استدراجًا له . قيل : ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده، حتى هلكوا .
ثم يعقِّب الله تعالى على هذا الردع والزجر بالوعيد الذي يبدل اليسر الذي جُعِل فيه عسرًا ، والتمهيد الذي مُهِّد له مشقة ، فيقول سبحانه وتعالى :
﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾(المدثر: 17)
وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعب الذي لا يطاق ، يصور حركة المشقة . فالتصعيد في الطريق هو أشق السير وأشده إرهاقًا . فإذا كان دفعًا من غير إرادة من المصعد ، كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقًا . وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن طريق الإيمان السهل الميسر ، يندبُّ في طريق وعر شاق مبتوت ، ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة وضيق ؛ كأنما يصعد في السماء ، أو يصعد في وعر صلد ، لا ريَّ فيه ولا زاد ، ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق !
وفي الترغيب والترهيب للمنذري ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في قوله :﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ :« جبل من نار يكلَّف أن يصعده ، فإذا وضع يده عليه ذابت ، فإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله عليه ذابت ، فإذا رفعها عادت ، يصعد سبعين خريفًا ، ثم يهوي كذلك » . رواه ( أحمد والحاكم والترمذي ) .
سادسًا- ثم يرسم الله تعالى لهذا الرجل المكذب المعاند صورة منكرة ، تثير الهزء والسخرية ، من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات ؛ كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات ، فيقول سبحانه :
﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾(المدثر: 18- 25)
فالرجل يكد ذهنه ، ويعصر أعصابه ، ويقبض جبينه ، وتكلح ملامحه وقسماته . كل ذلك ليجد عيبًا يعيب به هذا القرآن العظيم ، وليجد قولاً يقوله فيه . وبعد هذا المخاض كله يلد الجبل فأرًا ، وبعد هذا الحَزق كله ، لا يُفتح عليه بشيء ، فيولي عن النور مدبرًا ، ويصد عن الحق مستكبرًا ، ويقول :﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ !
وقوله تعالى :﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ تعليلٌ للوعيد ، واستحقاقه له . أو هو بيان لعناده لآيات الله تعالى .
وقوله تعالى :﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ تعجيبٌ من تقديره ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به . أو هو حكاية لما كرروه من قولهم : قتل كيف قدَّر ، تهكمًا بهم ، وبإعجابهم بتقديره ، واستعظامهم لقوله .
أما قوله تعالى :﴿ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ فهو تكرير للمبالغة . و﴿ ثُمَّ ﴾ للدلالة على أن ما بعدها أبلغ مما قبلها . وأما في قوله تعالى :﴿ ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ فهي باقية على أصلها من الدلالة على التراخي الزماني . أي : ثم نظر في القرآن مرة بعد مرة ، ثم قطَّب وجهه ، لمَّا لم يجد فيه مطعنًا ، ولم يدر ماذا يقول . وقيل : نظر في وجوه الناس ، ثم لمَّا عسُر عليه الرد ، قطَّب وجهه وبسَر . أي : كلح ، ثم أدبر عن الحق ، واستكبر عن اتباعه ، وقال :﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴾ . أي : يروَى ويتعلَّم .
وإنما عطف هذا بالفاء بعد أن عطف ما قبله بـ﴿ ثُمَّ ﴾ ، للدلالة على أن هذه الكلمة ، لما خطرت بباله ، لم يتملك أن نطق بها من غير تلعثم وتلبث . ثم أكَّدَ ذلك بقوله :﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ ؛ ولذلك لم يوسِّط بين الجملتين بأداة العطف .
وقد روي عنه- أي : عن الوليد بن المغيرة- أنه قال لبني مخزوم :« والله لقد سمعت من محمد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ، ولا من كلام الجن ، إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ، وما يعلى . فقالت قريش : صَبَأ ، والله الوليد . والله لتصبأن قريش كلهم . فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه ، فقعد عنده حزينًا ، وكلمه بما أحماه ، فقام ، فأتاهم ، فقال : تزعمون أن محمدًا مجنون ، فهل رأيتموه يخنق ؟ وتقولون : إنه كاهن ، فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه يتعاطى شعرًا قط ؟ وتزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب ؟ فقالوا في كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا : فما هو ؟ ففكر ، فقال : ما هو إلا ساحر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ، وولده ومواليه ، وما الذي يقوله إلا سحر يرويه عن أهل بابل ، ويتعلمه منهم . فارتجَّ النادي فرحًا ، وتفرقوا معجبين بقوله ، متعجبين منه » .
ولهذا يصور له التعبير القرآني المعجز هذه اللمحات الحيَّة التي يثبتها في المخيلة أقوى مما تثبتها الريشة في اللوحة ، وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار ، فتدع صاحبها سخريةَ الساخرين أبد الدهر ، وتثبت صورته الزَّرِيَّة في صلب الوجود ، تتملاها الأجيال بعد الأجيال !
سابعًا- فإذا ما انتهى الله تعالى من عرض هذه اللمحات الحيَّة الشاخصة لهذا المخلوق المضحك ، عقَّب عليها بالوعيد المفزع ، والتهديد الساحق ، فقال سبحانه :﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾(المدثر: 26) ، وهو بدل من قوله تعالى :﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ .
و﴿ سَقَرَ ﴾ هي- على ما قيل- الدرك السادس من النار ، ومنِع لفظها من التنوين للتأنيث . وقيل : إنه اسم أعجمي . والأول هو الصواب ؛ لأن الأعجمي إذا كان على ثلاثة أحرف ، انصرف ، وإن كان متحرك الأوسط . وأيضًا فإنه اسم عربي مشتق ، يقال : سَقَرَته الشمس ، إذا أحرقته . والسَّاقُورُ : حديدة تُحْمَى ، ويُكْوَى بها الحمار .
وزاد هذا التهديد ، وذلك الوعيد تهويلاً تنكير﴿ سَقَرَ ﴾ . ثم تكرارها في جملة استفهامية ، يزيد من تهويل أمرها ؛ وهي قوله تعالى :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾(المدثر: 27) . يريد : أيُّ شيء أدراك ما سقر ؟ أي: لم تبلغ درايتك غاية أمرها وعظم هولها ؛ لأنها شيء أعظم وأهول من الإدراك !
وقيل : كل ما في القرآن من قوله تعالى :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ ، فقد أدراه ، وما فيه من قوله :﴿ وَمَا يُدْريكَ ﴾ ، فلم يدره ؛ كقوله تعالى :﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾(الأحزاب: 63) . والدليل على الأول قوله تعالى :﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . فقد أدراه ما سقر؟ ومثله قوله تعالى :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾(القارعة: 3) . ثم أدراه ما القارعة ، فقال سبحانه :﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾(القارعة:4) ، ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾(القارعة:5)
ولما كان قوله تعالى :﴿ مَا سَقَرُ ﴾ ؟ و﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ؟ سؤالاً عن الماهيَّة ، لم يجز فيه الجمع بين الاسم ، وضميره؛ كما يفعل ذلك كثير من علماء وكتَّاب اليوم . فلا يقال : ما هي سقر ؟ وما هي القارعة ؟ وإنما يقال كما قال الله تعالى :﴿ مَا سَقَرُ ﴾ ؟ و﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ؟
أو يقال : ما هي ؟ إذا تقدم ذكر لها في الكلام ، فيقال : سقرٌ ما هي ؟ والقارعة ما هي ؟ كما قال تعالى :﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴾(القارعة: 9- 10) . فتأمل ذلك في القرآن ، تجده على ما ذكرت ، إن شاء الله !
ثم عقَّب الله تعالى على هذا تجهيل سقر ، وتهويل أمرها بذكر شيء من صفتها أشد هولاً وأعظم ، جوابًا عن السؤال السابق :﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾(المدثر: 27) ، فقال سبحانه : ﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴾(المدثر: 28) . أي : لا تبقي شيئًا فيها إلا أهلكته ، وإذا هلك ، لم تذره هالكًا حتى يعاد . أو لا تبقي على شيء ، ولا تدعه من الهلاك ، حتى تهلكه . فكل شيء يطرح فيها هالك لا محالة ، وكأنها تبلعه بلعًا ، وتمحوه محوًا . وللدلالة على هذا المعنى جيء بـ﴿ لَا ﴾ مكررة بعد الواو العاطفة ؛ لأنه لو قيل : لا تبقي وتذر ، احتمل وقوع النفي على أحد الفعلين ، دون الآخر .
ثم هي بعد ذلك :﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾(المدثر: 29) . أي : مغيِّرة لهم ، أو محرقة ، بلغة قريش . يقال : لاحته الشمس ، ولوَّحته ، إذا غيرته . ويقال : لوحَّت الشيءَ بالنار : أحميته بها . وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- وجمهور العلماء : معناه : مغيِّرة للبشرات ، ومحرقة للجلود ، مسودة لها . فالبشر- على هذا- جمع بشرة .
وقال الحسن وابن كيسان :﴿ لَوَّاحَةٌ ﴾ بناء مبالغة من لاح يلوح ، إذا ظهر . فالمعنى : أنها تظهر للناس- وهم البشر- من مسيرة خمسمائة عام ؛ وذلك لعظمها وهولها وزفيرها . وقرىء :﴿ لَوَّاحَةً ﴾ ، بالنصب على الاختصاص للتهويل .
ثم إن :﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾(المدثر: 30) ملكًا هم خزنة جهنم ، المحيطون بها ، المدبرون لأمرها ، القائمون على تعذيب أهلها ، الذين إليهم جماع أمر زبانيتها ، باتفاق العلماء جميعهم .
وهكذا تتلاحق الآيات سريعة الجريان ، منوعة الفواصل والقوافي ، يتئد إيقاعها أحيانًا ، ويجري لاهثًا أحيانًا ، وبخاصة عند تصوير المشهدين الأخيرين : مشهد ذلك المكذب بالبعث ، وهو يفكر ، ويقدر ، ويعبس ، ويبسر .. ومشهد سقر التي لا تبقي ولا تذر ، ملوحة للبشر !
وواضح من ذلك كله أن الغرض من نزول هذه السورة الكريمة هو تكليف محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون نذيرًا للبشر من عذاب الله تعالى . والإنذار يحتاج إلى دليل تقام به الحجة . والدليل- هنا- هو المعجزة . والمعجزة هي في قوله تعالى :
﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾(المدثر: 30)
وروي أنه لما نزلت هذه الآية ، قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ! أسمع ابنَ أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر ، وأنتم الدهر ! أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أبو الأشدِّ بن أسيد بن كلدة الجُمَحِيِّ ، وكان شديد البطش : أنا أكفيكم سبعة عشر ، فاكفوني أنتم اثنين . فأنزل الله تعالى قوله :
﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴾(المدثر: 31)
وأصحاب النار هم التسعة عشر ملكًا . والجمهور على أن المراد بهم النقباء الذين إليهم جماع زبانيتها كما تقدموإلا فقد جاء :« يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » .
وكان ظاهر الكلام يقتضي أن يقال :﴿ وَمَا جَعَلْنَاهم ﴾ ؛ ولكنه وضع الاسم الظاهر موضع الضمير ، وكأن ذلك لما في هذا الاسم الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبرون لأمرها ، القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير . وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر : النار مطلقًا ، لا طبقة خاصة منها ، وعليه يكون المعنى : وما جعلناهم إلا ملائكة لا يطاقون ، فهم من ذلك الخلق المغيَّب الذي لا يعلم طبيعته ، وقوته إلا الله تعالى ، وقد وصفهم الله عز وجل بقوله :
﴿ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾(التحريم : 6)
فقرر سبحانه وتعالى : أنهم غلاظ شداد ، يطيعون ما يأمرهم به الله ، وأن بهم القدرة على فعل ما يأمرهم ؛ فهم- إذًا- مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله تعالى به . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقر ، فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمة كما يعلمها الله ، فلا مجال لقهرهم ، أو مغالبتهم من هؤلاء البشر ! وما كان قول الكافرين عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله ، وتدبيره للأمور .
وقيل : لم يجعلهم الله تعالى بشرًا ؛ بل جعلهم ﴿ مَلَائِكَةً ﴾ ؛ ليخالفوا جنس المعذبين من الجن والإنس ، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ، ولا يستروحون إليهم ؛ ولأنهم أقوم من البشر بحق الله عز وجل ، وبالغضب له تعالى ؛ ولأنهم أشد الخلق بأسًا وأقواهم بطشًا .
وعن عمرو بن دينار:« واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر » . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصفهم :« كأن أعينهم البرق ، وكأن أفواهم الصياصي يجرون أشعارهم ، لأحدهم مثل قوة الثقلين ، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل ، فيرمي بهم في النار ، ويرمي بالجبل عليهم » .
ثامنًا- ثم أخبر تعالى عن الحكمة التي جعل من أجلها عدتهم تسعة عشر ، فقال سبحانه :
﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر ﴾(31)
أي : ما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا فتنة للذين كفروا ، ووسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب ، وزيادة في إيمان الذين آمنوا ، وحفظًا من ارتياب أهل الكتاب والمؤمنين ، وداعيًا إلى تقوُّل أهل الكفر والنفاق :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ .
فهذه خمس حكم من جعل عددهم : تسعة عشر . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : كيف يكون هذا العدد المخصص بـ﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ فتنة للذين كفروا ، ووسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب ، وازدياد الذين آمنوا إيمانًا ، وحفظًا من ارتياب أهل الكتاب والمؤمنين ، وداعيًا إلى تقول أهل النفاق والكفر ما قالوا ؟!
1- فأما كون هذا العدد فتنة وابتلاء للذين كفروا فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن الذين كفروا يستهزئون ، ويقولون : لمَ لمْ يكونوا عشرين ، أو ثمانية عشر مثلاً ؟ وذلك لأن حال هذا العدة الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته ، ويعترض ويستهزىء ، ولا يذعن إذعان المؤمن ، وإن خفي عليه وجه الحكمة .
والوجه الثاني : أنهم يقولون : كيف يكون هذا العدد القليل وافيًا بتعذيب أكثر الخلق من الجن والإنس ، من أول خلق آدم إلى يوم القيامة ؟
2- وأما كونه وسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب فلأنه مطابق لما عندهم في التوراة والإنجيل . فإذا سمعوا به في القرآن ، استيقنوا أنه منزل من عند الله تعالى ، ومصدق لما بين يديهم . وهذا مما يشهد لقومهم على صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم !
3- وأما كونه وسيلة إلى ازدياد الذين آمنوا إيمانًا فإن المؤمنين كلما جاءهم أمر عن ربهم صدقوه ، وإن لم يعلموا حقيقته ، اكتفاء بأنه من عند الله تعالى ؛ لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقيًا مباشرًا . وكل حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنسًا بالله ، وتزيد قلوبهم إيمانًا ، فتستشعر بحمكة الله في هذا العدد ، وتقديره الدقيق في الخلق .
ولمَّا أثبت الله تعالى بذلك العدد الاستيقان لأهل الكتاب ، وزيادة الإيمان للمؤمنين ، جعله حفظًا لهم من الوقوع في الريبة ، فجمع لهم بذلك : إثبات اليقين ، ونفي الريب . وإنما فعل ذلك ؛ لأنه آكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس ، وثلج الصدر ؛ ولأن فيه تعريضًا بحال من عَداهم ؛ كأنه قال : ولتخالف حالهم حال الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر .
وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب ؛ حيث لم يقل : ولا يرتابوا ، للتنبيه على تباين النفيين حالاً ؛ فان انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ، ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان ، ولا يخفى ما بينهما من الفرق .. والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث ﴿ الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾ ، للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم فيه .
4- وأما كونه داعيًا إلى تقوُّل أهل النفاق والكفر :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ ؟ فإن هذه السورة الكريمة مكية ، ولم يكن بمكة يومئذ نفاق ؛ وإنما نجم النفاق بالمدينة ، فأخبر الله تعالى أن النفاق سيحدث في قلوب هؤلاء في المدينة بعد الهجرة . وعلى هذا تصير هذه الآية الكريمة معجزة ؛ لأنها إخبار عن غيب سيقع ، وقد وقع على وفق الخبر ، فكان معجزًا .
وتعقيبًا على قولهم هذا قال الزمخشري :« فإن قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان ، وانتفاء الارتياب ، وقول المنافقين والكافرين ما قالوا ، فهب أن الاستيقان ، وانتفاء الريب يصح أن يكونا غرضين ، فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا ؟ قلت : أفادت اللام معنى العلة والسبب ، ولا يجب في العلة أن تكون غرضًا ؛ ألا ترى إلى قولك : خرجت من البلد مخافة الشر ؟ فقد جعلت المخافة علة لخروجك ، وما هي بغرضك » . أراد اللام التي في قوله تعالى :﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ﴾ .
وقولهم :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ ؟ إنما سموه مثًُلآ- على ما قال الزمخشري- لأنه استعارة من المثل المضروب ؛ لأنه مما غرُب من الكلام وبدُع ، استغرابًا منهم لهذا العدد ، واستبعادًا له . وقيل : لمَّا استبعدوه ، حسبوه مثلاً مضروبًا ؛ كما حسبه كذلك بعض الباحثين المعاصرين ، ممن ألفوا في أمثال القرآن . والمعنى : أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيب ؟ وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة عشر ، لا عشرين سواء ؟ ومرادهم : إنكاره من أصله ، وأنه ليس من عند الله ، وأنه لو كان من عند الله ، لما جاء بهذا العدد الناقص .
وهكذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين في القلوب المختلفة . فبينما الذين أوتوا الكتاب يستيقنون ، والذين آمنوا يزيدون إيمانًا ، إذا بضعاف القلوب ، والذين كفروا في حيرة يتساءلون :﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ ؟ فهم لا يدركون حكمة هذا الأمر الغريب ، ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة في تقدير كل خلق ، ولا يطمئنون إلى صدق الخبر ، والخير الكامن في إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ؛ ولهذا أشاروا إليه بقولهم :﴿ هَذَا ﴾ استحقارًا للمشار إليه ، واستبعادًا له ؛ كقولهم :﴿ أهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (الفرقان:41) . وهذا هو حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يفتتن به كفرًا وجحودًا ، وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقًا .
وهنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء ما سمَّوْه :﴿ مَثلاً ﴾ من تقدير وتدبير ، فيقول تعالى :﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾(المدثر: 31) ، وهو إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية . أي : مثل ذلك المذكور من الإضلال والهداية يضل المنافقين والكافرين حسب مشيئته ، ويهدي المؤمنين حسب مشيئته . فكل أمر مرجعه في النهاية إلى مشيئة الله تعالى المطلقة التي ينتهي إليها كل شيء ، ومشيئته سبحانه تابعة لحكمته . وقد جاء هذا المعنى موضحًا في آيات أخر ؛ منها قوله تعالى :
﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾( إبراهيم: 27)
أي : يفعل ما توجبه الحكمة ؛ لأن مشيئة الله تعالى تابعة للحكمة من تثبيت الذين آمنوا ، وتأييدهم ، وعصمتهم عند ثباتهم وعزمهم ، ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية بينهم ، وبين شأنهم عند زللهم . ففعله تعالى كله حسن ؛ لأنه مبني على الحكمة والصواب . فأما المؤمنون فيسلمون بحكمة الله تعالى ، ويذعنون لمشيئته ، لاعتقادهم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة وحكمة ، فيزيدهم ذلك إيمانًا . وأما الكافرون فينكرون أفعاله سبحانه ، ويشكون فيها ؛ لأنهم لا يدركون حكمة الله تعالى فيها ، فيزيدهم ذلك كفرًا وضلالاً .. وفي وضع الفعلين :﴿ يُضِلُّ , ويَهْدي ﴾ موضع المصدر إشعار بالاستمرار التجددي . والمضارع يستعمل له كثيرًا ؛ ففي التعبير به- هنا- إشارة إلى أن الإضلال والهداية لا يزالان يتجددان ما تجدد الزمان .
وقال تعالى :﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾(المدثر:31) ؛ لأن علم ذلك من الغيب . والمراد : علم حقيقتها ، وصفاتها ، ووظائفها ، وأعدادها . والله تعالى يكشف عما يريد الكشف عنه من أمر جنوده ، وقوله سبحانه هو الفصل في شأنهم . وليس لقائل بعده أن يجادل ، أو يحاول معرفة ما لم يكشف الله تعالى عنه ؛ إذ فلا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ، ولو إجمالاً ، فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها ، من كم ، وكيف ، ونسبة !
وروى أن إبراهيم- عليه السلام- لما خرج من النار ، أحضره نمرود ، وقال له في بعض قوله : يا إبراهيم ! أين جنود ربك الذي تزعم ؟ فقال له عليه السلام : سيريك فعل أضعف جنوده . فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من بعوض ، فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم ، حتى كانت العظام تلوح بيضاء ، ودخلت منها بعوضة في رأس نمرود ، فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرها ، ثم هلك منها .
قال الألوسي في تفسيره روح المعاني :« هذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من جنود الله تعالى ، لا يعلم حقائقها وأحوالها إلا هو عز وجل . ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط بها نطاق الحصر ، أو يصل إلى مركزها طائر الفكر » .
وقوله تعالى :﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر ﴾(المدثر: 31) إما أن يعود على :﴿ جُنُود رَبِّكَ ﴾ . أو يعود على :﴿ سَقَرَ وَمَنْ عَليْهَا من جنود ربك ﴾ . أي : وما جنود ربك ، أو : وما سقر ، ومن عليها إلا ذكرى للبشر . وذكراها للبشر ؛ إنما جاء للتنبيه والتحذير ، لا ليكون موضوعًا للجدل ! والقلوب المؤمنة هي التي تتعظ بالذكرى ، أما القلوب الضالة فتتخذها جدلاً .
وقد يكون فيما قاله علماء الإعجاز العددي في تفسير هذه الآية الكريمة ما يكشف عن حقيقة هذا العدد .. والله تعالى أعلم ، له الحمد في السموات والأرض ، وهو بكل شيء عليم !