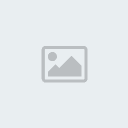وردت في القرآن في خمسة عشر موضعاً آيات تصف بالظلم من يقوم ببعض الأفعال والأقوال المنهي عنها شرعاً؛ من ذلك قوله تعالى: { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه } (البقرة:114)، ومنها قوله سبحانه: { ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله } (المائدة:140)، ومنها قوله تعالى: { ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته } (الأنعام:21)، ومنها قوله سبحانه: { ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها } (الكهف:57)، ومنها قوله سبحانه: { فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه } (الزمر:32) ونحو ذلك من الآيات .
وهذه
الآيات جاءت باستعمال صيغة المبالغة (أفعل) وهذه الصيغة تفيد أن الشخص
الموصوف بها لا أحد غيره يفوقه في تلك الصفة؛ فأنت إذا قلت: لا أحد أجود من
حاتم، فهذا يعني أن حاتماً أجود الناس، ولا يفوقه أحد آخر بهذا الجود؛
وعلى هذا الأسلوب تجري صيغة المبالغة في الأوصاف والأفعال .
والآيات
التي صدَّرنا بها الحديث أخبرت بأنواع متفرقة من الأفعال؛ فأخبرت أنه لا
أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ وأخبرت أنه لا أحد أظلم
ممن كتم شهادة عنده من الله؛ وأخبرت أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله
كذباً؛ وأخبرت أنه لا أحد أظلم ممن ذُكِّر بآيات ربه فأعرض عنها؛ وأخبرت
أنه لا أحد أظلم ممن كَذَب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وعلى هذا المنحى
أخبرت باقي الآيات التي جاءت على هذه الصيغة .
وقد
يبدو للقارئ أن ثمة تعارضاً بين هذه الآيات؛ وذلك أن كل آية من هذه الآيات
أخبرت عمن وصفته بأنه ( أظلم )، وهذا يقتضي أن المتصف بذلك الوصف أظلم من
غيره؛ فمثلاً الآية الأولى أخبرت أن من يمنع العبادة في مساجد الله هو أظلم
الناس، وهذا الإخبار قد يُفهم منه أنه لا أحد أظلم ممن يقوم بهذا الفعل،
وهذا بحسب ما تقتضيه صيغة المبالغة ( أفعل )؛ ومثل ذلك يقال في سائر الآيات
الواردة على هذه الشاكلة .
ولا
شك أن نفي أن يكون أحد أظلم ممن يمنع مساجد الله أن يُعْبَدَ الله فيها،
يعارضه الذي يفتري على الله الكذب، ويعارضه الذي يكتم شهادة عنده من الله،
ويعارضه الذي يُعرض عن ذكر الله، ويعارضه كل ما جاء في تلك الآيات التي
سيقت هذا المساق؛ إذ كل آية من هذه الآيات توهم التعارض مع غيرها من الآيات
التي تصف بعض الناس بأنه (أظلم) مَن يقوم بهذا الفعل المذكور فيها. هذا
وجه الإشكال الذي قد يبدو للبعض بين هذه الآيات .
وقد
أعرض أكثر المفسرين عن هذا الإشكال، ولم يولوه اهتماماً، وربما لم يجدوا
فيه إشكالاً يستحق الوقوف عنده، وتعرض إليه بعض المفسرين، ك أبي حيان و الآلوسي .
وكان ممن تعرض لهذا الإشكال، وتوقف عنده الزركشي في
كتابه "البرهان"، حيث نقل أجوبة المفسرين عليه، واختار قولاً مال إليه،
ونحن نلخص الأجوبة التي ذكرها في هذا الصدد على النحو التالي:
الجواب الأول: أن صيغة المبالغة (أظلم) الواردة في هذه الآيات وأمثالها مخصصة من عموم السياق الذي وردت فيه؛ فقوله تعالى: { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه } مخصص من عموم المانعين - المانعين لكل حق - فيكون أظلم المانعين من منع ذكر الله .
وكذلك الأمر في قوله تعالى: { ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا }،
معناه أن أظلم المفترين والكاذبين من يفتري على الله كذباً، وكأنه قيل:
لا أحد من المفترين (عموم المفترين) أظلم ممن افترى على الله كذباً. فصيغة
المبالغة (أظلم) في الآية مخصصة من مطلق المفترين .
وعلى هذا المنحى (التخصيص) من العموم تفهم سائر الآيات التي جاءت على هذه الشاكلة؛ وبالتالي لا يكون ثمة تعارض مع غيرها من الآيات .
الجواب الثاني:
أن صيغة المبالغة (أظلم) في كل آية من تلك الآيات خاصة بأول من قام بالفعل
الذي جاء ذمُّه في كل آية؛ إذ لمَّا لم يسبق أحد إلى مثل ذلك الفعل، حُكم
عليهم بأنهم (أظلم) ممن جاء بعدهم، سالكاً طريقتهم؛ فصيغة المبالغة (أظلم)
في آية المانعين مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، تعني بحسب هذا الجواب، أن
من سبق إلى هذا المنع من عموم المانعين، هو أظلمهم؛ وكذلك الأمر في صيغة
المبالغة (أظلم) في آية المفترين على الله كذباً، فإن أظلمهم من بدأ بهذا
الافتراء، وسبق غيره ممن جاء بعده، وبهذا لا يكون تعارض أيضاً بين الآيات؛
لأن صيغة المبالغة (أظلم) في كل آية من تلك الآيات تتحدث عن الأسبقية
الزمنية لذلك الفعل، كالمنع، والافتراء، والإعراض عن ذكر الله .
الجواب الثالث:
أن الآيات سيقت مساق الاستفهام، والاستفهام فيها ليس على سبيل الحقيقة،
وإنما على سبيل الاستعارة؛ لبيان عظم تلك الأفعال، وبالتالي لا يتعارض ذلك
مع كون غيره أظلم منه إن فُرض ذلك، وكثيراً ما يستعمل هذا في كلام العرب،
بقصد تهويل الأمر وتعظيمه، فيقال مثلاً: أي شيء أعظم من الزنى؛ وأي شيء
أعظم من شرب المسكر. فقائل ذلك يقصد بيان عظم الإتيان بتلك الأفعال، ولا
يقصد أن تلك الأفعال هي الأعظم، وأنه لا يوجد أعظم جُرماً منها، ولو قيل
للمتكلم بذلك: أنت قلت: إن الزنى وشرب المسكر أعظم الأشياء لأبى ذلك .
وهذا الجواب الثالث هو الذي ارتضاه الزركشي ، وقال بعد أن ساقه: فليُفهم هذا المعنى، فإن الكلام ينتظم معه، والمعنى عليه .
ثم إن أبا حيان الأندلسي
في تفسيره "المحيط" قد أجاب على هذا الإشكال جواباً غير الذي تقدم، حاصله:
أن كل آية من هذه الآيات أثبتت صفة (الظلم) بصيغة المبالغة لمن وصفتهم،
فيكون الجميع مشتركين في هذا الوصف (أظلم)، ولا يعني ذلك أن يكون أحدهم أقل
أو أكثر ظلماً من الآخر؛ غاية ما تعنيه الآيات أن هؤلاء المذكورين هم
(أظلم) من غيرهم .
قال الألوسي : " وقصارى ما يفهم من الآيات (أظلمية) أولئك المذكورين فيها ممن عداهم؛ كما أنك إذا قلت: لا أحد أفقه من زيد و عمرو و خالد ، لا يدل على أكثر من نفي أن يكون أحد أفقه منهم "، ولا يدل ذلك على أن أحدهم أفقه من الآخر .
على
أن مما ينفي وجود تعارض بين هذه الآيات وما شاكلها، أنها واردة في الكفار،
فهم متساوون في (الظلم)، وإن اختلفت طرق ظلمهم، فكلها مؤدية إلى الكفر،
فهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة للكفار، وإنما تمكن الزيادة في
الظلم بالنسبة لهم، وللعصاة من المؤمنين، من جهة اشتراكهم فيه، فنقول:
الكافر أظلم من المؤمن، ونقول: لا أحد أظلم من الكافر، ومعناه: أن ظلم
الكافر يزيد على ظلم غيره من عصاة المؤمنين .
وبما تقدم يتبين أن الآيات موضوع الحديث، وإن وردت كلها بصيغة المبالغة (أظلم): { ومن أظلم }، و{ فمن أظلم }،
إلا أن هذه الصيغة - كما يقول أهل اللغة - ليست على بابها، وإنما المراد
منها بيان عِظَم تلك الأفعال. وبهذا ينتفي أن يكون تعارض بين تلك الآيات