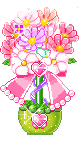تكلمنا في المقالين السابقين وفي الظلال العقديّة لقوله سبحانه: {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم} (المائدة:41)، أن الهداية محض فضلٍ من الله وحدَه، فيهبها لمن يشاء، ويمنعها ممّن يشاء، وأن المنع مرتبطٌ بعدم استحقاق صاحبِها لنعمة الهداية، وأن من يضلّ من البشرِ فليس بكفأ لهذه الهداية، وأن الضلال لا يقتضي بالضرورة عدم بلوغ الحجّة، وأن عامل الهوى مؤثّر في الضلال.
وهنا نقول: إن للهوى صوراً كثيرة ومسبّباتٍ كانت العامل المؤثّر في صرف الهداية عن أصحابِها، وتفضيلهم للدنيا على الآخرة، وتعلقهم بالفانية دون الباقية، ويمكن تلخصيها فيما يلي:
شهوة المال
المال يأتي في مقدّم الأمورِ التي بسببها يضلّ الناس عن الهدى؛ لأن شهوته مستقرّةٌ في النفوس، ولها تأثيرٌ لا يُنكر وقدرةٌ طاغيةٌ على التأثير في صدق النفوسِ وإخلاصها، ويشير محكم الكتاب إلى كونها من الشهوات التي أودعها الله فينا بقولِه سبحانَه: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة} (آل عمران:14)، وجاء تجسيده في النصِّ النبوي في مثلٍ عجيب، يقول فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو كان لابن آدم واديانِ من مالٍ لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَن تاب) متفق عليه.
والحالُ أن لهذه الشهوة بريقاً يأخذ باللبِّ، حتى يكون طلبُ الحقّ معها مجاهدة عظيمة إلا من عصمَه الله، وهو ما لم يحدث مع الكثير من أهل الكتاب الذين استيقنوا بالبيّنات الواضحات من نبوّة محمد -صلى الله عليه وسلم- لوجود البشارةِ به في كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم، قال تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون} (آل عمران:187). وقد جاء النهي عن المقايضة بين الحق والضلال لأجل حفنةٍ من الدراهم: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون} (البقرة:41).
وحيث كان أهل الكتاب على معرفةٍ تامّة بصفات المبلّغ عن الحق -صلى الله عليه وسلم- لما عرفوه من صفاته المذكورةِ في كتبهم، فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم -على حد الوصف القرآني-، وكانوا يبشّرون به، ويستفتحون على أعدائهم به، ثم هم يكفرون ويصدّون مع وثوقهم بصدقه، ولذلك صدر الوعيد الشديد في حقّهم: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} (البقرة:174)، والعجب أن القرآن وصف إيثارهم للمال على الحق بأنه شراءٌ للضلال: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار} (البقرة:175).
الحسد
إذا كان الحسد في حقيقته هو كراهية النعمة التي تكون عند لآخرين، فأعظم النعم مطلقاً: أن يصطفي الله من خلقِه من يشاءُ ليكون رسولاً مبلّغاً عن ربّه الرسالة، ومن الطبيعي أن يكون حواريو هؤلاء الأنبياء والرسل لهم مكانةٌ عند الله وعند الناس، وهذا هو المفتاح الأهم الذي من خلالِه نستطيع أن نفهم كيف وقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى موقفاً عدائياً رافضاً للحق الذي جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الكراهية المطلقة لحالة التفضيل والاصطفاء له ولأمته: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} (البقرة:105)، وتنامى الشعور بالكراهيّة ليصل إلى حد تمنّي حدوث الردّة في صفوف المسلمين، قال سبحانه: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} (البقرة:109)، وقد ذمّ الله اليهود على اتصافهم بصفة الحسد وكراهيتهم أن يؤتي الله من فضله أحداً غيرهم، وفي وصفهم بهذا يقول جل وعلا: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} (النساء:54). يقول السدّي تعليقاً على كفر أهل الكتاب: "وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا {فباءوا بغضب على غضب} (البقرة:90)".
الكبر والغطرسة
لا شك أن الكبر والخيلاء هما أعظم مانع من قبول الحق، وإن كان أوضحَ من الشمس في رابعة النهار، إنه حاجزٌ نفسي، يحمل صاحبَه على الاستعلاء عن الحق، وكأنّ في قبولِه منقصةٌ أو مهانة، وهذه الصفة الذميمة الإبليسيّة التي دعت إبليس إلى الإباء والإصرار على غواية بني آدم، هي كذلك التي منعت الكثير من البشر عن قبول دعوة الحق. والعلاقة بين الكبر والضلال جلاّها لنا القرآن، قال سبحانه وتعالى: {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا} (الأعراف:46)، وفي آية أخرى: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} (غافر:35)، فمهما توالت الآيات الكونيّة أو الشرعيّة على المستكبرين، فإنه لا يكون لها أثرٍ في سلوكهم، ولا تحرّك فيهم نزعة الإذعان للحق والقبول للهدى.
ولننظر إلى الكبرِ وهو ينضحُ من قولِ كفّار قريش: {وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم} (الزخرف:31)، أو مطالبتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخصّهم بالمجالسة دون الفقراء من المسلمين، جاء في تفاسير القرآن موقف الوليد بن المغيرة حين استكثر الرسالة على محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى قال: {أأنزل عليه الذكر من بيننا} (ص: ، أي: كيف يخصه الله من بيننا، وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ وهذه الأَنَفة هي التي حجبت الهداية عن كفّار قريش، بل كانت المانع للكثير من أهل الضلال في القديم والحديث من قبول الهدى والإذعان للحق، ومن تتبّع التاريخ علم أثر الكبر وخطورتَه.
، أي: كيف يخصه الله من بيننا، وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ وهذه الأَنَفة هي التي حجبت الهداية عن كفّار قريش، بل كانت المانع للكثير من أهل الضلال في القديم والحديث من قبول الهدى والإذعان للحق، ومن تتبّع التاريخ علم أثر الكبر وخطورتَه.
والعَجَبُ يتملّك المرء حين يرى جلساتِ الحوارِ والمناظرات التي تقوم بين المسلمين وغيرِهم من القساوسة وأحبار اليهود والملاحدة وغيرِهم، ويرى البراهين الساطعات وانقطاع حجّة الخصوم وقيام الحجّة كاملةً، ثم يجدُ مدافعة الحق بأوهى الأسباب التي لا تصمدُ حجّتها، ولا يقومُ برهانها، ولا يجد تفسير ذلك إلا في قول الحق: {فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون} (الأنعام:33).
الخوف على المنصب والرئاسة
كما حدث مع هرقل عظيم الروم؛ فقد أخبرتنا كتب السيرة النبويّة أن هرقل عظيم الروم طلب محاروة أبي سفيان، وبعد أن انتهت المحاورة، وأدراكَ هرقل أدراكاً تامًّا نبوة محمد –صلى الله عليه وسلم-، وعلمَ علم اليقين أنه رسول الله حقاً، وأن ما جاء به هو الحق، وكادَ أن يُعلن إسلامَه، فلما عرض على خاصّتِه عزمَه على الامتثال والإذعان، رأى منهم الإنكار والصدود، دعاهم فقال لهم: "إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت"، والحديث بتمامِه في "الصحيحين"، فلم يمنعه من قبول الحق والإذعان له إلا الخوف على مكانته، ومنصبه.
وكثيراً ما نسمعُ عن أحوال بعض أهل الكتاب في زماننا ممّن يشغلون مناصب عليا في الأديرة والكنائس، وتُغدق عليهم الأموال، وينالون من المكاسب السياسية والمكانة الاجتماعيّة البارزة، فإذا أسلموا فقدوا ذلك كلّه، وقيامُ مثلِ هذه الحالة من الاضطهاد تمنعُ غيرهم من التضحية بهذه المكاسب الدنيوية لأجل الحق.
حب الدنيا
من ضعف أهل الضلال وقلّةِ عقولِهم، إجراءَهم المقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، ليصلوا بعد هذه المقارنة إلى تفضيل الدنيا على الآخرة؛ نظراً لكونِها بين أيديهم، فتغريهم الدنيا بما فيها من المفاتِن والشهوات، ويرفضون الحق حيث يمنعُ عنهم الانحلال والتفلّت، ولنا في قصّة الشاعر الجاهلي الشهير بالأعشى خير شاهد على ما نقول، حيث سمع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعجب به وأثنى على سيرتِه، وكتب فيها قصيدةً رائعةً يمدحُه فيها، ومن أبياتها:
أجدك لم تسمع وصاة محمد ... نبي الإله حين أوصى وأشهدا
فقد أقرّ فيها بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم إقراراً ليس ينقصُه سوى النطقُ بالشهادتين، وبالفعل كان هذا الذي يريدُ أن يفعلَه، فلما كان في طريقه إلى المدينة للقاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- والإيمانِ به، اعترضه بعض المشركين من قريش، فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: يا أبا بصير! فإنه يحرّم الزنا، فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمرٌ مالي فيه من أِرَب -أي: رغبة-، فقال: يا أبا بصير! فإنه يحرّم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في النفس لعُلالاتٍ منها أي: النفسُ تتوقُ لشرب الخمر، فلا يستطيع تركها- ولكني منصرف فأرتوي منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك، ولم يَعُد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
التعصّب للآباء
عندما يتطبّعُ الإنسانُ على طريقةٍ أو مسلكٍ مدّة طويلة، فإنه يصعب عليه إحداث تغيير في حياتِه أو كسرِ الروتين الذي عاش فيه، فكيف إذا كان هذا التغيير جذريّاً يمسُّ المعتقد -وهو أغلى ما يملك الإنسان ويعقد عليه قلبَه-؟ لا شك بأنها عمليّةٌ صعبة لا يقدرُ عليها كلّ الناس، إلا من وفّقه الله، وأحيا قلبَه وشرح صدرَه للإسلام فهو على نورٍ من ربّه.
والمشكلةُ تكمن في أن هذا النمط السائد ربّما تربّت عليه أجيالٌ كاملة، فيصعبُ عليهم إحداث هذا التغيير، ولو كانت دلائل بطلان ما كانوا عليه، وحقيقة ما ينبغي أن يصيروا إليه، هنا يحدث التمنّع والتحفّظ الذي يتحوّل إلى المعادات السافرة للحق والتعصّب للموروث الديني وإن كان خاطئاً.
ولقد تاهتْ أممٌ كثيرة من قبل في أودية الجهالة والضلال بسبب ما كانوا عليه من الوقوع في أسر التقليد، الذي يمنعُ صاحبَه من تحكيم العقل، فآل أمرُهم إلى الجمود على الماضي الموروث، والبقاء عليه، والقرآن قد وصف حال كثير من هؤلاء في قوله تعالى: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} (الزخرف:23)، أو قول قوم شعيب عليه السلام: {قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد} (هود:87). قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على الآيات السابقة: "وهذه الأمور وأمثالها ليست حججاً تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم؛ فلذلك لم يتبعوهم..بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحبون علوَّ كلمتِه، وليس عندهم حسدٌ له، وكانوا يعلمون صدقَه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعتِه فراق دين آبائِهم وذم قريشٍ لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به؛ بل لهوى النفس".
هذه جملةٌ من الأسباب التي توضّح لنا حقيقة الأفعال الإلهيّة في الحكمِ على بعض الناس بالضلال، ولماذا يحول الله سبحانه وتعالى بين المرءِ وقلبِه؛ فلا يتمكن مِن فهم الحقِّ ولا ينشرح صدره له، وبالله التوفيق، وإليه يرجع الأمر كله.
وهنا نقول: إن للهوى صوراً كثيرة ومسبّباتٍ كانت العامل المؤثّر في صرف الهداية عن أصحابِها، وتفضيلهم للدنيا على الآخرة، وتعلقهم بالفانية دون الباقية، ويمكن تلخصيها فيما يلي:
شهوة المال
المال يأتي في مقدّم الأمورِ التي بسببها يضلّ الناس عن الهدى؛ لأن شهوته مستقرّةٌ في النفوس، ولها تأثيرٌ لا يُنكر وقدرةٌ طاغيةٌ على التأثير في صدق النفوسِ وإخلاصها، ويشير محكم الكتاب إلى كونها من الشهوات التي أودعها الله فينا بقولِه سبحانَه: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة} (آل عمران:14)، وجاء تجسيده في النصِّ النبوي في مثلٍ عجيب، يقول فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو كان لابن آدم واديانِ من مالٍ لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَن تاب) متفق عليه.
والحالُ أن لهذه الشهوة بريقاً يأخذ باللبِّ، حتى يكون طلبُ الحقّ معها مجاهدة عظيمة إلا من عصمَه الله، وهو ما لم يحدث مع الكثير من أهل الكتاب الذين استيقنوا بالبيّنات الواضحات من نبوّة محمد -صلى الله عليه وسلم- لوجود البشارةِ به في كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم، قال تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون} (آل عمران:187). وقد جاء النهي عن المقايضة بين الحق والضلال لأجل حفنةٍ من الدراهم: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون} (البقرة:41).
وحيث كان أهل الكتاب على معرفةٍ تامّة بصفات المبلّغ عن الحق -صلى الله عليه وسلم- لما عرفوه من صفاته المذكورةِ في كتبهم، فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم -على حد الوصف القرآني-، وكانوا يبشّرون به، ويستفتحون على أعدائهم به، ثم هم يكفرون ويصدّون مع وثوقهم بصدقه، ولذلك صدر الوعيد الشديد في حقّهم: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} (البقرة:174)، والعجب أن القرآن وصف إيثارهم للمال على الحق بأنه شراءٌ للضلال: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار} (البقرة:175).
الحسد
إذا كان الحسد في حقيقته هو كراهية النعمة التي تكون عند لآخرين، فأعظم النعم مطلقاً: أن يصطفي الله من خلقِه من يشاءُ ليكون رسولاً مبلّغاً عن ربّه الرسالة، ومن الطبيعي أن يكون حواريو هؤلاء الأنبياء والرسل لهم مكانةٌ عند الله وعند الناس، وهذا هو المفتاح الأهم الذي من خلالِه نستطيع أن نفهم كيف وقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى موقفاً عدائياً رافضاً للحق الذي جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الكراهية المطلقة لحالة التفضيل والاصطفاء له ولأمته: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} (البقرة:105)، وتنامى الشعور بالكراهيّة ليصل إلى حد تمنّي حدوث الردّة في صفوف المسلمين، قال سبحانه: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} (البقرة:109)، وقد ذمّ الله اليهود على اتصافهم بصفة الحسد وكراهيتهم أن يؤتي الله من فضله أحداً غيرهم، وفي وصفهم بهذا يقول جل وعلا: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} (النساء:54). يقول السدّي تعليقاً على كفر أهل الكتاب: "وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا {فباءوا بغضب على غضب} (البقرة:90)".
الكبر والغطرسة
لا شك أن الكبر والخيلاء هما أعظم مانع من قبول الحق، وإن كان أوضحَ من الشمس في رابعة النهار، إنه حاجزٌ نفسي، يحمل صاحبَه على الاستعلاء عن الحق، وكأنّ في قبولِه منقصةٌ أو مهانة، وهذه الصفة الذميمة الإبليسيّة التي دعت إبليس إلى الإباء والإصرار على غواية بني آدم، هي كذلك التي منعت الكثير من البشر عن قبول دعوة الحق. والعلاقة بين الكبر والضلال جلاّها لنا القرآن، قال سبحانه وتعالى: {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا} (الأعراف:46)، وفي آية أخرى: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} (غافر:35)، فمهما توالت الآيات الكونيّة أو الشرعيّة على المستكبرين، فإنه لا يكون لها أثرٍ في سلوكهم، ولا تحرّك فيهم نزعة الإذعان للحق والقبول للهدى.
ولننظر إلى الكبرِ وهو ينضحُ من قولِ كفّار قريش: {وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم} (الزخرف:31)، أو مطالبتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخصّهم بالمجالسة دون الفقراء من المسلمين، جاء في تفاسير القرآن موقف الوليد بن المغيرة حين استكثر الرسالة على محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى قال: {أأنزل عليه الذكر من بيننا} (ص:
 ، أي: كيف يخصه الله من بيننا، وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ وهذه الأَنَفة هي التي حجبت الهداية عن كفّار قريش، بل كانت المانع للكثير من أهل الضلال في القديم والحديث من قبول الهدى والإذعان للحق، ومن تتبّع التاريخ علم أثر الكبر وخطورتَه.
، أي: كيف يخصه الله من بيننا، وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ وهذه الأَنَفة هي التي حجبت الهداية عن كفّار قريش، بل كانت المانع للكثير من أهل الضلال في القديم والحديث من قبول الهدى والإذعان للحق، ومن تتبّع التاريخ علم أثر الكبر وخطورتَه.والعَجَبُ يتملّك المرء حين يرى جلساتِ الحوارِ والمناظرات التي تقوم بين المسلمين وغيرِهم من القساوسة وأحبار اليهود والملاحدة وغيرِهم، ويرى البراهين الساطعات وانقطاع حجّة الخصوم وقيام الحجّة كاملةً، ثم يجدُ مدافعة الحق بأوهى الأسباب التي لا تصمدُ حجّتها، ولا يقومُ برهانها، ولا يجد تفسير ذلك إلا في قول الحق: {فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون} (الأنعام:33).
الخوف على المنصب والرئاسة
كما حدث مع هرقل عظيم الروم؛ فقد أخبرتنا كتب السيرة النبويّة أن هرقل عظيم الروم طلب محاروة أبي سفيان، وبعد أن انتهت المحاورة، وأدراكَ هرقل أدراكاً تامًّا نبوة محمد –صلى الله عليه وسلم-، وعلمَ علم اليقين أنه رسول الله حقاً، وأن ما جاء به هو الحق، وكادَ أن يُعلن إسلامَه، فلما عرض على خاصّتِه عزمَه على الامتثال والإذعان، رأى منهم الإنكار والصدود، دعاهم فقال لهم: "إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت"، والحديث بتمامِه في "الصحيحين"، فلم يمنعه من قبول الحق والإذعان له إلا الخوف على مكانته، ومنصبه.
وكثيراً ما نسمعُ عن أحوال بعض أهل الكتاب في زماننا ممّن يشغلون مناصب عليا في الأديرة والكنائس، وتُغدق عليهم الأموال، وينالون من المكاسب السياسية والمكانة الاجتماعيّة البارزة، فإذا أسلموا فقدوا ذلك كلّه، وقيامُ مثلِ هذه الحالة من الاضطهاد تمنعُ غيرهم من التضحية بهذه المكاسب الدنيوية لأجل الحق.
حب الدنيا
من ضعف أهل الضلال وقلّةِ عقولِهم، إجراءَهم المقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، ليصلوا بعد هذه المقارنة إلى تفضيل الدنيا على الآخرة؛ نظراً لكونِها بين أيديهم، فتغريهم الدنيا بما فيها من المفاتِن والشهوات، ويرفضون الحق حيث يمنعُ عنهم الانحلال والتفلّت، ولنا في قصّة الشاعر الجاهلي الشهير بالأعشى خير شاهد على ما نقول، حيث سمع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعجب به وأثنى على سيرتِه، وكتب فيها قصيدةً رائعةً يمدحُه فيها، ومن أبياتها:
أجدك لم تسمع وصاة محمد ... نبي الإله حين أوصى وأشهدا
فقد أقرّ فيها بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم إقراراً ليس ينقصُه سوى النطقُ بالشهادتين، وبالفعل كان هذا الذي يريدُ أن يفعلَه، فلما كان في طريقه إلى المدينة للقاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- والإيمانِ به، اعترضه بعض المشركين من قريش، فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: يا أبا بصير! فإنه يحرّم الزنا، فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمرٌ مالي فيه من أِرَب -أي: رغبة-، فقال: يا أبا بصير! فإنه يحرّم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في النفس لعُلالاتٍ منها أي: النفسُ تتوقُ لشرب الخمر، فلا يستطيع تركها- ولكني منصرف فأرتوي منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك، ولم يَعُد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
التعصّب للآباء
عندما يتطبّعُ الإنسانُ على طريقةٍ أو مسلكٍ مدّة طويلة، فإنه يصعب عليه إحداث تغيير في حياتِه أو كسرِ الروتين الذي عاش فيه، فكيف إذا كان هذا التغيير جذريّاً يمسُّ المعتقد -وهو أغلى ما يملك الإنسان ويعقد عليه قلبَه-؟ لا شك بأنها عمليّةٌ صعبة لا يقدرُ عليها كلّ الناس، إلا من وفّقه الله، وأحيا قلبَه وشرح صدرَه للإسلام فهو على نورٍ من ربّه.
والمشكلةُ تكمن في أن هذا النمط السائد ربّما تربّت عليه أجيالٌ كاملة، فيصعبُ عليهم إحداث هذا التغيير، ولو كانت دلائل بطلان ما كانوا عليه، وحقيقة ما ينبغي أن يصيروا إليه، هنا يحدث التمنّع والتحفّظ الذي يتحوّل إلى المعادات السافرة للحق والتعصّب للموروث الديني وإن كان خاطئاً.
ولقد تاهتْ أممٌ كثيرة من قبل في أودية الجهالة والضلال بسبب ما كانوا عليه من الوقوع في أسر التقليد، الذي يمنعُ صاحبَه من تحكيم العقل، فآل أمرُهم إلى الجمود على الماضي الموروث، والبقاء عليه، والقرآن قد وصف حال كثير من هؤلاء في قوله تعالى: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} (الزخرف:23)، أو قول قوم شعيب عليه السلام: {قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد} (هود:87). قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على الآيات السابقة: "وهذه الأمور وأمثالها ليست حججاً تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم؛ فلذلك لم يتبعوهم..بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحبون علوَّ كلمتِه، وليس عندهم حسدٌ له، وكانوا يعلمون صدقَه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعتِه فراق دين آبائِهم وذم قريشٍ لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به؛ بل لهوى النفس".
هذه جملةٌ من الأسباب التي توضّح لنا حقيقة الأفعال الإلهيّة في الحكمِ على بعض الناس بالضلال، ولماذا يحول الله سبحانه وتعالى بين المرءِ وقلبِه؛ فلا يتمكن مِن فهم الحقِّ ولا ينشرح صدره له، وبالله التوفيق، وإليه يرجع الأمر كله.