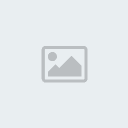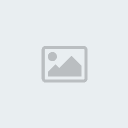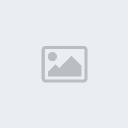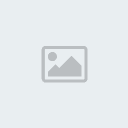من أسرار الإعجاز البياني في سور الكافرون
قال الله تبارك وتعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾(الكافرون : 1- 6)
أولاً- هذه السورة مكية ، وآياتها ست آيات ، وتسمى : سورة البراءة ، وسورة الإخلاص . وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه :« إنها تعدِل ثُلثَ القرآن » . وروى ابن الأنباري عن أنس- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، تعدل رُبُعَ القرآن » . وخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في صلاة الفجر في سفر ، فقرأ :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ﴾ ، ثم قال صلى الله عليه وسلم :« قرأت عليكم ثُلثَ القرآن ، ورُبُعَه » . وخرَّج ابنُ الأنباري عن نوفل الأشجعي ، قال : جاء رجُل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أوصني ، قال :« اقرأ عند منامك : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ؛ فإنَّها براءةٌ من الشِّركِ » .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما :« ليس في القرآن أشدُّ غيظًا لإبليس - لعنه الله - من هذه السورة ؛ لأنها توحيد ، وبراءة من الشرك » . وقال الأصمعي :« كان يقال لـ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ﴾ المقشقشتان » . أي : إنهما تبرئان من النفاق ؛ كما يقشقش القطِرانُ الجرب ، فيبرئه .
وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« أتحب يا جُبيرُ ، إذا خرجت سفرًا ، أن تكون من أَمْثَلِ أصحابك هيْئةً ، وأكْثرِهم زادًا ؟ » قلت : نعم . قال :« فاقرأ هذه السُّوَر الخمسَ من أول : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، إلى : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، وافتتح قرءاتك ببسم الله الرحمن الرحيم » . قال : فوالله ، لقد كنت غير كثير المال . إذا سافرت ، أكون أبذَّهُم هيئة ، وأقلهم مالاً ، فمذ قرأتهن ، صرت من أحسنهم هيئة ، وأكثرهم زادًا ، حتى أرجع من سفري ذلك .
وروى ابن اسحق في سبب نزول هذه السورة الكريمة ، فقال :« اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يطوف بالكعبة- فيما بلغني- الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، والوليد بن المغيرة ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل السهمي ، وكانوا ذوي أسنان في قومهم ، فقالوا : يا محمد ! هَلُمَّ ، فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن ، وأنت في الأمر ؛ فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان ما نعبد خيرًا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه . فأنزل الله تعالى فيهم :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.. ﴾ إلى آخر السورة » .
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن العرب في جاهليتهم الأولى لم يكونوا يجحدون الله تعالى ؛ ولكنهم كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف سبحانه وتعالى بها نفسه ، والتي عرفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ، شأنهم في ذلك شأن الأمم الأخرى ؛ ولهذا كانوا يشركون به آلهتهم في العبادة ، وكانوا لا يقدرونه حق قدره ، ولا يعبدونه حق عبادته ؛ كغيرهم ممَّن سبقهم من عبَّاد الأصنام والأوثان . لقد كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى ، وأنه الخالق للسموات والأرض ، والخالق لذواتهم ؛ ولكنهم مع إيمانهم به ، كان الشرك يفسد عليهم تصوُّرَهم ، كما كان يفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم . وكانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام ، وأنهم أهدى من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة العربية ؛ لأن اليهود يقولون : عزيرٌ ابنُ الله . والنصارى يقولون : عيسى ابنُ الله ، بينما هم يعبدون الملائكة والجن ، على اعتبار قرابتهم من الله - على حدِّ زعمهم- فكانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقًا ؛ لأن نسبة الملائكة والجن إلى الله تعالى أقرب من نسبة عزير وعيسى . وهذا كله شرك ، وليس في الشرك خيار .
ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول :﴿ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾(الأنعام: 161) ، قالوا : نحن على دين إبراهيم ، فما حاجتنا- إذًا- إلى ترك ما نحن عليه ، واتباع محمد ؟! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم خطةً وسطًا بينهم وبينه ، فعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه ، وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم ، وله فيهم وعليهم ما يشترط !
ولعل اختلاط تصوراتهم ، واعترافهم بوجود الله مع عبادة آلهة أخرى معه ، كان يشعرهم أن المسافة بينهم ، وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة يمكن التفاهم عليها ؛ وذلك بقسمة البلد بلدين ، والالتقاء في منتصف الطريق ، مع بعض الترضيات الشخصية ؛ كما يفعلون في التجارة تمامًا . وفرق بين الاعتقاد ، والتجارة كبير ! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها ؛ لأن الصغير منها كالكبير ؛ بل ليس في العقيدة صغير وكبير ، إنها حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء ، لا يطيع فيها صاحبها أحدًا ، ولا يتخلى عن شيء منها أبدًا . وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام ، والجاهلية في منتصف الطريق ، ولا أن يلتقيا في أي طريق ؛ وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان- جاهلية الأمس واليوم والغد كلها سواء- إن الهُوَّة بينها ، وبين الإسلام لا تُعْبَرُ ، ولا تقام عليها قنطرة ، ولا تقبل قسمة ، ولا صلة ، ولا مساومة ؛ وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق بين الحق والباطل !
وقد وردت روايات شتى فيما كان يساوم فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدهنون له ؛ ليدهن لهم ويلين ، كما يودون ، ويترك سبَّ آلهتهم وتسفيه عبادتهم ، أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ؛ ليتابعوه في دينه ، وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب ، على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسمًا في موقفه من دينه ، لا يساوم فيه ، ولا يدهن ، ولا يلين ، حتى وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة ، وهو محاصر بدعوته ، وأصحابه القلائل يتخطَّفون ويعذَّبون ويؤذَوْن في الله أشدَّ الإيذاء ، وهم صابرون ، ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الطغاة المتجبرين ، تأليفًا لقلوبهم ، أو دفعًا لأذاهم ، ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب ، أو من بعيد ، وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانبًا ، وأحسنهم معاملة ، وأبرُّهم بعشيرة ، وأحرصهم على اليسر والتيسير . فأما الدين فهو الدين ، وهو فيه عند توجيه ربه ، حيث يقول له سبحانه :
﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴾(القلم:
﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾(يونس: 41)
﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾(الكافرون: 1- 6)
ثانيًا- وافتتاح السورة الكريمة بهذا الأمر الإلهي الحاسم :﴿ قُلْ ﴾ لإِظهار العناية بما بعد القول ، وهو افتتاح مُوحٍ بأن أمر هذه العقيدة هو أمر الله تعالى وحده ، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه شيء ؛ إنما هو الله الآمر الذي لا مردَّ لأمره ، والحاكم الذي لا رادَّ لحكمه ؛ ففي قوله تعالى :﴿ قُلْ ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله .
والخطاب بقوله :﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ هو خطاب لجنس الكفار ، فيعم كل كافر على وجه الأرض إلى يوم القيامة ، ويدخل فيه كفار مكة دخولاً أوليًّا ؛ إذ كانوا هم المقصودون أولاً بهذا الخطاب . وخطابه صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الوصف في ناديهم ومكان بسطة أيديهم ، مع ما فيه من الإرذال بهم والتحقير لهم ، دليل على أنه محروس من عند الله تعالى ، لا يبالي بهم . وإنما ابتدىء الخطاب بهذا النداء ﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ الذي يجمع بين نداء النفس ونداء القلب ونداء الروح ؛ لأن النداء يُستَدعَى به إقبالُ المُنادَى على ما سيُلقَى عليه ، بنفسه وقلبه وروحه .
و﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ جمع : كافر، على وزن : فاعل ، من قولهم : كفر يكفر . والكفر في اللغة هو السَّتْرُ والتغطية . ووُصِفَ الليل بالكافر ؛ لأنه يغطي كل شيء . ووُصِفَ الزارع بالكافر ؛ لأنه يغطي البذر في الأرض . وكُفْرُ النعمة وكُفْرانُها : تغطيتها بترك أداء شكرها . قال أحدهم :« لو جاز أن تعبد الشمس في دين الله ، لكنت أعبدها ؛ فإنها شمس ما ألقت يدًا في كافر ، ولا وضعت يدًا إلا في شاكر » . فالكفر يضادُّه الشكر ، وهو مصدر سماعي لكَفَر يكفُر . وأصله : جَحْدُ نعمةَ المُنْعِم ، واشتقاقه من مادة الكَفْر ، بفتح الكاف ، وهو السَّتْرُ والتَّغطِيةُ ؛ لأن جاحد النعمة قد أخفى الاعتراف بها ؛ كما أن شاكرها أعلنها ؛ ولذلك صيغ له مصدر على وزان الشُّكر ، وقالوا أيضًا : كُفْرانٌ ، على وزن شُكْران . ثم أطلق الكفر في القرآن الكريم على جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة ، بناء على أنه أشد صور كفر النعمة ؛ وذلك أعظم الكفر .
واستعمال الكفران في جحود النعمة أكثر من استعمال الكفر . ومنه قول الله تعالى :﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾(الأنبياء: 94) . واستعمال الكفر في الدين أكثر من استعمال الكفران . ومنه قول الله تعالى :﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾(النساء: 136) ، وقوله سبحانه وتعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾(المائدة: 44) . وأما الكُفُور فيستعمل فيهما جميعًا ؛ كما في قول الله تعالى :﴿ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَلاَّ كُفُوراً ﴾(الإسراء: 99) .
وجاء الأمر في السورة الكريمة بندائهم بوصف الكافرين :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وجاء في سورة الزُّمَر بندائهم بوصف الجاهلين :﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾(الزمر: 64) . وبيانه : أن هذه السورة نزلت فيهم بتمامها ، وليس كذلك سورة الزُّمَر ؛ ولهذا كان لابدَّ من أن تكون المبالغة بالوصف فيها أبلغَ وأشدَّ . ولا يوجد لفظ أبلغ في الكشف عن حقيقة هؤلاء ، وأشدُّ وقعًا عليهم ، وإيلامًا لهم من لفظ ( الكافرين ) . ثم إنه لا يوجد لفظ أبشع ولا أشنع من هذا اللفظ ؛ لأنه صفة ذمٍّ عند جميع الخلق ، سواء كان مطلقًا ، أو مقيدًا . أما لفظ ( الجهل ) فإنه عند التقييد قد لا يذم ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في علم الأنساب :« علم لا ينفع ، وجهل لا يضر » ، خلافًا للجهل المطلق فهو الذي يذم ؛ إذ هو كالشجرة ، والكفر منه كالثمرة . فلما نزلت السورة ، وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه . ولكون الكفر ثمرة للجهل وصفة ذمٍّ ، لم يقع الخطاب به في القرآن الكريم في غير موضعين ، هذا أحدهما . والثاني قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾(التحريم: 7) .
والفرق بين الوصفين : أن ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يحتمل أن يكونوا قد آمنوا ، ثم كفروا . وأما ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ فيدل على أن الكفر صفة ملازمة لهم ، ثابتة فيهم ، سواء كانوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها الحق ، أو لم يكونوا . وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاحها بهذا الخطاب ، بحقيقة الانفصال الذي لا يُرجَى معه اتصال أبدًا بين الكفر والإيمان ، وبين الحق والباطل !
ولسائل أن يسأل : لمَ جاء خطابهم في قوله تعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ بالأمر ﴿ قُلْ ﴾ ، وجاء بدونه في قوله :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾(التحريم: 7) ؟ ويجاب عن ذلك بأن الخطاب في سورة التحريم إنما هو خطاب لهم يوم القيامة ، وهو يومٌ لا يكون فيه الرسول رسولاً إليهم . ثم إنهم في ذلك اليوم يكونون مطيعين ، لا كافرين ؛ فلذلك ذكرهم الله عز وجل بقوله :﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . وأما الخطاب في سورة الكافرين فهو خطاب لهم في الدنيا ، وأنهم كانوا موصوفين بالكفر ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولاً إليهم ؛ فلهذا جاء خطابهم بقوله تعالى :﴿ قُلْ ﴾ . وفي ذلك إشارة إلى أن من كان الكفر وصفًا ثابتًا له لازمًا لا يفارقه ، فهو حقيق أن يتبرَّأ الله تعالى ورسله منه وممَّا يعبد من دون الله تعالى ، ويكون هو أيضًا بريئًا من الله تعالى ورسله ودينهم .
فإن قيل : إنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بالرفق واللين في جميع الأمور ؛ كما قال تعالى :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾(الأنبياء: 107) ، ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾(آل عمران: 159) . كما أنه كان مأمورًا بأن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى :﴿ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(النحل: 125) ، ولما كان الأمر كذلك ، فكيف يليق ذلك الرفق واللين والحسن بهذا التغليظ في قوله :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ؟
فالجواب عن ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا الكلام من الله عز وجل ، لا أنه ذكره من عند نفسه ، فهو رسول مبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه ؛ كما نصَّ على ذلك قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾(المائدة: 67) ، فأمره سبحانه بتبليغ كل ما أنزل عليه ، فلما قال له تعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ نقل هو- عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام بجملته ، وبلغه إلى كل كافر ؛ كما أمره ربه جل وعلا . والسور المفتتحة في القرآن بالأمر ﴿ قُلْ ﴾ خمس سور : سورة الجن ، وسورة الكافرون ، وسورة الإخلاص ، والمعوِّذتان ؛ فالثلاث الأول نزلت لقول يبلِّغه ، والمعوِّذتان نزلتا لقول يقوله لتعويذ نفسه .
ثالثًا- وقوله :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ جواب للنداء ، وهو نفي لعبادته ما يعبدونه فيما هو كائن لم ينقطع ، وقابله بقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، وهو نفي لعبادتهم ما يعبده هو في المستقبل . وأما قوله :﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾ فهو نفي لعبادته ما عبدوه في المستقبل ، وقابله بقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، وهو نفي لعبادتهم ما يعبده في المستقبل . وعلى هذا فلا تكرار أصلاً في السورة ، خلافًا لمن زعم أن هذا تكرار الغرض منه التوكيد . وبهذا الذي ذكرت تكون الآيات الكريمة قد استوفت أقسام النفي عن عبادته صلى الله عليه وسلم ، وعبادة الكافرين ، في الماضي والحاضر والمستقبل ، بأوجز لفظ وأخصره وأبينه .
ثم إن في تكرير الأفعال بصيغة المضارع ﴿ أَعْبُدُ ﴾ الذي يدل على ما هو كائن لم ينقطع حين أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه ، وتكريرها بصيغة المضارع ﴿ أَعْبُدُ ﴾ والماضي ﴿عَبَدتُّمْ ﴾ حين أخبر عنهم ، سرٌّ بديع من أسرار البيان ، وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده ، والاستبدال به غيره ، وأن معبوده عليه الصلاة والسلام واحد في الحال ، وفي المآل على الدوام ، لا يرضى به بدلاً ، ولا يبغي عنه حولاً ، بخلاف الكافرين ؛ فإنهم يعبدون أهواءهم ، ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم ، فهم بصدَد أن يعبدوا اليوم معبودًا ، وغدًا يعبدون غيره .
رابعًا- وقال :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، فعبَّر عن معبودهم ، ومعبوده بـ« مَا » ، وهي في مذهب الجمهور لما لا يعقل . فإن صحَّ التعبير بها عن معبودهم ؛ لأنه أصنام لا تعقل ، فكيف عبَّر بها عن معبوده ، وهو الباري جل وعلا ؟ ولمَ لمْ يعبِّر عنه بـ« مَنْ » التي أجمعوا على وقوعها على من يعقل ، فيقول :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَنْ أَعْبُدُ ﴾ ؟
وقد أجابوا عن ذلك من وجوه :
أحدها : أن « مَا » بمعنى :« الَّذِي » ، وهو اسم موصول يُعبَّر به عن العاقل ، وغير العاقل . والتقدير : لا أعبد الذي تعبدون ، ولا تعبدون الذي أعبد .
والثاني : أن المراد من معبودهم ومعبوده الصفة ، والمعنى : لا أعبد الباطل ، ولا أنتم تعبدون الحق .
والثالث : أن « مَا » مصدرية تقدَّر مع ما بعدها بالمصدر ، والمعنى : لا أعبد عبادتكم ، ولا أنتم تعبدون عبادتي . كما في قوله تعالى :﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾(النساء: 3) . أي : فانكحوا الطيِّب من النساء .
والرابع : أنه لما قال أولاً :﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ، ومعبودهم لا يصلح للتعبير عنه إلا « مَا » ، حمل عليه قوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، وإن كان المراد بمعبوده الباري جل وعلا ، قصدًا لازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة ، فاستوى بذلك اللفظان وتقابل الكلامان ، ولم يتنافيا .
والخامس : أن « مَا » ، و« مَنْ » قد تتعاقبان ، فتقع إحداهما موقع الأخرى ؛ كما في قوله تعالى في أحد القولين :﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾(النساء: 3) ، ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ﴾(النساء: 22) . أي : فانكحوا مَنْ طاب لكم من النساء ، ولا تنكحوا من نكح آباؤكم منهن ، فعبَّر بـ« مَا » تنزيلاً للإناث منزلة غير العقلاء . وقوله :﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾(الأحقاف: 5) . أي : يدعو من دون الله ما لا يستجيب له ، فعبَّر عنه بـ« مَنْ » تنزيلاً لما لا يعقل منزلة العقلاء .
وفي الإجابة عن ذلك نقول بعون الله وتعليمه :
1- أما القول بأن « مَا » بمعنى « الَّذِي » فهو مبنيُّ على اعتبار أنهما اسمان موصولان . وهذا الاعتبار مبني في الأصل على التقسيم الثلاثي القاصر لأقسام الكلم في اللغة العربية ؛ إذ حصروه في : الاسم والفعل والحرف . وكان ينبغي أن تحل الأداة محل الحرف في هذا التقسيم ؛ كما كان ينبغي أن تتسع دائرة هذا التقسيم ؛ لتشمل ما يسمَّى بالصفة ، والضمير ، وغيرهما من الكلمات التي لم تنل حظًّا وافرًا من التحقيق اللغوي .
ومن الواضح أن حصر أنواع الكلم في الاسم والفعل والحرف قد خلق كثيرًا من اللبس والاختلاط وسوء الفهم ؛ فمن ذلك إطلاقهم مصطلح الاسم على أنواع من الضمائر والصفات ، فكان هناك ما يسمَّى بالأسماء الموصولة ، وكان ينبغي أن يطلق عليها : الضمائر الموصولة . وهذه الضمائر الموصولة بعضها صفات ؛ كـ« الَّذِي » و« الَّتِي » ، وبعضها الآخر كنايات ؛ كـ« مَنْ » و« مَا » .
ويمكن إدراك الفرق بين « الَّذِي » ، و« مَا » ، و « مَنْ » من مراقبة وظيفة كل منها في الجملة . تقول :« الرجل الذي زارني عالم » ، ولا تقول :« الرجل ما زارني عالم » ، أو :« الرجل من زارني عالم » ؛ لأن « مَا » ، و« مَنْ » لا يكونان صفة كما يكون « الَّذِي » ؛ وإنما يكونان كناية .. فإذا قيل :« الذي زارني عالم » فمن حلول الصفة محلَّ الموصوف . وإذا قيل :« من زارني عالم » و :« ما عندي خير مما عندك » ، فمن حلول الكناية محلَّ المَكْنِيِّ عنه ، ويُعَبَّر بهما عن المفرد والجمع ، بخلاف « الَّذِي » ؛ إذ لا يُعَبَّر به إلا عن المفرد .. وهذا هو أحد أوجه الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة .
2- وأما القول بأن المراد من معبودهم ومعبوده الصفة ، وأن المعنى : لا أعبد الباطل ، ولا أنتم تعبدون الحق ، فهو قول فاسد ؛ لأن المراد إعلام الكافرين براءتم من عبادة معبوده الموصوف بأنه الحق ، وبراءته عليه الصلاة والسلام من عبادة معبودهم الموصوف بالباطل . وفرق كبير بين أن يقال : فلان يعبد الله الحق ، وبين أن يقال : فلان يعبد الحق ؛ فالثاني فاسد قطعًا ؛ بل هو شرك نعوذ بالله تعالى منه ؛ لأن الصفة غير الموصوف ، وإن كانت صفة لله . فالعبادة لا تكون للصفة ؛ وإنما تكون لله عز وجل الموصوف بهذه الصفة ، والتي استحق لأجلها العبادة . فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله ، لم يكن متعبدًا لله ؛ وإنما يكون متعبدًا لتلك الصفة . قال تعالى :﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الأنعام: 162) . فلكونه تعالى رب للعالمين استحق العبادة .
3- وأما القول بأن « مَا » مصدرية تقدَّر مع ما بعدها بالمصدر ، وأن المعنى : لا أعبد عبادتكم ، ولا أنتم تعبدون عبادتي ، فليس كذلك ؛ إذ المراد- كما تقدم- براءته عليه الصلاة والسلام من معبودهم ، وإعلامهم أنهم بريئون من معبوده . فالمقصود المعبود لا العبادة ، ولو جعلت مصدرية ، لما دلت على هذا المعنى .. فتبين أن كونها موصولة أنسب وأجود ؛ لإبهامها ووقوعها على الجنس العام . ونظير ذلك قوله تعالى :﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾(يونس: 41) .
وأما قوله تعالى :﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾(النساء: 3) فليست « مَا » فيه مصدرية ، أو واقعة موقع « مَنْ » ، وإنما أوثر التعبير هنا بـ« ما » ؛ لأنه نُحِيَ بها مَنْحَى الصفة ، وهو الطِّيب من جنس النساء بِلا تعيين ذات ، وإن كان فيها الإشارة إلى الذات . أو أريد بها النوع . أي : فانكحوا النوع الطيب من النساء . ولو قيل :( فانكحوا مَنْ طاب لكم ) ، لتبادر إلى الذهن إرادة نسوة معروفات بينهم بحسبهن ونسبهن .. وكذلك حال « مَا » في الاستفهام ، فإذا قلت :« ما تزوجت ؟ » فأنت تريد : ما صفتها ؟ أبكرًا ، أم ثيِّبًا ؟ . وإذا قلت :« مَنْ تزوجت ؟ » فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها .. وهذا- كما قال ابن قيِّم الجوزيَّة- باب لا ينخرم ، وهو من ألطف مسالك العربية .. فتأمل !!!
4- وأما القول بأنه قال :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، ولم يقل :( من أعبد ) ؛ ليقابل به ، قوله :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ، فهو قول مبني على أن المراد بمعبودهم الأصنام ، وهو قول ضعيف ؛ لأنه يحصر براءته عليه الصلاة والسلام من عبادة الأصنام التي يعبدها كفار العرب ، دون غيرها مما يعبده كفار أهل الأرض جميعهم من دون الله عز وجل . والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعلن براءتهم من عبادة معبوده ، وبراءته من عبادة معبودهم على الإطلاق ، فشملت البراءة كل ما يعبده الكفار من الأصنام والأوثان ، ومن شياطين الإنس والجن ، ومن الملائكة والمسيح ، وغير ذلك مما يعقل ولا يعقل . فتخصيص البراءة من الشرك بشرك كفار العرب غلط عظيم ؛ وإنما هي براءة من كل شرك . ثم إن كون الرب جل وعلا يتصف بما تتصف به الأصنام من عدم العلم فهو مما لا يجوز عليه سبحانه ، ولا تصح المقابلة فى مثل ذلك ؛ بل المقصود التعبير عن معبودهم ومعبوده على الإطلاق دون تخصيص ؛ ليتبرأ من معبودهم ، ويبرئهم من معبوده على الإطلاق .
5- وأما القول بأن « مَا » ، و« مَنْ » قد تتعاقبان فتقع إحداهما موقع الأخرى ، فليس كذلك ؛ لأن « مَا » ضمير موصول يقع على الأجناس كلها ، ولا يقع فيها إلا على جنس تتنوَّع منه أنواع . فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصُّوا بها ما يعلم ويعقل ، أبدلوا ألفها نونًا ساكنة ، فقالوا :« مَنْ » .
تأمل قول الله تعالى :﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾(الأحقاف: 4) ، كيف عبَّر سبحانه عن معبود الكافرين بقوله :﴿ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ، فدل على أنه جنس تحته أنواع ، هي أصنامهم وأوثانهم ، وكل ما يدعونه من دون الله تعالى مما يعقل ولا يعقل . وهذا المعنى لا يصلح للتعبير عنه غير « مَا » المبهمة التي تقع على كل شيء .
ثم تأمل قوله تعالى في الآية التي تلت الآية السابقة :﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾(الأحقاف: 5) ، كيف عدل سبحانه عن « مَا » في الآية السابقة إلى « مَنْ » في قوله :﴿ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ ، فدل على أن المراد به النوع الذي يعقل ممَّن يدعونه من دون الله ، من شياطين الإنس والجن ، والملائكة وعيسى ، ونحوهم ؛ فإن هؤلاء لا يستجيبون لمن يعبدونهم ويدعونهم من دون الله إلى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون .
فلما كان المراد الجنس العام دون تخصيص أتِي بـ« مَا » ، ولما كان المراد نوع معين من أنواع الجنس العام ، وتخصيصه بمن يعقل أتِيَ بـ« مَنْ » . ولو كان المعنى في الموضعين- على ما قيل- واحدًا ، لم يكن لهذا العدول أي معنى . ولو كان المراد بـ﴿ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ الأصنام وحدها ، لما احتيج تقييده بقوله تعالى :﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ . وهذا الاحتياج ينبعث من كون « مَا » مبهمة عامة . وحيث كانت بإبهامها وعمومها واقعة على الجنس العام ومتناولة لله جل وعلا ، احتيج ذلك إلى هذا التقييد . فلو كانت مختصة بما لا يعقل ، لما احتيج إليه ، ولما كان له فائدة سوى التأكيد . أما بناء على أنها واقعة على الجنس العام ، ومتناولة لما يعقل وما لا يعقل ، تكون فائدة هذا التقييد التأسيس . والتأسيس أولى من التأكيد ؛ لأنه الأصل ، فحمل الكلام عليه أولى من حمله على التأكيد .
خامسًا- وقد سبق أن ذكرنا أن الخطاب في قوله :﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ هو خطاب للجنس ، فيتناول كل كافر ؛ سواء كان ممن يظهر الشرك ، أو كان ممن فيه تعطيل لما يستحقه الله تعالى من العبادة ، واستكبار عن عبادته . ولذلك لم يقل :( يا أيها المشركون ) . أو :( يا أيها النصارى ) . أو :( يا أيها اليهود ) ؛ وإنما قال :﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ! فخاطب جنس الكافرين على اختلاف أنواعهم ومشاربهم .
ثم قال :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، فنفى عليه الصلاة والسلام عبادته لما يعبدون ، وعبادتهم لما يعبد نفيًا مطلقًا . وما يعبدونه هم ويعبده هو معناه : المعبود . والمعبود لفظ مطلق يتناول المفرد والجمع ، والمذكر والمؤنث ؛ فهو يتناول كل معبود لهم . والمعبود هو الإله ، ويتضمن إضافة إلى العابد ؛ فكأنه- عليه الصلاة والسلام- قال : لا أعبد إلهكم ، ولا تعبدون إلهي ؛ كما ذكر الله تعالى فى قصة يعقوب عليه السلام ، فقال :
﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾(البقرة: 133)
فأخبر سبحانه أن إله يعقوب وإله آبائه- إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم- هو الذي يعبده هؤلاء ، ويألهونه ، ويعبده كل من كان على ملتهم ؛ كما قال يوسف عليه السلام :
﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾(يوسف: 37- 38) إلى قوله :﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾(يوسف: 40)
فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله جل وعلا ، وهي ملة إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام ، وقد قال الله تعالى :
﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾(البقرة: 130)
فبين أن كل من رغب عن ملة إبراهيم – عليه السلام - فهو سفيه . وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى وكفار مكة وغيرهم ليسوا على ملة إبراهيم . وإذا لم يكونوا على ملته ، لم يكونوا يعبدون إلهه .
ولفظ الإله يراد به : المستحق للإلهية والعبادة . ويراد به : كل ما اتُّخِذ إلهًا باطلاً وعُبِد من دون الله سبحانه ، وهو جنس تحته أنواع منه ؛ كالأصنام ، والأوثان ، والمسيح بن مريم ، وعُزَيْر ، والأحبار والرهبان ، والإناث من الملائكة ، والشياطين من الإنس والجن ، والشمس والقمر ، والدرهم والدينار ، وكل ما عبد ويعبد من دون الله سبحانه ، ممَّا يسمَّى آلهة .
إذا عرفت ذلك ، تبيَّن لك أن المراد بقوله :﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ التعبير عن إله الكافرين على الإطلاق ، دون تخصيص بالأصنام ، أو غيرها ، وأن المراد بقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ التعبير عن إلهه جل وعلا على الإطلاق ، دون تخصيص ؛ لأن امتناعهم عن عبادة الله تعالى لم يكن لذاته ؛ بل كانوا يظنون أنهم كانوا يعبدون الله ؛ ولكنهم كانوا جاهلين به . قال تعالى :﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً ﴾(الفرقان: 60) ، فقالوا :﴿ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ ؛ لأنهم لا يعرفونه بحقيقته التي وصف سبحانه وتعالى بها نفسه ، والتي عرفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ووصفه بها . ولو كانوا يعرفونه حق معرفته ويقدرونه حق قدره ، لقالوا :( ومن الرحمن ؟ أنسجد لمن تأمرنا ؟ ) ؛ ولهذا ناسب إيقاع « مَا » عليه ، دون « مَنْ » ؛ لأن من جلت عظمته حتى خرجت عن الحصر وعجزت الأفهام عن كنه ذاته ، وجب أن يقال فيه :« هو ما هو » ؛ كقول العرب :« سبحان ما سبح الرعد بحمده » ، وقولهم :« سبحان ما سخَّركُنَّ لنا » . فـ« مَا » في هذه الموضع ونحوه اقتضاها الإبهام وتعظيم المعبود ، مع أن الحسَّ منهم مانعٌ لهم أن يعبدوا معبوده كائنًا ما كان ؛ فلهذا حسُنت ، دون « مَنْ » .
وبنحو هذا أجاب الشيخ السهلي رحمه الله ، ثم ذكر جوابًا آخر ؛ وهو :« أنهم كانوا يشتهون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدًا له وأنفة من اتباعه ، فهم لا يعبدون معبوده ، لا كراهية لذات المعبود ؛ ولكن كراهية لاتباعه صلى الله عليه وسلم ، وشهوة منهم لمخالفته في العبادة ، كائنًا ما كان معبوده ، وإن لم يكن معبوده إلا الحق سبحانه وتعالى .. فعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا « مَا » ، لإبهامها ، ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية » .
وأقرب من هذا - كما قال ابن قيِّم الجوزيَّة- هو :« أن المقصود هنا ذكر المعبود ، الموصوف بكونه أهلاً للعبادة ، مستحقًا لها ، فأتى بـ« مَا » الدالة على هذا المعنى ؛ كأنه قيل : ولا أنتم عابدون معبودي ، الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أتى بلفظ « مَنْ » ، لكانت إنما تدل على الذات فقط ، ويكون ذكر الصلة تعريفًا ، لا إنه جهة العبادة . ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلاً لأن يعبد تعريف محض ، أو وصف مقتض لعبادته .. فتأمله ، فإنه بديعٌ جدًّا » .
ويتضح لك ذلك إذا علمت أن المعبود لا يعبد لذاته ؛ وإنما يعبد لصفاته لصفاته الدالة على ذاته ، أيًّا كان ذلك المعبود ؛ ولهذا أنكر الله تعالى على المشركين عبادة الآلهة من دونه سبحانه ، ووبخهم عليها ؛ لأنهم عبدوا ذواتًا لا صفات لها ، وسمُّوها بأسماء لا تستحقها ، وتركوا عبادة الله المتصف بصفات الكمال والجلال ، فقال عز وجل :
﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾(النحل: 17) ؟
﴿ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾(الأنبياء: 67)
ولهذا لما سأل فرعونُ موسى- عليه السلام- عن رب العالمين ؛ كالطالب لماهيَّته ، سأل بـ« مَا » ، ولم يسأل بـ« مَنْ » ، فقال :﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾(الشعراء: 23) ، فأجابه موسى عليه السلام ببيان الأوصاف المرشدة إلى معرفة الله جل وعلا ، والتي استحق لأجلها أن يكون ربًّا ، وإلهًا معبودًا ، فقال :﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾(الشعراء: 24) .
فإذا تأملت ما تقدم ، تبين لك أنه لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع أن يعبَّر بـ« مَنْ » بدلاً من « مَا » ، أو العكس . والله تعالى أعلم .
سادسًا- ومن تأمل صيغ النفي في السورة الكريمة ، وجد أن النفي لم يأت في حق الكافرين إلا بصيغة الفاعل :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ ﴾ . وأما في جهة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالفعل المضارع :﴿ لا أَعْبُدُ ﴾ تارة ، وبصيغة الفاعل :﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ ﴾ تارة أخرى ؛ وذلك- والله أعلم- لنكتة بديعة ، وهي أن المقصود الأعظم من ذلك براءته صلى الله عليه وسلم من معبوديهم بكل وجه ، وفي كل وقت ؛ ولهذا أتى في هذا النفي بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ، ثم أتى بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت ، فأفاد في النفي الأول أن تلك العبادة لا تقع منه أبدًا ، وأفاد في الثاني أن تلك العبادة ليست من وصفه ، ولا من شأنه ؛ فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : عبادة غير الله تعالى لا تكون فعلاً لي ، ولا وصفًا من أوصافي ، فأتى بنفييْن لمنفيَّين مقصودين بالنفي . وأما في حق الكافرين فإنما أتى بصيغة الفاعل الدالة على الوصف والثبوت دون الفعل ، فأفاد ذلك أن الوصف الثابت اللازم العائد لله تعالى منتفٍ عن الكافرين ؛ لأن هذا الوصف ليس ثابتًا لهم ، وإنما هو ثابت لمن خصَّ الله تعالى وحده بالعبادة ، ولم يشرك معه فيها أحدًا .
وعقَّب ابن قيِّم الجوزيَّة على ذلك بقوله :« فتأمل هذه النكتة البديعة ، كيف تجد في طيَّها أنه لا يوصف بأنه عابدٌ لله تعالى ، وأنه عَبْدُهُ المستقيم على عبادته ، إلا من انقطع إليه بكلِّيته ، وتبتَّل إليه تبتيلاً ، لم يلتفت إلى غيره ، ولم يشرك به أحدًا في عبادته ، وأنه وإن عبده وأشرك به غيره ، فليس بعابدٍ لله تعالى ، ولا عَبْدًا له سبحانه . وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتيْ الإخلاص والتي تعدل ربع القرآن ؛ كما جاء في بعض السنن . وهذا لا يفهمه كل أحد ، ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عنده .. فلله الحمد والمِنَّة » .
سابعًا- ومن أسرار هذه السورة التي لا يكاد يُفطَن إليها أن النفي فيها أتى بأداة النفي « لا » ، ولم يأت بالأداة « ما » ، مع أن نفي الحاضر الدائم والمستمر بـ« ما » أولى من نفيه بـ« لا » ، وأكثر منه استعمالاً . والسر في ذلك أن « ما » لا ينفى بها في الكلام إلا ما بعدها ، وأنها لا تكون إلا جوابًا عن الدعوى . أما « لا » ، فينفى بها في أكثر الكلام ما قبلها ، فيكون ما بعدها في حكم الوجوب ، وأنها تكون جوابًا عن السؤال ، وتكون ردًّا لكلام سابق . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن « لا » إذا نفي بها المضارع ، فإنها تدل على نفيه نفيًا شاملاً مستغرقًا لكل جزء من أجزاء الزمن ، بدون قرينة تصحبها ؛ كما في قوله تعالى :﴿ عَالِمِ الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾(سبأ: 3) . أما « ما » فلا تدل على نفي المضارع على سبيل الاستغراق إلا بوجود قرينة تصحبها ، وهي « مِنْ » الاستغراقية ؛ كما في قوله تعالى :﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾(يونس: 61).
وبهذا تكون هذه السورة العظيمة قد اشتملت على النفي المحض ، وهذا هو خاصيَّتها ؛ فإنها سورة براءةٍ من الشرك- كما جاء في وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم- فالمقصود الأعظم منها هو البراءة المطلوبة بين الموحدين ، والمشركين ؛ ولهذا جيء بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة ، مع أنها متضمنَّة للإثبات صريحًا ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ براءة محضة . وقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ إثبات أن له عليه الصلاة والسلام معبودًا يعبده ، وأنهم بريئون من عبادته . فتضمَّنت بذلك النفي والإثبات ، وطابقت قول إمام الحنفاء سيدنا إبراهيم عليه السلام :﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾(الزخرف: 26- 27) ، وطابقت قول الفئة الموحّدة :﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا ﴾(الكهف: 16) ، فانتظمت بذلك حقيقة التوحيد بقول :« لا إله إلا الله » .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن هذه السورة العظيمة بسورة ( قل هو الله أحد ) ، في سنة الفجر ، وسنة المغرب ؛ فإن هاتين السورتين ( سورتي الإخلاص ) قد اشتملتا- كما قال ابن قيِّم الجوزية- على نوعَيْ التوحيد الذين لا نجاة للعبد ، ولا فلاح له إلا بهما : أولهما : توحيد العلم والاعتقاد . وثانيهما : : توحيد القصد والإرادة .
1- فأما توحيد العلم والاعتقاد فهو المتضمِّن تنزيه الله تعالى عمَّا لا يليق به ، من الشرك والكفر، والولد والوالد ، وأنه إله أحد صمد ، لم يلد فيكون له فرع ، ولم يولد فيكون له أصل ، ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له مِثْل . ومع هذا فقد اجتمعت له جل جلاله صفات الكمال كلها ، فتضمنَّت السورة إثبات ما يليق بجلال الله عز وجل من صفات الكمال ، ونفي ما لا يليق بجلاله سبحانه من الشريك أصلاً وفرعًا ، وشبهًا ومثلاً .. فهذا هو توحيد العلم والاعتقاد .
2- وأما توحيد القصد والإرادة فهو أن لا يُعبدَ إلا الله جل وعلا ، فلا يُشرَك به في عبادته سواه ؛ بل يكون وحده سبحانه هو المعبود . وسورة الكافرون مشتملة على هذا النوع من نوعيْ التوحيد ، فتضمنت بذلك السورتان نوعيْ التوحيد ، وأخلصتا له .
ثامنًا- ومن أسرار هذه السورة العظيمة ما تضمنه قوله تعالى في ختامها من التأكيد :﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . والسؤال هنا : هل أفاد هذا معنى زائدًا على ما تقدَّم ؟ والجواب : أن النفي في الآيات السابقة أفاد براءته صلى الله عليه وسلم من معبوديهم ، وأنه لا يتصور منه ، ولا ينبغي له أن يعبدهم ، وهم أيضًا لا يكونون عابدين لمعبوده ؛ كما أفاد إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم ونصيبهم ، فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو ، وغيره أرضًا ، فقال له : لا تدخل في حدِّي ، ولا أدخل في حدِّك ، لك أرضك ، ولي أرضي . فتضمَّنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أن المؤمنين ، والكافرين اقتسموا حظهم فيما بينهم ، فأصاب المؤمنين التوحيدُ والإيمان ، فهو نصيبهم الذي اختصوا به ، لا يشركهم الكافرون فيه . وأصاب الكافرين الشركُ بالله تعالى والكفر به ، فهو نصيبهم الذي اختصوا به ، لا يشركهم المؤمنون فيه .
ثم إن في تقديم حظ الكافرين ونصيبهم في هذه الآية على حظ المؤمنين ونصيبهم ، وتقديم ما يختص به المؤمنون على ما يختص به الكافرون في أول السورة ، من أسرار البيان وبديع الخطاب ، ما لا يدركه إلا فرسان البلاغة وأربابها ، وبيان ذلك :
أن السورة لما اقتضت البراءة ، واقتسام دينَيْ التوحيد والشرك بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين الكافرين ، ورضي كلٌّ بقسمه ، وكان المحق هو صاحب القسمة ، وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون ، وأنه استولى على القسم الأشرف ، والحظ الأعظم ، أراد أن يشعرهم بسوء اختيارهم ، فقدم قسمهم على قسمه ، تهكمًا بهم ، ونداءً على سوء اختيارهم ، فكان ذلك- كما قال ابن قيِّم الجوزيَّة- بمنزلة من اقتسم هو ، وغيره سُمًَّا وشفاءً ، فرضي مقاسمه بالسمِّ ؛ فإنه يقول له : لا تشاركني في قسمي ، ولا أشاركك في قسمك . لك قسمك ، ولي قسمي ! ولهذا كان تقديم قوله :﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ على قوله :﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ هنا أبلغ وأحسن ؛ وكأنه يقول : هذا هو قسمكم الذي آثرتموه بالتقديم ، وزعمتم أنه أشرف القسمين ، وأحقهما بالتقديم !!
وذكر ابن قيِّم الجوزيَّة وجهًا آخر ؛ وهو : أن مقصود السورة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم- هذا هو لبُّها ومغزاها- وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكمِّلاً لبراءته ومحققًا لها . فلما كان المقصود براءته من دينهم ، بدأ به في أول السورة ، ثم جاء قوله تعالى :﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ مطابقًا لهذا المعنى . أي : لا أشارككم في دينكم ، ولا أوافقكم عليه ؛ بل هو دين تختصون به أنتم ، فطابق آخر السورة أولها .
فتأمل هذه الأسرار البديعة المعجزة ، واللطائف الدقيقة المبهرة التي تشهد أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد ، وأنه الأعلى في البلاغة والفصاحة والبيان ! نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يفقهون كلامه ، ويدركون أسرار بيانه ، والحمد لله على نعمة الفهم والعقل والدين .
قال الله تبارك وتعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾(الكافرون : 1- 6)
أولاً- هذه السورة مكية ، وآياتها ست آيات ، وتسمى : سورة البراءة ، وسورة الإخلاص . وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه :« إنها تعدِل ثُلثَ القرآن » . وروى ابن الأنباري عن أنس- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، تعدل رُبُعَ القرآن » . وخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في صلاة الفجر في سفر ، فقرأ :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ﴾ ، ثم قال صلى الله عليه وسلم :« قرأت عليكم ثُلثَ القرآن ، ورُبُعَه » . وخرَّج ابنُ الأنباري عن نوفل الأشجعي ، قال : جاء رجُل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أوصني ، قال :« اقرأ عند منامك : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ؛ فإنَّها براءةٌ من الشِّركِ » .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما :« ليس في القرآن أشدُّ غيظًا لإبليس - لعنه الله - من هذه السورة ؛ لأنها توحيد ، وبراءة من الشرك » . وقال الأصمعي :« كان يقال لـ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ﴾ المقشقشتان » . أي : إنهما تبرئان من النفاق ؛ كما يقشقش القطِرانُ الجرب ، فيبرئه .
وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« أتحب يا جُبيرُ ، إذا خرجت سفرًا ، أن تكون من أَمْثَلِ أصحابك هيْئةً ، وأكْثرِهم زادًا ؟ » قلت : نعم . قال :« فاقرأ هذه السُّوَر الخمسَ من أول : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، إلى : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، وافتتح قرءاتك ببسم الله الرحمن الرحيم » . قال : فوالله ، لقد كنت غير كثير المال . إذا سافرت ، أكون أبذَّهُم هيئة ، وأقلهم مالاً ، فمذ قرأتهن ، صرت من أحسنهم هيئة ، وأكثرهم زادًا ، حتى أرجع من سفري ذلك .
وروى ابن اسحق في سبب نزول هذه السورة الكريمة ، فقال :« اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يطوف بالكعبة- فيما بلغني- الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، والوليد بن المغيرة ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل السهمي ، وكانوا ذوي أسنان في قومهم ، فقالوا : يا محمد ! هَلُمَّ ، فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن ، وأنت في الأمر ؛ فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان ما نعبد خيرًا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه . فأنزل الله تعالى فيهم :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.. ﴾ إلى آخر السورة » .
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن العرب في جاهليتهم الأولى لم يكونوا يجحدون الله تعالى ؛ ولكنهم كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف سبحانه وتعالى بها نفسه ، والتي عرفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ، شأنهم في ذلك شأن الأمم الأخرى ؛ ولهذا كانوا يشركون به آلهتهم في العبادة ، وكانوا لا يقدرونه حق قدره ، ولا يعبدونه حق عبادته ؛ كغيرهم ممَّن سبقهم من عبَّاد الأصنام والأوثان . لقد كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى ، وأنه الخالق للسموات والأرض ، والخالق لذواتهم ؛ ولكنهم مع إيمانهم به ، كان الشرك يفسد عليهم تصوُّرَهم ، كما كان يفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم . وكانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام ، وأنهم أهدى من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة العربية ؛ لأن اليهود يقولون : عزيرٌ ابنُ الله . والنصارى يقولون : عيسى ابنُ الله ، بينما هم يعبدون الملائكة والجن ، على اعتبار قرابتهم من الله - على حدِّ زعمهم- فكانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقًا ؛ لأن نسبة الملائكة والجن إلى الله تعالى أقرب من نسبة عزير وعيسى . وهذا كله شرك ، وليس في الشرك خيار .
ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول :﴿ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾(الأنعام: 161) ، قالوا : نحن على دين إبراهيم ، فما حاجتنا- إذًا- إلى ترك ما نحن عليه ، واتباع محمد ؟! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم خطةً وسطًا بينهم وبينه ، فعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه ، وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم ، وله فيهم وعليهم ما يشترط !
ولعل اختلاط تصوراتهم ، واعترافهم بوجود الله مع عبادة آلهة أخرى معه ، كان يشعرهم أن المسافة بينهم ، وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة يمكن التفاهم عليها ؛ وذلك بقسمة البلد بلدين ، والالتقاء في منتصف الطريق ، مع بعض الترضيات الشخصية ؛ كما يفعلون في التجارة تمامًا . وفرق بين الاعتقاد ، والتجارة كبير ! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها ؛ لأن الصغير منها كالكبير ؛ بل ليس في العقيدة صغير وكبير ، إنها حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء ، لا يطيع فيها صاحبها أحدًا ، ولا يتخلى عن شيء منها أبدًا . وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام ، والجاهلية في منتصف الطريق ، ولا أن يلتقيا في أي طريق ؛ وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان- جاهلية الأمس واليوم والغد كلها سواء- إن الهُوَّة بينها ، وبين الإسلام لا تُعْبَرُ ، ولا تقام عليها قنطرة ، ولا تقبل قسمة ، ولا صلة ، ولا مساومة ؛ وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق بين الحق والباطل !
وقد وردت روايات شتى فيما كان يساوم فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدهنون له ؛ ليدهن لهم ويلين ، كما يودون ، ويترك سبَّ آلهتهم وتسفيه عبادتهم ، أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ؛ ليتابعوه في دينه ، وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب ، على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسمًا في موقفه من دينه ، لا يساوم فيه ، ولا يدهن ، ولا يلين ، حتى وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة ، وهو محاصر بدعوته ، وأصحابه القلائل يتخطَّفون ويعذَّبون ويؤذَوْن في الله أشدَّ الإيذاء ، وهم صابرون ، ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الطغاة المتجبرين ، تأليفًا لقلوبهم ، أو دفعًا لأذاهم ، ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب ، أو من بعيد ، وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانبًا ، وأحسنهم معاملة ، وأبرُّهم بعشيرة ، وأحرصهم على اليسر والتيسير . فأما الدين فهو الدين ، وهو فيه عند توجيه ربه ، حيث يقول له سبحانه :
﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴾(القلم:

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾(يونس: 41)
﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾(الكافرون: 1- 6)
ثانيًا- وافتتاح السورة الكريمة بهذا الأمر الإلهي الحاسم :﴿ قُلْ ﴾ لإِظهار العناية بما بعد القول ، وهو افتتاح مُوحٍ بأن أمر هذه العقيدة هو أمر الله تعالى وحده ، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه شيء ؛ إنما هو الله الآمر الذي لا مردَّ لأمره ، والحاكم الذي لا رادَّ لحكمه ؛ ففي قوله تعالى :﴿ قُلْ ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله .
والخطاب بقوله :﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ هو خطاب لجنس الكفار ، فيعم كل كافر على وجه الأرض إلى يوم القيامة ، ويدخل فيه كفار مكة دخولاً أوليًّا ؛ إذ كانوا هم المقصودون أولاً بهذا الخطاب . وخطابه صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الوصف في ناديهم ومكان بسطة أيديهم ، مع ما فيه من الإرذال بهم والتحقير لهم ، دليل على أنه محروس من عند الله تعالى ، لا يبالي بهم . وإنما ابتدىء الخطاب بهذا النداء ﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ الذي يجمع بين نداء النفس ونداء القلب ونداء الروح ؛ لأن النداء يُستَدعَى به إقبالُ المُنادَى على ما سيُلقَى عليه ، بنفسه وقلبه وروحه .
و﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ جمع : كافر، على وزن : فاعل ، من قولهم : كفر يكفر . والكفر في اللغة هو السَّتْرُ والتغطية . ووُصِفَ الليل بالكافر ؛ لأنه يغطي كل شيء . ووُصِفَ الزارع بالكافر ؛ لأنه يغطي البذر في الأرض . وكُفْرُ النعمة وكُفْرانُها : تغطيتها بترك أداء شكرها . قال أحدهم :« لو جاز أن تعبد الشمس في دين الله ، لكنت أعبدها ؛ فإنها شمس ما ألقت يدًا في كافر ، ولا وضعت يدًا إلا في شاكر » . فالكفر يضادُّه الشكر ، وهو مصدر سماعي لكَفَر يكفُر . وأصله : جَحْدُ نعمةَ المُنْعِم ، واشتقاقه من مادة الكَفْر ، بفتح الكاف ، وهو السَّتْرُ والتَّغطِيةُ ؛ لأن جاحد النعمة قد أخفى الاعتراف بها ؛ كما أن شاكرها أعلنها ؛ ولذلك صيغ له مصدر على وزان الشُّكر ، وقالوا أيضًا : كُفْرانٌ ، على وزن شُكْران . ثم أطلق الكفر في القرآن الكريم على جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة ، بناء على أنه أشد صور كفر النعمة ؛ وذلك أعظم الكفر .
واستعمال الكفران في جحود النعمة أكثر من استعمال الكفر . ومنه قول الله تعالى :﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾(الأنبياء: 94) . واستعمال الكفر في الدين أكثر من استعمال الكفران . ومنه قول الله تعالى :﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾(النساء: 136) ، وقوله سبحانه وتعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾(المائدة: 44) . وأما الكُفُور فيستعمل فيهما جميعًا ؛ كما في قول الله تعالى :﴿ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَلاَّ كُفُوراً ﴾(الإسراء: 99) .
وجاء الأمر في السورة الكريمة بندائهم بوصف الكافرين :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وجاء في سورة الزُّمَر بندائهم بوصف الجاهلين :﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾(الزمر: 64) . وبيانه : أن هذه السورة نزلت فيهم بتمامها ، وليس كذلك سورة الزُّمَر ؛ ولهذا كان لابدَّ من أن تكون المبالغة بالوصف فيها أبلغَ وأشدَّ . ولا يوجد لفظ أبلغ في الكشف عن حقيقة هؤلاء ، وأشدُّ وقعًا عليهم ، وإيلامًا لهم من لفظ ( الكافرين ) . ثم إنه لا يوجد لفظ أبشع ولا أشنع من هذا اللفظ ؛ لأنه صفة ذمٍّ عند جميع الخلق ، سواء كان مطلقًا ، أو مقيدًا . أما لفظ ( الجهل ) فإنه عند التقييد قد لا يذم ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في علم الأنساب :« علم لا ينفع ، وجهل لا يضر » ، خلافًا للجهل المطلق فهو الذي يذم ؛ إذ هو كالشجرة ، والكفر منه كالثمرة . فلما نزلت السورة ، وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه . ولكون الكفر ثمرة للجهل وصفة ذمٍّ ، لم يقع الخطاب به في القرآن الكريم في غير موضعين ، هذا أحدهما . والثاني قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾(التحريم: 7) .
والفرق بين الوصفين : أن ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يحتمل أن يكونوا قد آمنوا ، ثم كفروا . وأما ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ فيدل على أن الكفر صفة ملازمة لهم ، ثابتة فيهم ، سواء كانوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها الحق ، أو لم يكونوا . وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاحها بهذا الخطاب ، بحقيقة الانفصال الذي لا يُرجَى معه اتصال أبدًا بين الكفر والإيمان ، وبين الحق والباطل !
ولسائل أن يسأل : لمَ جاء خطابهم في قوله تعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ بالأمر ﴿ قُلْ ﴾ ، وجاء بدونه في قوله :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾(التحريم: 7) ؟ ويجاب عن ذلك بأن الخطاب في سورة التحريم إنما هو خطاب لهم يوم القيامة ، وهو يومٌ لا يكون فيه الرسول رسولاً إليهم . ثم إنهم في ذلك اليوم يكونون مطيعين ، لا كافرين ؛ فلذلك ذكرهم الله عز وجل بقوله :﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . وأما الخطاب في سورة الكافرين فهو خطاب لهم في الدنيا ، وأنهم كانوا موصوفين بالكفر ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولاً إليهم ؛ فلهذا جاء خطابهم بقوله تعالى :﴿ قُلْ ﴾ . وفي ذلك إشارة إلى أن من كان الكفر وصفًا ثابتًا له لازمًا لا يفارقه ، فهو حقيق أن يتبرَّأ الله تعالى ورسله منه وممَّا يعبد من دون الله تعالى ، ويكون هو أيضًا بريئًا من الله تعالى ورسله ودينهم .
فإن قيل : إنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بالرفق واللين في جميع الأمور ؛ كما قال تعالى :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾(الأنبياء: 107) ، ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾(آل عمران: 159) . كما أنه كان مأمورًا بأن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى :﴿ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(النحل: 125) ، ولما كان الأمر كذلك ، فكيف يليق ذلك الرفق واللين والحسن بهذا التغليظ في قوله :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ؟
فالجواب عن ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا الكلام من الله عز وجل ، لا أنه ذكره من عند نفسه ، فهو رسول مبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه ؛ كما نصَّ على ذلك قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾(المائدة: 67) ، فأمره سبحانه بتبليغ كل ما أنزل عليه ، فلما قال له تعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ نقل هو- عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام بجملته ، وبلغه إلى كل كافر ؛ كما أمره ربه جل وعلا . والسور المفتتحة في القرآن بالأمر ﴿ قُلْ ﴾ خمس سور : سورة الجن ، وسورة الكافرون ، وسورة الإخلاص ، والمعوِّذتان ؛ فالثلاث الأول نزلت لقول يبلِّغه ، والمعوِّذتان نزلتا لقول يقوله لتعويذ نفسه .
ثالثًا- وقوله :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ جواب للنداء ، وهو نفي لعبادته ما يعبدونه فيما هو كائن لم ينقطع ، وقابله بقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، وهو نفي لعبادتهم ما يعبده هو في المستقبل . وأما قوله :﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾ فهو نفي لعبادته ما عبدوه في المستقبل ، وقابله بقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، وهو نفي لعبادتهم ما يعبده في المستقبل . وعلى هذا فلا تكرار أصلاً في السورة ، خلافًا لمن زعم أن هذا تكرار الغرض منه التوكيد . وبهذا الذي ذكرت تكون الآيات الكريمة قد استوفت أقسام النفي عن عبادته صلى الله عليه وسلم ، وعبادة الكافرين ، في الماضي والحاضر والمستقبل ، بأوجز لفظ وأخصره وأبينه .
ثم إن في تكرير الأفعال بصيغة المضارع ﴿ أَعْبُدُ ﴾ الذي يدل على ما هو كائن لم ينقطع حين أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه ، وتكريرها بصيغة المضارع ﴿ أَعْبُدُ ﴾ والماضي ﴿عَبَدتُّمْ ﴾ حين أخبر عنهم ، سرٌّ بديع من أسرار البيان ، وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده ، والاستبدال به غيره ، وأن معبوده عليه الصلاة والسلام واحد في الحال ، وفي المآل على الدوام ، لا يرضى به بدلاً ، ولا يبغي عنه حولاً ، بخلاف الكافرين ؛ فإنهم يعبدون أهواءهم ، ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم ، فهم بصدَد أن يعبدوا اليوم معبودًا ، وغدًا يعبدون غيره .
رابعًا- وقال :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، فعبَّر عن معبودهم ، ومعبوده بـ« مَا » ، وهي في مذهب الجمهور لما لا يعقل . فإن صحَّ التعبير بها عن معبودهم ؛ لأنه أصنام لا تعقل ، فكيف عبَّر بها عن معبوده ، وهو الباري جل وعلا ؟ ولمَ لمْ يعبِّر عنه بـ« مَنْ » التي أجمعوا على وقوعها على من يعقل ، فيقول :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَنْ أَعْبُدُ ﴾ ؟
وقد أجابوا عن ذلك من وجوه :
أحدها : أن « مَا » بمعنى :« الَّذِي » ، وهو اسم موصول يُعبَّر به عن العاقل ، وغير العاقل . والتقدير : لا أعبد الذي تعبدون ، ولا تعبدون الذي أعبد .
والثاني : أن المراد من معبودهم ومعبوده الصفة ، والمعنى : لا أعبد الباطل ، ولا أنتم تعبدون الحق .
والثالث : أن « مَا » مصدرية تقدَّر مع ما بعدها بالمصدر ، والمعنى : لا أعبد عبادتكم ، ولا أنتم تعبدون عبادتي . كما في قوله تعالى :﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾(النساء: 3) . أي : فانكحوا الطيِّب من النساء .
والرابع : أنه لما قال أولاً :﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ، ومعبودهم لا يصلح للتعبير عنه إلا « مَا » ، حمل عليه قوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، وإن كان المراد بمعبوده الباري جل وعلا ، قصدًا لازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة ، فاستوى بذلك اللفظان وتقابل الكلامان ، ولم يتنافيا .
والخامس : أن « مَا » ، و« مَنْ » قد تتعاقبان ، فتقع إحداهما موقع الأخرى ؛ كما في قوله تعالى في أحد القولين :﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾(النساء: 3) ، ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ﴾(النساء: 22) . أي : فانكحوا مَنْ طاب لكم من النساء ، ولا تنكحوا من نكح آباؤكم منهن ، فعبَّر بـ« مَا » تنزيلاً للإناث منزلة غير العقلاء . وقوله :﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾(الأحقاف: 5) . أي : يدعو من دون الله ما لا يستجيب له ، فعبَّر عنه بـ« مَنْ » تنزيلاً لما لا يعقل منزلة العقلاء .
وفي الإجابة عن ذلك نقول بعون الله وتعليمه :
1- أما القول بأن « مَا » بمعنى « الَّذِي » فهو مبنيُّ على اعتبار أنهما اسمان موصولان . وهذا الاعتبار مبني في الأصل على التقسيم الثلاثي القاصر لأقسام الكلم في اللغة العربية ؛ إذ حصروه في : الاسم والفعل والحرف . وكان ينبغي أن تحل الأداة محل الحرف في هذا التقسيم ؛ كما كان ينبغي أن تتسع دائرة هذا التقسيم ؛ لتشمل ما يسمَّى بالصفة ، والضمير ، وغيرهما من الكلمات التي لم تنل حظًّا وافرًا من التحقيق اللغوي .
ومن الواضح أن حصر أنواع الكلم في الاسم والفعل والحرف قد خلق كثيرًا من اللبس والاختلاط وسوء الفهم ؛ فمن ذلك إطلاقهم مصطلح الاسم على أنواع من الضمائر والصفات ، فكان هناك ما يسمَّى بالأسماء الموصولة ، وكان ينبغي أن يطلق عليها : الضمائر الموصولة . وهذه الضمائر الموصولة بعضها صفات ؛ كـ« الَّذِي » و« الَّتِي » ، وبعضها الآخر كنايات ؛ كـ« مَنْ » و« مَا » .
ويمكن إدراك الفرق بين « الَّذِي » ، و« مَا » ، و « مَنْ » من مراقبة وظيفة كل منها في الجملة . تقول :« الرجل الذي زارني عالم » ، ولا تقول :« الرجل ما زارني عالم » ، أو :« الرجل من زارني عالم » ؛ لأن « مَا » ، و« مَنْ » لا يكونان صفة كما يكون « الَّذِي » ؛ وإنما يكونان كناية .. فإذا قيل :« الذي زارني عالم » فمن حلول الصفة محلَّ الموصوف . وإذا قيل :« من زارني عالم » و :« ما عندي خير مما عندك » ، فمن حلول الكناية محلَّ المَكْنِيِّ عنه ، ويُعَبَّر بهما عن المفرد والجمع ، بخلاف « الَّذِي » ؛ إذ لا يُعَبَّر به إلا عن المفرد .. وهذا هو أحد أوجه الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة .
2- وأما القول بأن المراد من معبودهم ومعبوده الصفة ، وأن المعنى : لا أعبد الباطل ، ولا أنتم تعبدون الحق ، فهو قول فاسد ؛ لأن المراد إعلام الكافرين براءتم من عبادة معبوده الموصوف بأنه الحق ، وبراءته عليه الصلاة والسلام من عبادة معبودهم الموصوف بالباطل . وفرق كبير بين أن يقال : فلان يعبد الله الحق ، وبين أن يقال : فلان يعبد الحق ؛ فالثاني فاسد قطعًا ؛ بل هو شرك نعوذ بالله تعالى منه ؛ لأن الصفة غير الموصوف ، وإن كانت صفة لله . فالعبادة لا تكون للصفة ؛ وإنما تكون لله عز وجل الموصوف بهذه الصفة ، والتي استحق لأجلها العبادة . فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله ، لم يكن متعبدًا لله ؛ وإنما يكون متعبدًا لتلك الصفة . قال تعالى :﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الأنعام: 162) . فلكونه تعالى رب للعالمين استحق العبادة .
3- وأما القول بأن « مَا » مصدرية تقدَّر مع ما بعدها بالمصدر ، وأن المعنى : لا أعبد عبادتكم ، ولا أنتم تعبدون عبادتي ، فليس كذلك ؛ إذ المراد- كما تقدم- براءته عليه الصلاة والسلام من معبودهم ، وإعلامهم أنهم بريئون من معبوده . فالمقصود المعبود لا العبادة ، ولو جعلت مصدرية ، لما دلت على هذا المعنى .. فتبين أن كونها موصولة أنسب وأجود ؛ لإبهامها ووقوعها على الجنس العام . ونظير ذلك قوله تعالى :﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾(يونس: 41) .
وأما قوله تعالى :﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾(النساء: 3) فليست « مَا » فيه مصدرية ، أو واقعة موقع « مَنْ » ، وإنما أوثر التعبير هنا بـ« ما » ؛ لأنه نُحِيَ بها مَنْحَى الصفة ، وهو الطِّيب من جنس النساء بِلا تعيين ذات ، وإن كان فيها الإشارة إلى الذات . أو أريد بها النوع . أي : فانكحوا النوع الطيب من النساء . ولو قيل :( فانكحوا مَنْ طاب لكم ) ، لتبادر إلى الذهن إرادة نسوة معروفات بينهم بحسبهن ونسبهن .. وكذلك حال « مَا » في الاستفهام ، فإذا قلت :« ما تزوجت ؟ » فأنت تريد : ما صفتها ؟ أبكرًا ، أم ثيِّبًا ؟ . وإذا قلت :« مَنْ تزوجت ؟ » فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها .. وهذا- كما قال ابن قيِّم الجوزيَّة- باب لا ينخرم ، وهو من ألطف مسالك العربية .. فتأمل !!!
4- وأما القول بأنه قال :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، ولم يقل :( من أعبد ) ؛ ليقابل به ، قوله :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ، فهو قول مبني على أن المراد بمعبودهم الأصنام ، وهو قول ضعيف ؛ لأنه يحصر براءته عليه الصلاة والسلام من عبادة الأصنام التي يعبدها كفار العرب ، دون غيرها مما يعبده كفار أهل الأرض جميعهم من دون الله عز وجل . والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعلن براءتهم من عبادة معبوده ، وبراءته من عبادة معبودهم على الإطلاق ، فشملت البراءة كل ما يعبده الكفار من الأصنام والأوثان ، ومن شياطين الإنس والجن ، ومن الملائكة والمسيح ، وغير ذلك مما يعقل ولا يعقل . فتخصيص البراءة من الشرك بشرك كفار العرب غلط عظيم ؛ وإنما هي براءة من كل شرك . ثم إن كون الرب جل وعلا يتصف بما تتصف به الأصنام من عدم العلم فهو مما لا يجوز عليه سبحانه ، ولا تصح المقابلة فى مثل ذلك ؛ بل المقصود التعبير عن معبودهم ومعبوده على الإطلاق دون تخصيص ؛ ليتبرأ من معبودهم ، ويبرئهم من معبوده على الإطلاق .
5- وأما القول بأن « مَا » ، و« مَنْ » قد تتعاقبان فتقع إحداهما موقع الأخرى ، فليس كذلك ؛ لأن « مَا » ضمير موصول يقع على الأجناس كلها ، ولا يقع فيها إلا على جنس تتنوَّع منه أنواع . فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصُّوا بها ما يعلم ويعقل ، أبدلوا ألفها نونًا ساكنة ، فقالوا :« مَنْ » .
تأمل قول الله تعالى :﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾(الأحقاف: 4) ، كيف عبَّر سبحانه عن معبود الكافرين بقوله :﴿ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ، فدل على أنه جنس تحته أنواع ، هي أصنامهم وأوثانهم ، وكل ما يدعونه من دون الله تعالى مما يعقل ولا يعقل . وهذا المعنى لا يصلح للتعبير عنه غير « مَا » المبهمة التي تقع على كل شيء .
ثم تأمل قوله تعالى في الآية التي تلت الآية السابقة :﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾(الأحقاف: 5) ، كيف عدل سبحانه عن « مَا » في الآية السابقة إلى « مَنْ » في قوله :﴿ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ ، فدل على أن المراد به النوع الذي يعقل ممَّن يدعونه من دون الله ، من شياطين الإنس والجن ، والملائكة وعيسى ، ونحوهم ؛ فإن هؤلاء لا يستجيبون لمن يعبدونهم ويدعونهم من دون الله إلى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون .
فلما كان المراد الجنس العام دون تخصيص أتِي بـ« مَا » ، ولما كان المراد نوع معين من أنواع الجنس العام ، وتخصيصه بمن يعقل أتِيَ بـ« مَنْ » . ولو كان المعنى في الموضعين- على ما قيل- واحدًا ، لم يكن لهذا العدول أي معنى . ولو كان المراد بـ﴿ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ الأصنام وحدها ، لما احتيج تقييده بقوله تعالى :﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ . وهذا الاحتياج ينبعث من كون « مَا » مبهمة عامة . وحيث كانت بإبهامها وعمومها واقعة على الجنس العام ومتناولة لله جل وعلا ، احتيج ذلك إلى هذا التقييد . فلو كانت مختصة بما لا يعقل ، لما احتيج إليه ، ولما كان له فائدة سوى التأكيد . أما بناء على أنها واقعة على الجنس العام ، ومتناولة لما يعقل وما لا يعقل ، تكون فائدة هذا التقييد التأسيس . والتأسيس أولى من التأكيد ؛ لأنه الأصل ، فحمل الكلام عليه أولى من حمله على التأكيد .
خامسًا- وقد سبق أن ذكرنا أن الخطاب في قوله :﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ هو خطاب للجنس ، فيتناول كل كافر ؛ سواء كان ممن يظهر الشرك ، أو كان ممن فيه تعطيل لما يستحقه الله تعالى من العبادة ، واستكبار عن عبادته . ولذلك لم يقل :( يا أيها المشركون ) . أو :( يا أيها النصارى ) . أو :( يا أيها اليهود ) ؛ وإنما قال :﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ! فخاطب جنس الكافرين على اختلاف أنواعهم ومشاربهم .
ثم قال :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، فنفى عليه الصلاة والسلام عبادته لما يعبدون ، وعبادتهم لما يعبد نفيًا مطلقًا . وما يعبدونه هم ويعبده هو معناه : المعبود . والمعبود لفظ مطلق يتناول المفرد والجمع ، والمذكر والمؤنث ؛ فهو يتناول كل معبود لهم . والمعبود هو الإله ، ويتضمن إضافة إلى العابد ؛ فكأنه- عليه الصلاة والسلام- قال : لا أعبد إلهكم ، ولا تعبدون إلهي ؛ كما ذكر الله تعالى فى قصة يعقوب عليه السلام ، فقال :
﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾(البقرة: 133)
فأخبر سبحانه أن إله يعقوب وإله آبائه- إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم- هو الذي يعبده هؤلاء ، ويألهونه ، ويعبده كل من كان على ملتهم ؛ كما قال يوسف عليه السلام :
﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾(يوسف: 37- 38) إلى قوله :﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾(يوسف: 40)
فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله جل وعلا ، وهي ملة إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام ، وقد قال الله تعالى :
﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾(البقرة: 130)
فبين أن كل من رغب عن ملة إبراهيم – عليه السلام - فهو سفيه . وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى وكفار مكة وغيرهم ليسوا على ملة إبراهيم . وإذا لم يكونوا على ملته ، لم يكونوا يعبدون إلهه .
ولفظ الإله يراد به : المستحق للإلهية والعبادة . ويراد به : كل ما اتُّخِذ إلهًا باطلاً وعُبِد من دون الله سبحانه ، وهو جنس تحته أنواع منه ؛ كالأصنام ، والأوثان ، والمسيح بن مريم ، وعُزَيْر ، والأحبار والرهبان ، والإناث من الملائكة ، والشياطين من الإنس والجن ، والشمس والقمر ، والدرهم والدينار ، وكل ما عبد ويعبد من دون الله سبحانه ، ممَّا يسمَّى آلهة .
إذا عرفت ذلك ، تبيَّن لك أن المراد بقوله :﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ التعبير عن إله الكافرين على الإطلاق ، دون تخصيص بالأصنام ، أو غيرها ، وأن المراد بقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ التعبير عن إلهه جل وعلا على الإطلاق ، دون تخصيص ؛ لأن امتناعهم عن عبادة الله تعالى لم يكن لذاته ؛ بل كانوا يظنون أنهم كانوا يعبدون الله ؛ ولكنهم كانوا جاهلين به . قال تعالى :﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً ﴾(الفرقان: 60) ، فقالوا :﴿ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ ؛ لأنهم لا يعرفونه بحقيقته التي وصف سبحانه وتعالى بها نفسه ، والتي عرفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ووصفه بها . ولو كانوا يعرفونه حق معرفته ويقدرونه حق قدره ، لقالوا :( ومن الرحمن ؟ أنسجد لمن تأمرنا ؟ ) ؛ ولهذا ناسب إيقاع « مَا » عليه ، دون « مَنْ » ؛ لأن من جلت عظمته حتى خرجت عن الحصر وعجزت الأفهام عن كنه ذاته ، وجب أن يقال فيه :« هو ما هو » ؛ كقول العرب :« سبحان ما سبح الرعد بحمده » ، وقولهم :« سبحان ما سخَّركُنَّ لنا » . فـ« مَا » في هذه الموضع ونحوه اقتضاها الإبهام وتعظيم المعبود ، مع أن الحسَّ منهم مانعٌ لهم أن يعبدوا معبوده كائنًا ما كان ؛ فلهذا حسُنت ، دون « مَنْ » .
وبنحو هذا أجاب الشيخ السهلي رحمه الله ، ثم ذكر جوابًا آخر ؛ وهو :« أنهم كانوا يشتهون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدًا له وأنفة من اتباعه ، فهم لا يعبدون معبوده ، لا كراهية لذات المعبود ؛ ولكن كراهية لاتباعه صلى الله عليه وسلم ، وشهوة منهم لمخالفته في العبادة ، كائنًا ما كان معبوده ، وإن لم يكن معبوده إلا الحق سبحانه وتعالى .. فعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا « مَا » ، لإبهامها ، ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية » .
وأقرب من هذا - كما قال ابن قيِّم الجوزيَّة- هو :« أن المقصود هنا ذكر المعبود ، الموصوف بكونه أهلاً للعبادة ، مستحقًا لها ، فأتى بـ« مَا » الدالة على هذا المعنى ؛ كأنه قيل : ولا أنتم عابدون معبودي ، الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أتى بلفظ « مَنْ » ، لكانت إنما تدل على الذات فقط ، ويكون ذكر الصلة تعريفًا ، لا إنه جهة العبادة . ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلاً لأن يعبد تعريف محض ، أو وصف مقتض لعبادته .. فتأمله ، فإنه بديعٌ جدًّا » .
ويتضح لك ذلك إذا علمت أن المعبود لا يعبد لذاته ؛ وإنما يعبد لصفاته لصفاته الدالة على ذاته ، أيًّا كان ذلك المعبود ؛ ولهذا أنكر الله تعالى على المشركين عبادة الآلهة من دونه سبحانه ، ووبخهم عليها ؛ لأنهم عبدوا ذواتًا لا صفات لها ، وسمُّوها بأسماء لا تستحقها ، وتركوا عبادة الله المتصف بصفات الكمال والجلال ، فقال عز وجل :
﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾(النحل: 17) ؟
﴿ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾(الأنبياء: 67)
ولهذا لما سأل فرعونُ موسى- عليه السلام- عن رب العالمين ؛ كالطالب لماهيَّته ، سأل بـ« مَا » ، ولم يسأل بـ« مَنْ » ، فقال :﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾(الشعراء: 23) ، فأجابه موسى عليه السلام ببيان الأوصاف المرشدة إلى معرفة الله جل وعلا ، والتي استحق لأجلها أن يكون ربًّا ، وإلهًا معبودًا ، فقال :﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾(الشعراء: 24) .
فإذا تأملت ما تقدم ، تبين لك أنه لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع أن يعبَّر بـ« مَنْ » بدلاً من « مَا » ، أو العكس . والله تعالى أعلم .
سادسًا- ومن تأمل صيغ النفي في السورة الكريمة ، وجد أن النفي لم يأت في حق الكافرين إلا بصيغة الفاعل :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ ﴾ . وأما في جهة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالفعل المضارع :﴿ لا أَعْبُدُ ﴾ تارة ، وبصيغة الفاعل :﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ ﴾ تارة أخرى ؛ وذلك- والله أعلم- لنكتة بديعة ، وهي أن المقصود الأعظم من ذلك براءته صلى الله عليه وسلم من معبوديهم بكل وجه ، وفي كل وقت ؛ ولهذا أتى في هذا النفي بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ، ثم أتى بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت ، فأفاد في النفي الأول أن تلك العبادة لا تقع منه أبدًا ، وأفاد في الثاني أن تلك العبادة ليست من وصفه ، ولا من شأنه ؛ فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : عبادة غير الله تعالى لا تكون فعلاً لي ، ولا وصفًا من أوصافي ، فأتى بنفييْن لمنفيَّين مقصودين بالنفي . وأما في حق الكافرين فإنما أتى بصيغة الفاعل الدالة على الوصف والثبوت دون الفعل ، فأفاد ذلك أن الوصف الثابت اللازم العائد لله تعالى منتفٍ عن الكافرين ؛ لأن هذا الوصف ليس ثابتًا لهم ، وإنما هو ثابت لمن خصَّ الله تعالى وحده بالعبادة ، ولم يشرك معه فيها أحدًا .
وعقَّب ابن قيِّم الجوزيَّة على ذلك بقوله :« فتأمل هذه النكتة البديعة ، كيف تجد في طيَّها أنه لا يوصف بأنه عابدٌ لله تعالى ، وأنه عَبْدُهُ المستقيم على عبادته ، إلا من انقطع إليه بكلِّيته ، وتبتَّل إليه تبتيلاً ، لم يلتفت إلى غيره ، ولم يشرك به أحدًا في عبادته ، وأنه وإن عبده وأشرك به غيره ، فليس بعابدٍ لله تعالى ، ولا عَبْدًا له سبحانه . وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتيْ الإخلاص والتي تعدل ربع القرآن ؛ كما جاء في بعض السنن . وهذا لا يفهمه كل أحد ، ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عنده .. فلله الحمد والمِنَّة » .
سابعًا- ومن أسرار هذه السورة التي لا يكاد يُفطَن إليها أن النفي فيها أتى بأداة النفي « لا » ، ولم يأت بالأداة « ما » ، مع أن نفي الحاضر الدائم والمستمر بـ« ما » أولى من نفيه بـ« لا » ، وأكثر منه استعمالاً . والسر في ذلك أن « ما » لا ينفى بها في الكلام إلا ما بعدها ، وأنها لا تكون إلا جوابًا عن الدعوى . أما « لا » ، فينفى بها في أكثر الكلام ما قبلها ، فيكون ما بعدها في حكم الوجوب ، وأنها تكون جوابًا عن السؤال ، وتكون ردًّا لكلام سابق . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن « لا » إذا نفي بها المضارع ، فإنها تدل على نفيه نفيًا شاملاً مستغرقًا لكل جزء من أجزاء الزمن ، بدون قرينة تصحبها ؛ كما في قوله تعالى :﴿ عَالِمِ الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾(سبأ: 3) . أما « ما » فلا تدل على نفي المضارع على سبيل الاستغراق إلا بوجود قرينة تصحبها ، وهي « مِنْ » الاستغراقية ؛ كما في قوله تعالى :﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾(يونس: 61).
وبهذا تكون هذه السورة العظيمة قد اشتملت على النفي المحض ، وهذا هو خاصيَّتها ؛ فإنها سورة براءةٍ من الشرك- كما جاء في وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم- فالمقصود الأعظم منها هو البراءة المطلوبة بين الموحدين ، والمشركين ؛ ولهذا جيء بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة ، مع أنها متضمنَّة للإثبات صريحًا ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم :﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ براءة محضة . وقوله :﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ إثبات أن له عليه الصلاة والسلام معبودًا يعبده ، وأنهم بريئون من عبادته . فتضمَّنت بذلك النفي والإثبات ، وطابقت قول إمام الحنفاء سيدنا إبراهيم عليه السلام :﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾(الزخرف: 26- 27) ، وطابقت قول الفئة الموحّدة :﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا ﴾(الكهف: 16) ، فانتظمت بذلك حقيقة التوحيد بقول :« لا إله إلا الله » .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن هذه السورة العظيمة بسورة ( قل هو الله أحد ) ، في سنة الفجر ، وسنة المغرب ؛ فإن هاتين السورتين ( سورتي الإخلاص ) قد اشتملتا- كما قال ابن قيِّم الجوزية- على نوعَيْ التوحيد الذين لا نجاة للعبد ، ولا فلاح له إلا بهما : أولهما : توحيد العلم والاعتقاد . وثانيهما : : توحيد القصد والإرادة .
1- فأما توحيد العلم والاعتقاد فهو المتضمِّن تنزيه الله تعالى عمَّا لا يليق به ، من الشرك والكفر، والولد والوالد ، وأنه إله أحد صمد ، لم يلد فيكون له فرع ، ولم يولد فيكون له أصل ، ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له مِثْل . ومع هذا فقد اجتمعت له جل جلاله صفات الكمال كلها ، فتضمنَّت السورة إثبات ما يليق بجلال الله عز وجل من صفات الكمال ، ونفي ما لا يليق بجلاله سبحانه من الشريك أصلاً وفرعًا ، وشبهًا ومثلاً .. فهذا هو توحيد العلم والاعتقاد .
2- وأما توحيد القصد والإرادة فهو أن لا يُعبدَ إلا الله جل وعلا ، فلا يُشرَك به في عبادته سواه ؛ بل يكون وحده سبحانه هو المعبود . وسورة الكافرون مشتملة على هذا النوع من نوعيْ التوحيد ، فتضمنت بذلك السورتان نوعيْ التوحيد ، وأخلصتا له .
ثامنًا- ومن أسرار هذه السورة العظيمة ما تضمنه قوله تعالى في ختامها من التأكيد :﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . والسؤال هنا : هل أفاد هذا معنى زائدًا على ما تقدَّم ؟ والجواب : أن النفي في الآيات السابقة أفاد براءته صلى الله عليه وسلم من معبوديهم ، وأنه لا يتصور منه ، ولا ينبغي له أن يعبدهم ، وهم أيضًا لا يكونون عابدين لمعبوده ؛ كما أفاد إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم ونصيبهم ، فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو ، وغيره أرضًا ، فقال له : لا تدخل في حدِّي ، ولا أدخل في حدِّك ، لك أرضك ، ولي أرضي . فتضمَّنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أن المؤمنين ، والكافرين اقتسموا حظهم فيما بينهم ، فأصاب المؤمنين التوحيدُ والإيمان ، فهو نصيبهم الذي اختصوا به ، لا يشركهم الكافرون فيه . وأصاب الكافرين الشركُ بالله تعالى والكفر به ، فهو نصيبهم الذي اختصوا به ، لا يشركهم المؤمنون فيه .
ثم إن في تقديم حظ الكافرين ونصيبهم في هذه الآية على حظ المؤمنين ونصيبهم ، وتقديم ما يختص به المؤمنون على ما يختص به الكافرون في أول السورة ، من أسرار البيان وبديع الخطاب ، ما لا يدركه إلا فرسان البلاغة وأربابها ، وبيان ذلك :
أن السورة لما اقتضت البراءة ، واقتسام دينَيْ التوحيد والشرك بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين الكافرين ، ورضي كلٌّ بقسمه ، وكان المحق هو صاحب القسمة ، وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون ، وأنه استولى على القسم الأشرف ، والحظ الأعظم ، أراد أن يشعرهم بسوء اختيارهم ، فقدم قسمهم على قسمه ، تهكمًا بهم ، ونداءً على سوء اختيارهم ، فكان ذلك- كما قال ابن قيِّم الجوزيَّة- بمنزلة من اقتسم هو ، وغيره سُمًَّا وشفاءً ، فرضي مقاسمه بالسمِّ ؛ فإنه يقول له : لا تشاركني في قسمي ، ولا أشاركك في قسمك . لك قسمك ، ولي قسمي ! ولهذا كان تقديم قوله :﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ على قوله :﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ هنا أبلغ وأحسن ؛ وكأنه يقول : هذا هو قسمكم الذي آثرتموه بالتقديم ، وزعمتم أنه أشرف القسمين ، وأحقهما بالتقديم !!
وذكر ابن قيِّم الجوزيَّة وجهًا آخر ؛ وهو : أن مقصود السورة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم- هذا هو لبُّها ومغزاها- وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكمِّلاً لبراءته ومحققًا لها . فلما كان المقصود براءته من دينهم ، بدأ به في أول السورة ، ثم جاء قوله تعالى :﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ مطابقًا لهذا المعنى . أي : لا أشارككم في دينكم ، ولا أوافقكم عليه ؛ بل هو دين تختصون به أنتم ، فطابق آخر السورة أولها .
فتأمل هذه الأسرار البديعة المعجزة ، واللطائف الدقيقة المبهرة التي تشهد أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد ، وأنه الأعلى في البلاغة والفصاحة والبيان ! نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يفقهون كلامه ، ويدركون أسرار بيانه ، والحمد لله على نعمة الفهم والعقل والدين .