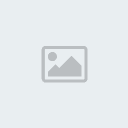عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول
الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري و مسلم .
الشرح
بعث
الله سبحانه وتعالى الرسل الكرام ، وأنزل معهم الكتب العِظام ، لينشروا
الدين في أرجاء المعمورة ، فيكون ظاهرا عاليا على سائر الأديان والملل ،
كما بيّن سبحانه ذلك في قوله : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله } ( البقرة : 193 ) .
وكانت
هذه المهمة محور دعوة كل أنبياء الله ، فقاموا جميعا لتحقيق هذه الغاية ،
باذلين في ذلك الغالي والنفيس ، والمال والنفس ، داعين إلى الله بالليل
والنهار ، والسرّ والعلانية ، فانقسم الناس عند ذلك إلى فريقين : فريق قذف
الله في قلبه أنوار الحق ، فانشرح صدره للإسلام ، فوحّد ربّه ، واتّبع
شريعته ، وفريق طمس الله بصيرته ، وجعل على قلبه غشاوة ، فأظلم قلبُه ،
وأبى أن يقبل دعوة الحق ، ولقد أوضح الله تعالى حقيقة الفريقين في قوله
تعالى : { ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم } ( محمد : 3 ) .
إن
انقسام الناس إلى مصدّق ومكذّب ، ومؤمن وكافر ، أمر حتمي تجاه كل ما هو
جديد ، وتجاه كل دين أو معتقد ، وإذا كان انقسامهم أمرا لازما ؛ فإنه يجب
على ذلك الدين أو ذلك المعتقد أن يتعامل مع كلا الفريقين ، وجميع الطائفتين
، وهذا عين ما جاءت به شرائع الله عزوجل ، ومنها الإسلام .
لقد
أمرنا الله تعالى في دين الإسلام أن ندعو المعرضين والمكذبين بالحسنى ، وأن
نجتهد في ذلك ، بل أن نجادلهم بالتي هي أحسن ، فإن أبوا ، كان لزاما عليهم
ألا يمنعوا هذا الخير من أن يصل إلى غيرهم ، ووجب عليهم أن يفسحوا لذلك
النور لكي يراه سواهم ، فإن أصروا على مدافعة هذا الخير ، وحجب ذلك النور ،
كانوا عقبة وحاجزاً ينبغي إزالته ، ودفع شوكته ، وهذا مما أشار إليه النبي
صلى الله عليه وسلم في قوله : ( أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) ، فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بنشر دين الإسلام ، واستئصال شوكة كل معاند أو معارض ، وتلك هي حقيقة الدين وغايته .
لكن
ما سبق لا يدل على أن دين الإسلام دينٌ متعطشٌ للدماء ، وإزهاق أرواح
الأبرياء ، بل هو دين رحمةٍ ورأفةٍ ، حيث لم يكره أحدا على الدخول فيه ،
بشرط ألا يكون عقبةً أو حاجزاً كما تقدم ، وقد قال تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي } ( البقرة : 256 ) .
ثم
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا ، الأمور التي تحصل
بها عصمة الدم والنفس ، وهي : النطق بالشهادتين ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء
الزكاة ، فمن فعل ذلك ، فقد عصم نفسه وماله ، وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه
العصمة المطلقة ، أو العصمة بالإسلام ، وحقيقتها : أن يدخل المرء في دين
الإسلام ، ويمتثل لأوامره ، وينقاد لأحكامه ، فمن فعل ذلك كان مسلما ، له
ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم .
أما العصمة المقيّدة أو العصمة
لغير المسلمين ، فحقيقتها : أن كل كافر غير محارب ، أي : المُستأمن والذميّ
والمعاهَد ، فإنه معصوم الدمّ ، بشروط معينة وضّحها العلماء في كتبهم .
وإذا
أردنا أن نوضّح حقيقة العصمة بالإسلام فنقول : إن من تلفّظ بالشهادتين ،
فإننا نقبل منه ظاهر قوله ، ونكل سريرته إلى الله تعالى ؛ لأن الله سبحانه
وتعالى لم يأمرنا أن ننقب عن قلوب الناس ، أونبحث في مكنونات صدروهم ،
أسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا لا يعني ترك
الانقياد للدين أو العمل بأحكامه ، فإن من شروط لا إله إلا الله الانقياد
لها ، والعمل بمقتضياتها .
أما إقامة الصلاة ، فهي من أعظم مظاهر الانقياد والعبودية، بل إن تاركها ليست له عصمة ، يشهد لذلك قوله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } ( التوبة : 11 ) ، فدل على أنهم إن لم يصلوا فلا أخوة لهم ، ولما أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يضرب عنق ذي الخويصرة - الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للمال- نهاه عن ذلك قائلا : ( لا ؛ لعله أن يكون يصلي ) رواه البخاري و مسلم ، وهذا يقتضي أنه لو كان تاركا للصلاة لما منع خالدا من قتله .
وإيتاء الزكاة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ويؤتوا الزكاة )
، هي من مظاهر الانقياد المالية لله تعالى ، ولا يعني ذكرها في الحديث أن
مجرد الامتناع عن أدائها كفر مخرج من الملة ، بل في ذلك تفصيل آخر ليس هذا
مجال بسطه.
وإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة في شخص أو فئة ، حصلت لهم
العصمة التامة ، فتصان دماؤهم وأموالهم وأنفسهم ، إلا بسبب حق من حقوق
الإسلام ، وذلك بأن يرتكب الإنسان ما يبيح دمه ، كالقتل بغير حق ، والزنى
مع الإحصان ، والردة بعد الإسلام.
وبذلك يتبين لنا أن الإسلام دين
يدعوا الناس جميعا إلى الالتزام بأحكام الله تعالى ، فإذا أدوا ما عليهم من
واجبات ، فقد كفل لهم حقوقهم ، وصان أعراضهم وأموالهم .
( أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول
الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري و مسلم .
الشرح
بعث
الله سبحانه وتعالى الرسل الكرام ، وأنزل معهم الكتب العِظام ، لينشروا
الدين في أرجاء المعمورة ، فيكون ظاهرا عاليا على سائر الأديان والملل ،
كما بيّن سبحانه ذلك في قوله : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله } ( البقرة : 193 ) .
وكانت
هذه المهمة محور دعوة كل أنبياء الله ، فقاموا جميعا لتحقيق هذه الغاية ،
باذلين في ذلك الغالي والنفيس ، والمال والنفس ، داعين إلى الله بالليل
والنهار ، والسرّ والعلانية ، فانقسم الناس عند ذلك إلى فريقين : فريق قذف
الله في قلبه أنوار الحق ، فانشرح صدره للإسلام ، فوحّد ربّه ، واتّبع
شريعته ، وفريق طمس الله بصيرته ، وجعل على قلبه غشاوة ، فأظلم قلبُه ،
وأبى أن يقبل دعوة الحق ، ولقد أوضح الله تعالى حقيقة الفريقين في قوله
تعالى : { ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم } ( محمد : 3 ) .
إن
انقسام الناس إلى مصدّق ومكذّب ، ومؤمن وكافر ، أمر حتمي تجاه كل ما هو
جديد ، وتجاه كل دين أو معتقد ، وإذا كان انقسامهم أمرا لازما ؛ فإنه يجب
على ذلك الدين أو ذلك المعتقد أن يتعامل مع كلا الفريقين ، وجميع الطائفتين
، وهذا عين ما جاءت به شرائع الله عزوجل ، ومنها الإسلام .
لقد
أمرنا الله تعالى في دين الإسلام أن ندعو المعرضين والمكذبين بالحسنى ، وأن
نجتهد في ذلك ، بل أن نجادلهم بالتي هي أحسن ، فإن أبوا ، كان لزاما عليهم
ألا يمنعوا هذا الخير من أن يصل إلى غيرهم ، ووجب عليهم أن يفسحوا لذلك
النور لكي يراه سواهم ، فإن أصروا على مدافعة هذا الخير ، وحجب ذلك النور ،
كانوا عقبة وحاجزاً ينبغي إزالته ، ودفع شوكته ، وهذا مما أشار إليه النبي
صلى الله عليه وسلم في قوله : ( أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) ، فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بنشر دين الإسلام ، واستئصال شوكة كل معاند أو معارض ، وتلك هي حقيقة الدين وغايته .
لكن
ما سبق لا يدل على أن دين الإسلام دينٌ متعطشٌ للدماء ، وإزهاق أرواح
الأبرياء ، بل هو دين رحمةٍ ورأفةٍ ، حيث لم يكره أحدا على الدخول فيه ،
بشرط ألا يكون عقبةً أو حاجزاً كما تقدم ، وقد قال تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي } ( البقرة : 256 ) .
ثم
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا ، الأمور التي تحصل
بها عصمة الدم والنفس ، وهي : النطق بالشهادتين ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء
الزكاة ، فمن فعل ذلك ، فقد عصم نفسه وماله ، وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه
العصمة المطلقة ، أو العصمة بالإسلام ، وحقيقتها : أن يدخل المرء في دين
الإسلام ، ويمتثل لأوامره ، وينقاد لأحكامه ، فمن فعل ذلك كان مسلما ، له
ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم .
أما العصمة المقيّدة أو العصمة
لغير المسلمين ، فحقيقتها : أن كل كافر غير محارب ، أي : المُستأمن والذميّ
والمعاهَد ، فإنه معصوم الدمّ ، بشروط معينة وضّحها العلماء في كتبهم .
وإذا
أردنا أن نوضّح حقيقة العصمة بالإسلام فنقول : إن من تلفّظ بالشهادتين ،
فإننا نقبل منه ظاهر قوله ، ونكل سريرته إلى الله تعالى ؛ لأن الله سبحانه
وتعالى لم يأمرنا أن ننقب عن قلوب الناس ، أونبحث في مكنونات صدروهم ،
أسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا لا يعني ترك
الانقياد للدين أو العمل بأحكامه ، فإن من شروط لا إله إلا الله الانقياد
لها ، والعمل بمقتضياتها .
أما إقامة الصلاة ، فهي من أعظم مظاهر الانقياد والعبودية، بل إن تاركها ليست له عصمة ، يشهد لذلك قوله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } ( التوبة : 11 ) ، فدل على أنهم إن لم يصلوا فلا أخوة لهم ، ولما أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يضرب عنق ذي الخويصرة - الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للمال- نهاه عن ذلك قائلا : ( لا ؛ لعله أن يكون يصلي ) رواه البخاري و مسلم ، وهذا يقتضي أنه لو كان تاركا للصلاة لما منع خالدا من قتله .
وإيتاء الزكاة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ويؤتوا الزكاة )
، هي من مظاهر الانقياد المالية لله تعالى ، ولا يعني ذكرها في الحديث أن
مجرد الامتناع عن أدائها كفر مخرج من الملة ، بل في ذلك تفصيل آخر ليس هذا
مجال بسطه.
وإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة في شخص أو فئة ، حصلت لهم
العصمة التامة ، فتصان دماؤهم وأموالهم وأنفسهم ، إلا بسبب حق من حقوق
الإسلام ، وذلك بأن يرتكب الإنسان ما يبيح دمه ، كالقتل بغير حق ، والزنى
مع الإحصان ، والردة بعد الإسلام.
وبذلك يتبين لنا أن الإسلام دين
يدعوا الناس جميعا إلى الالتزام بأحكام الله تعالى ، فإذا أدوا ما عليهم من
واجبات ، فقد كفل لهم حقوقهم ، وصان أعراضهم وأموالهم .